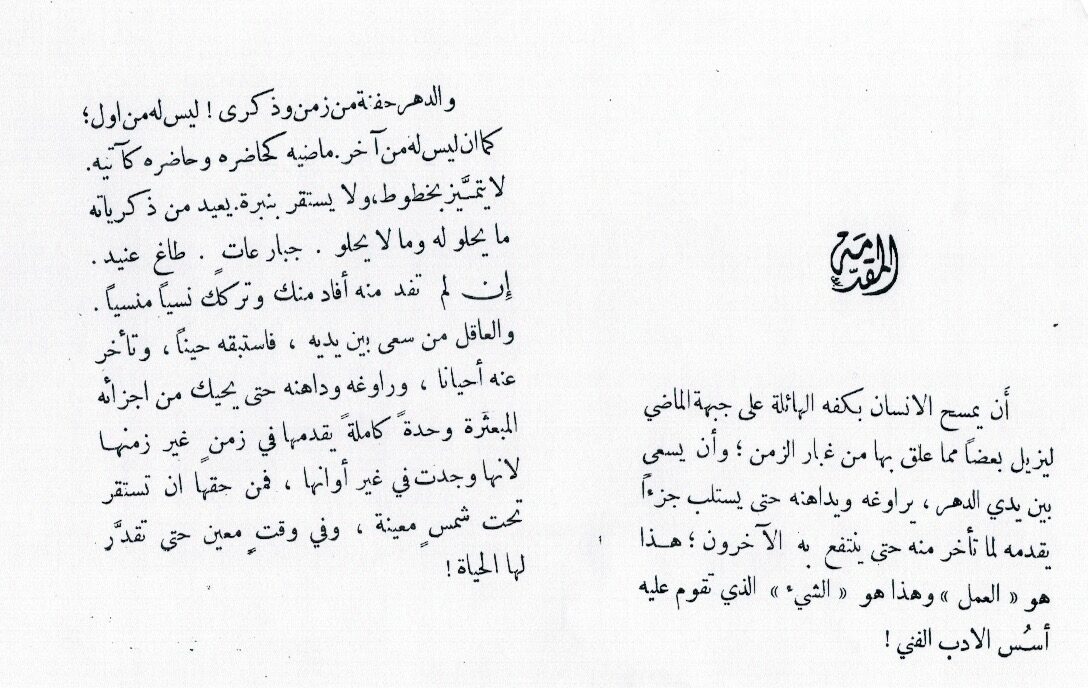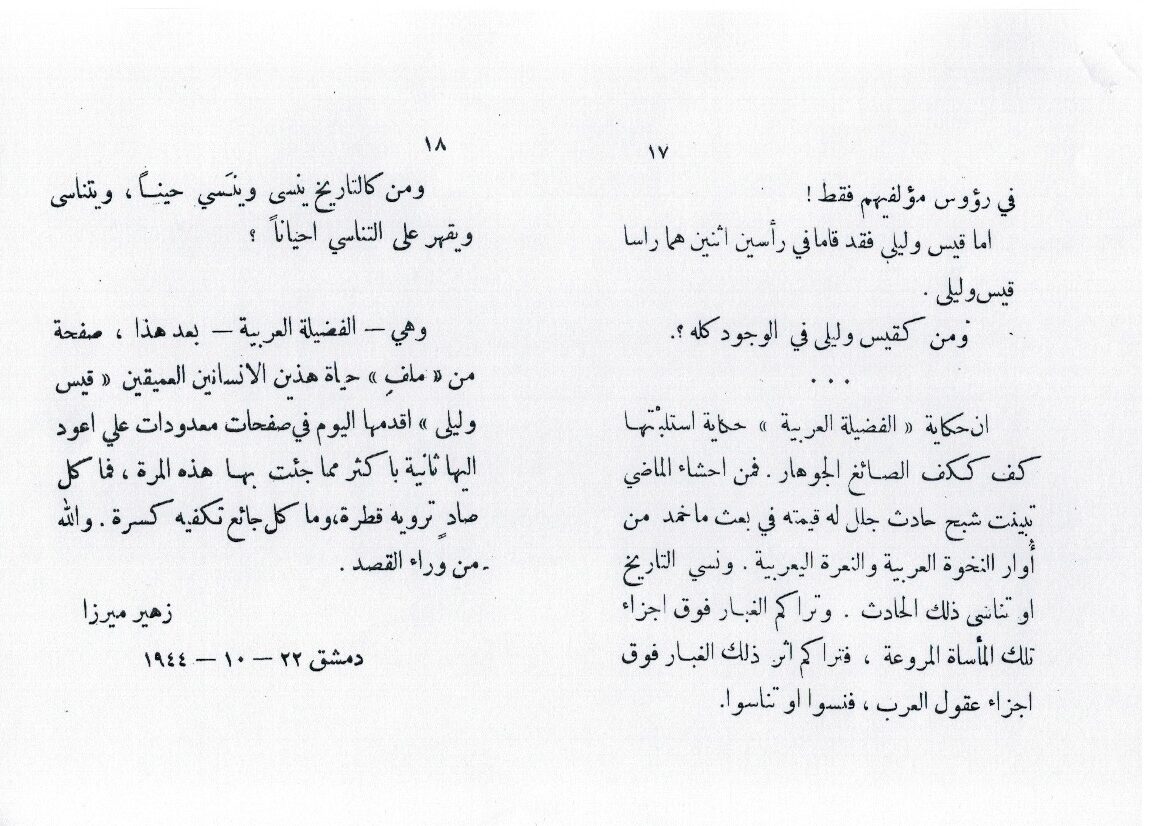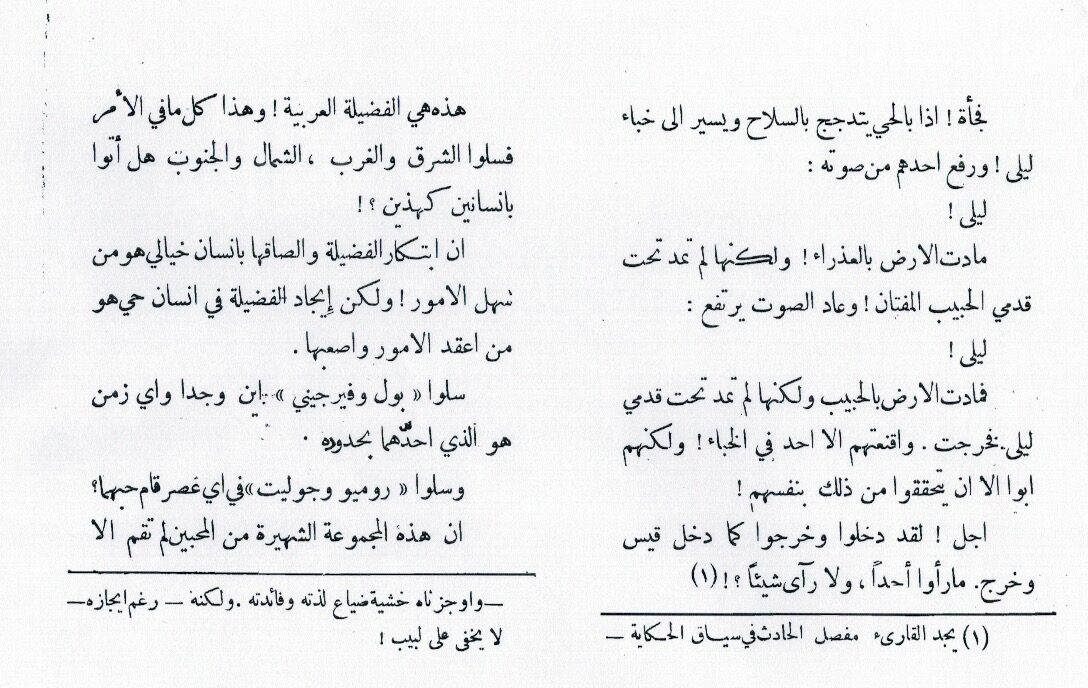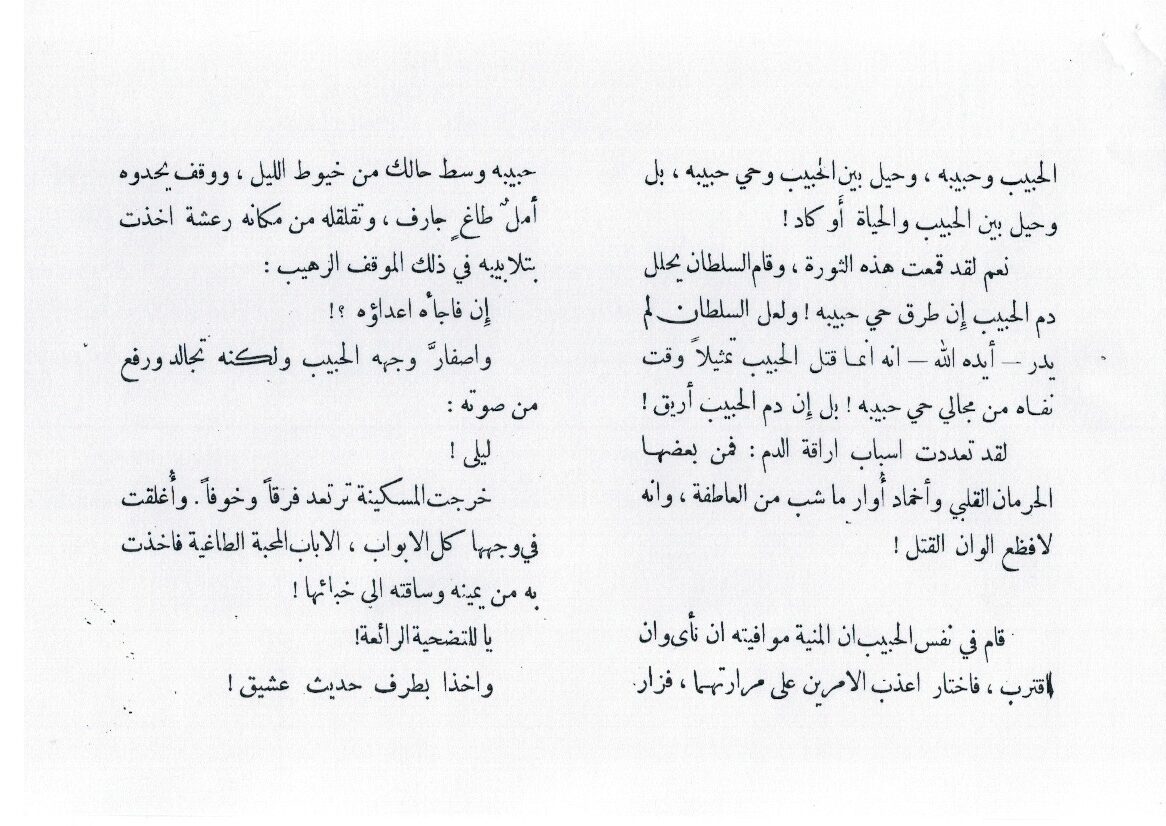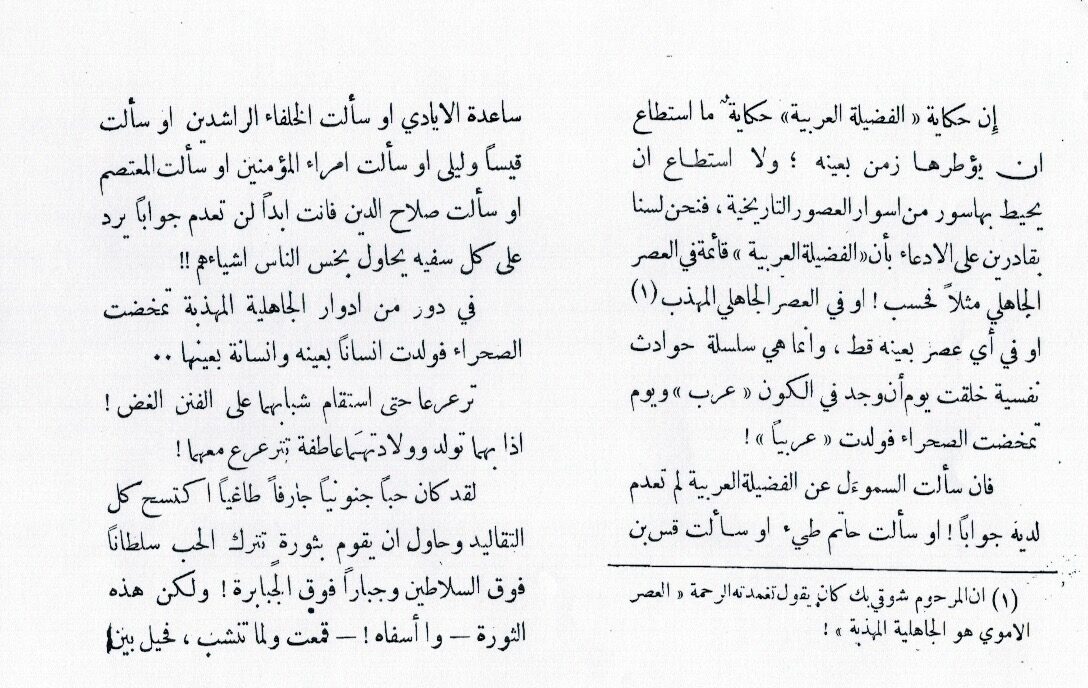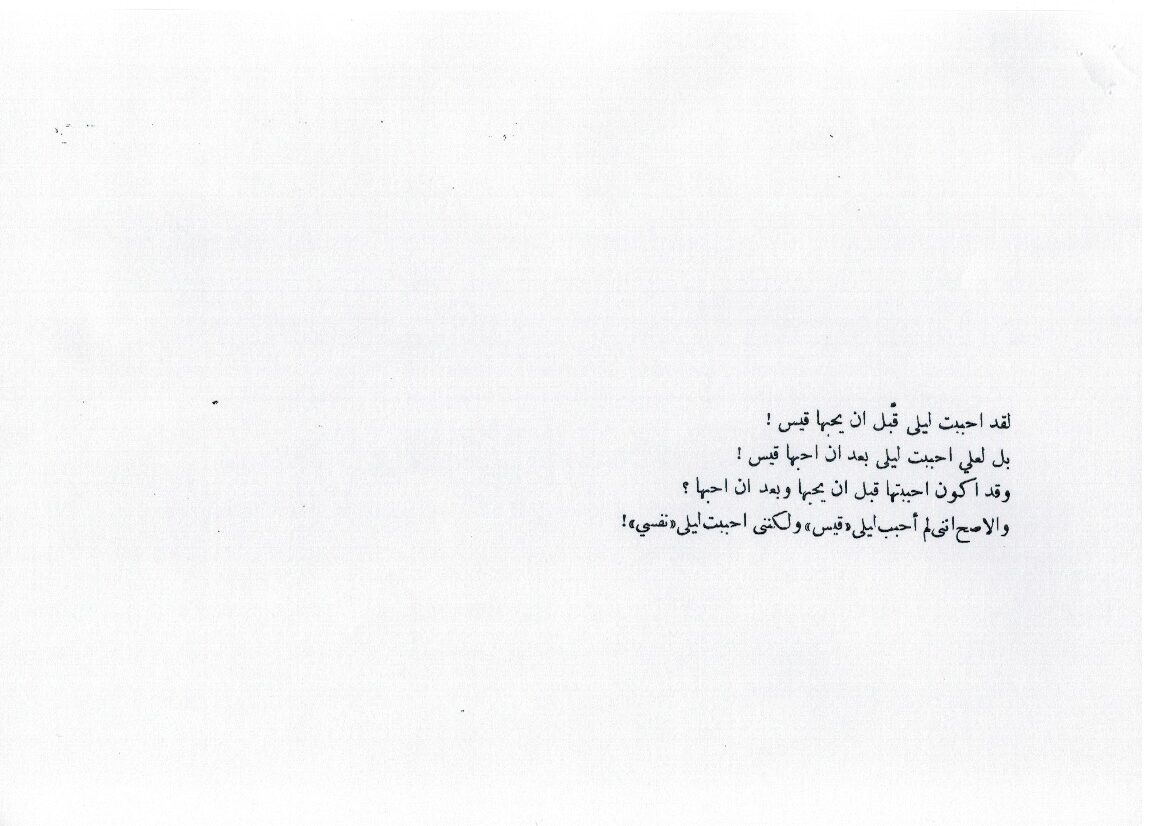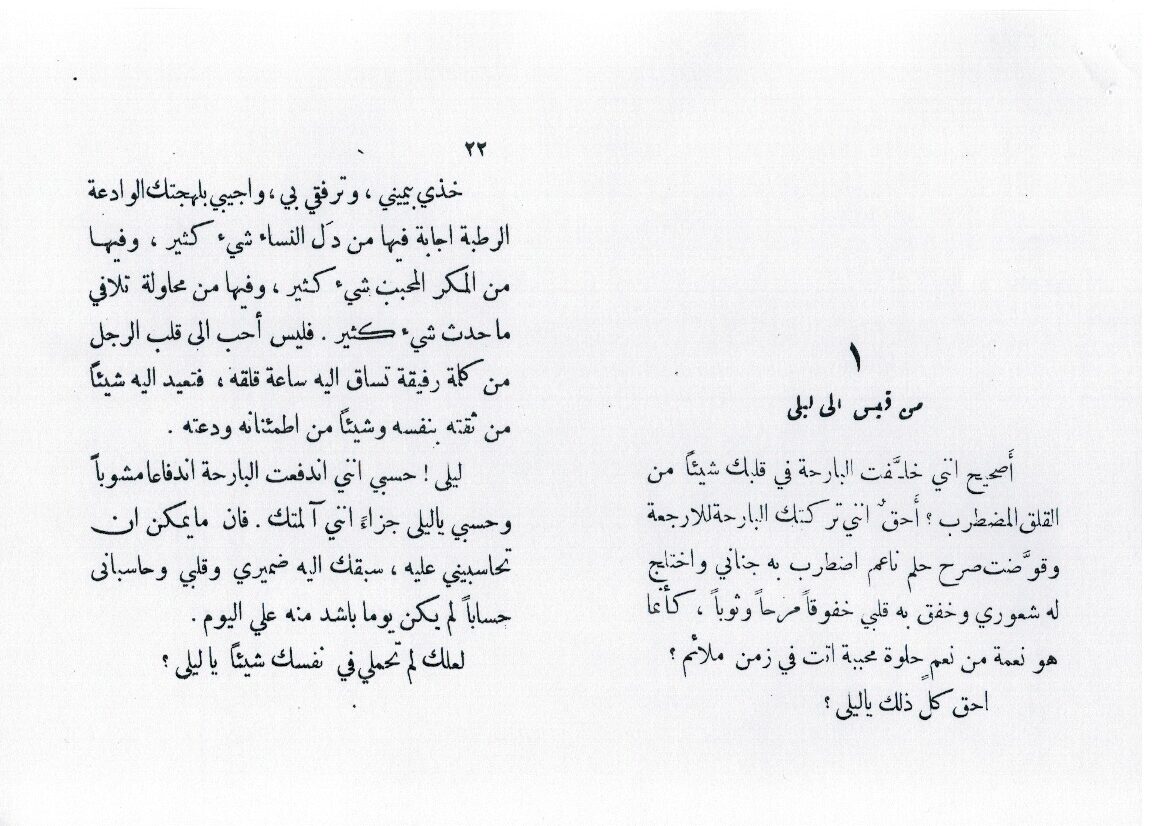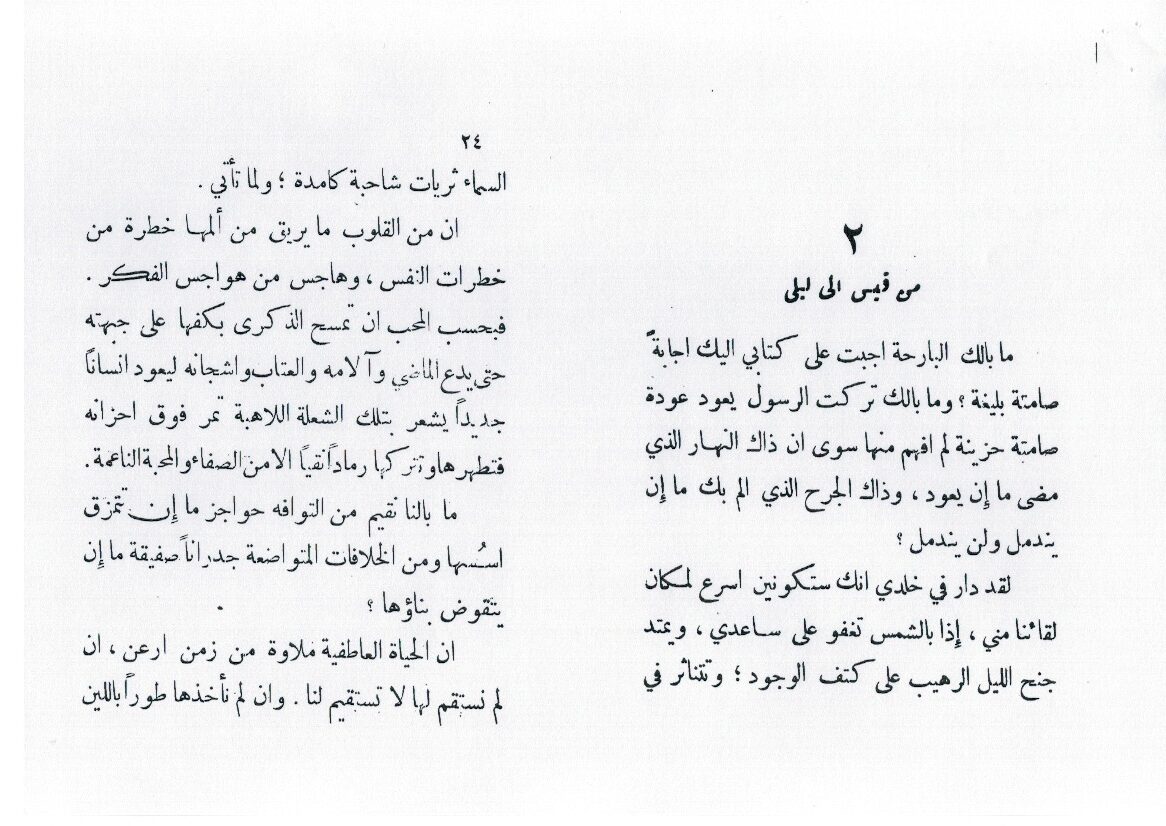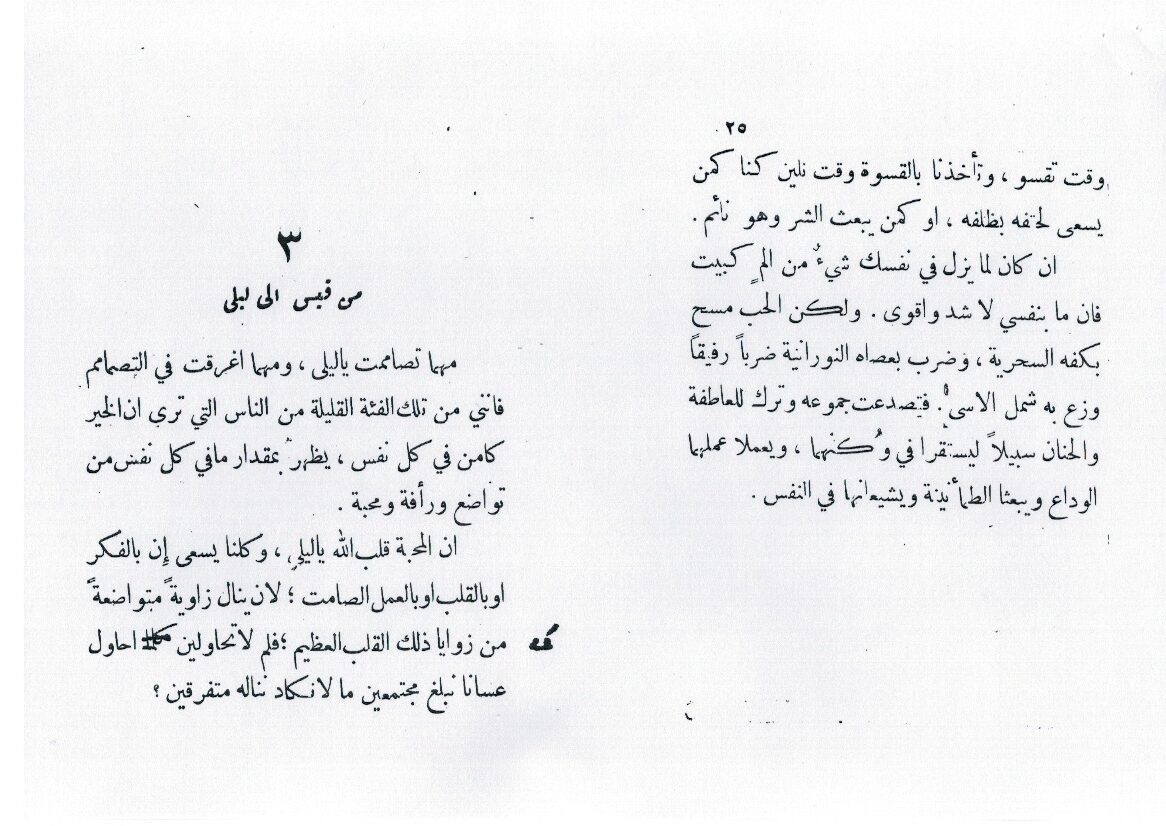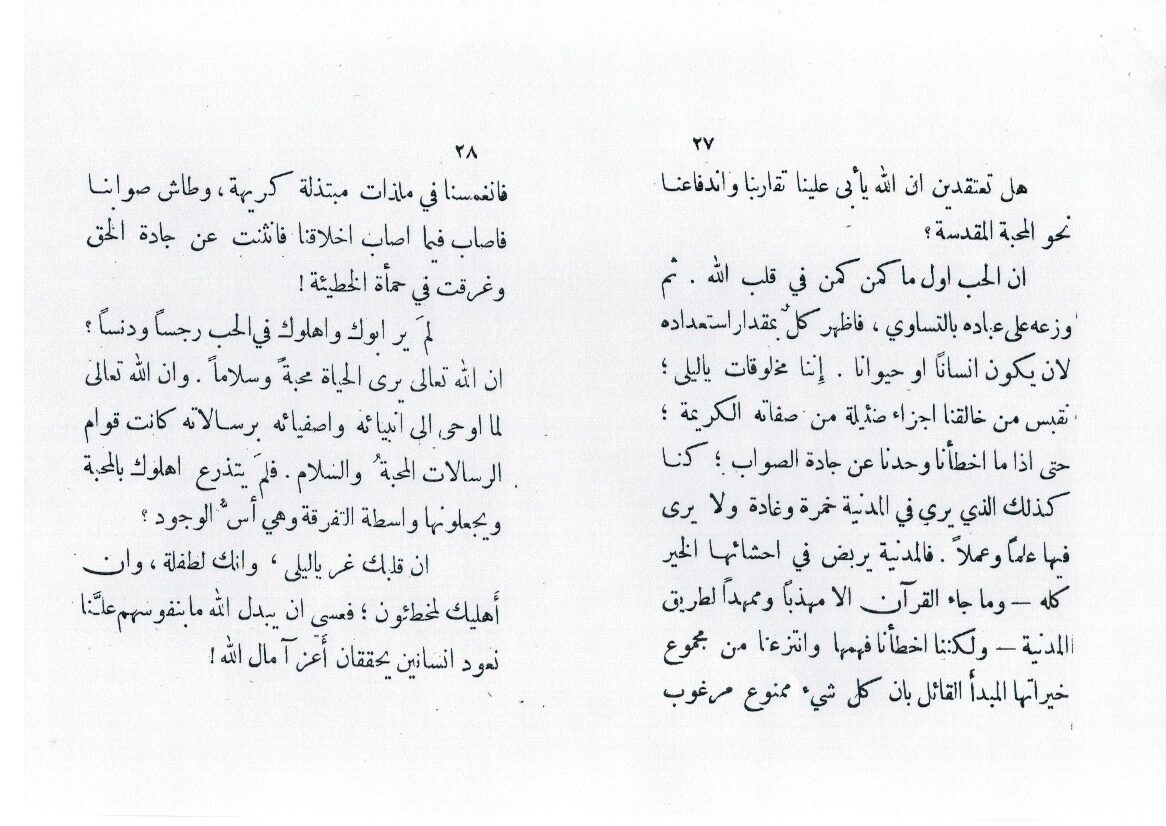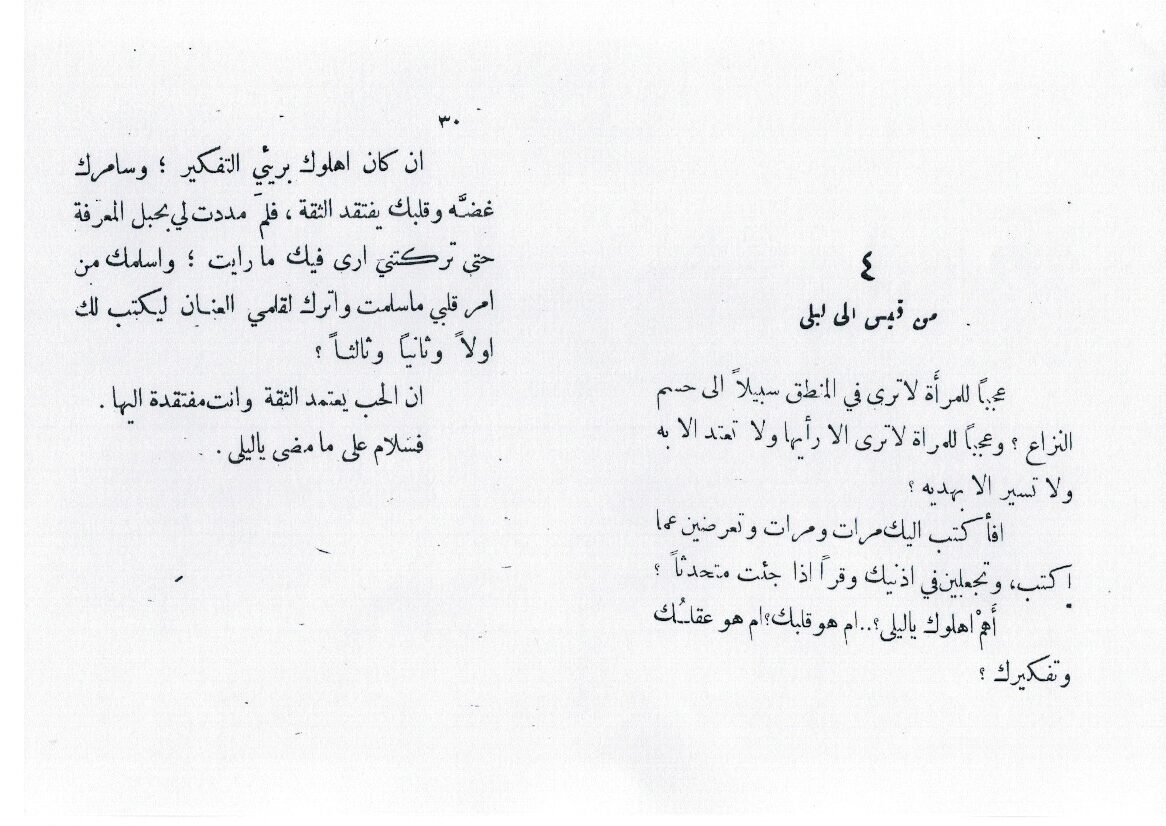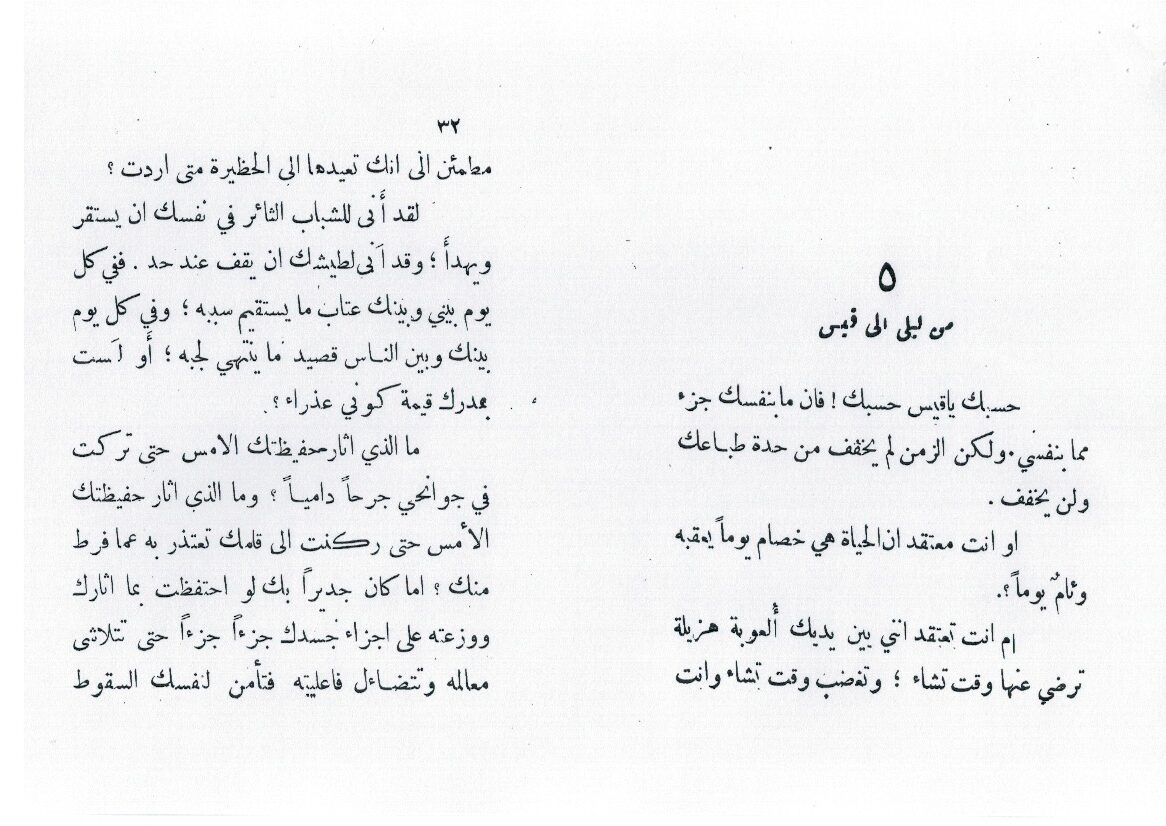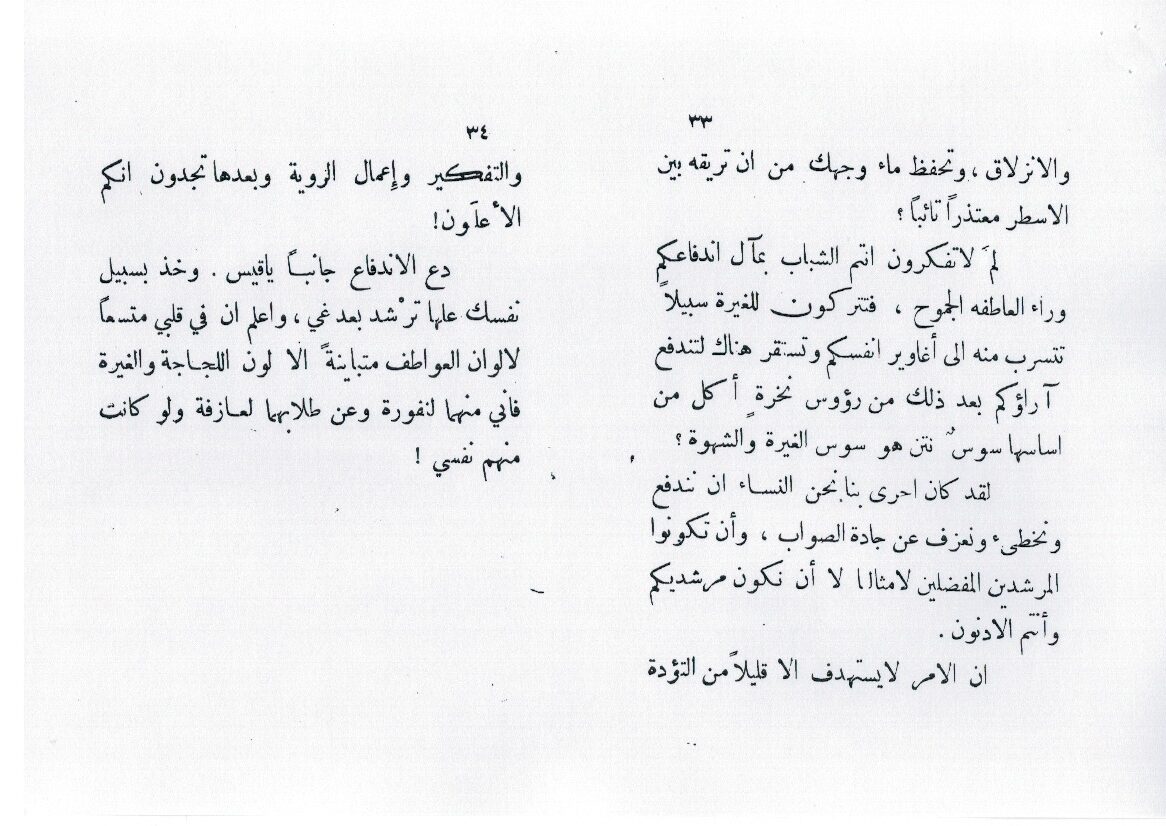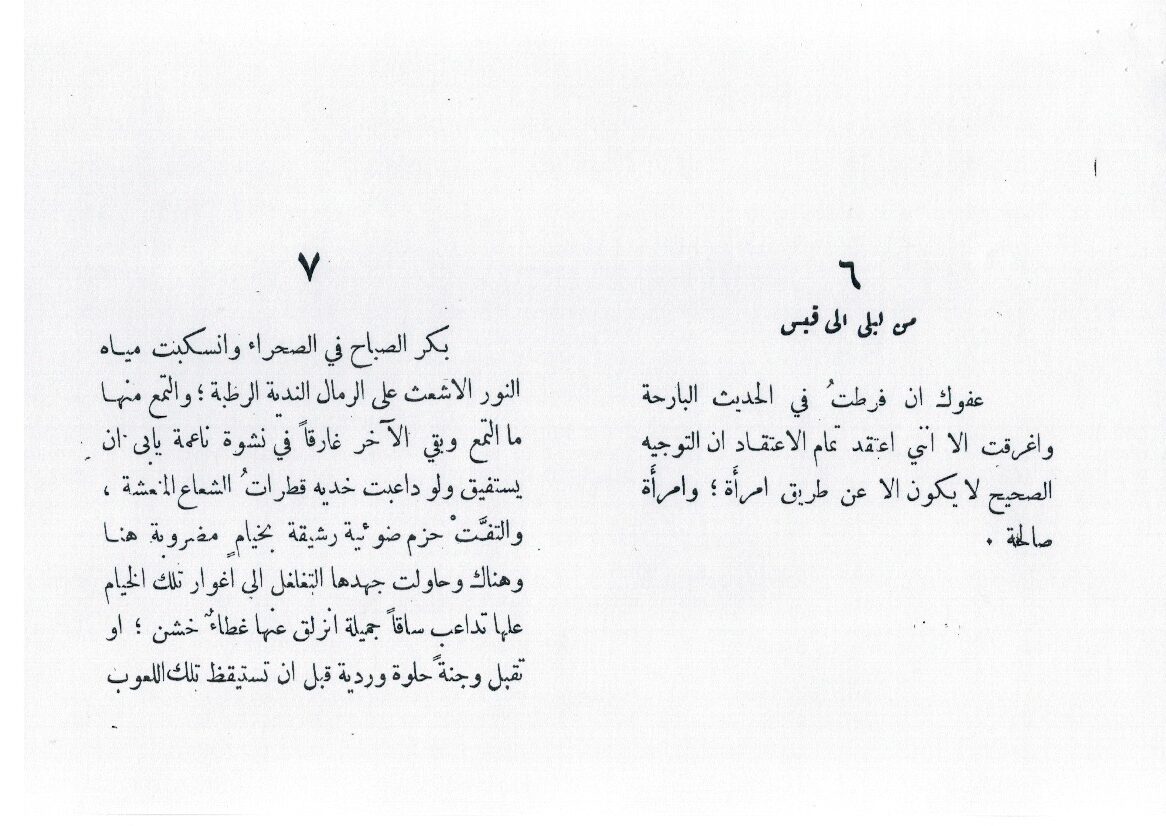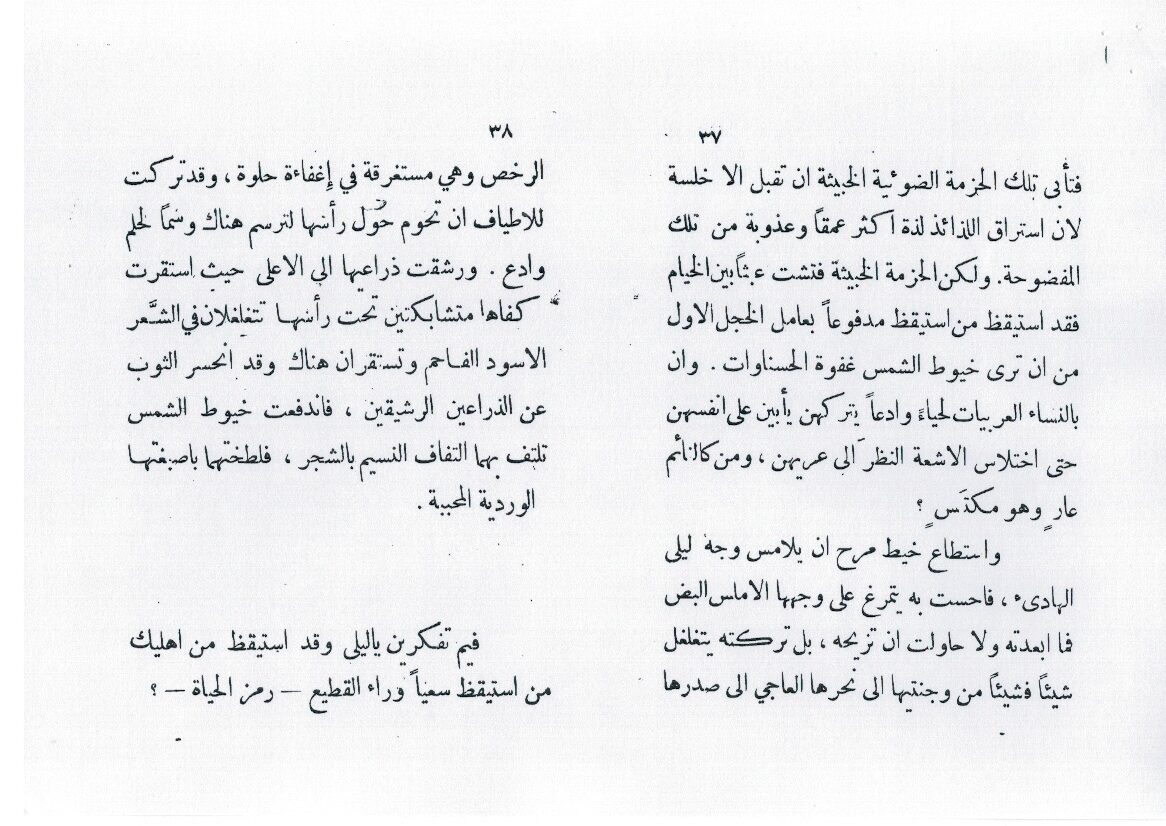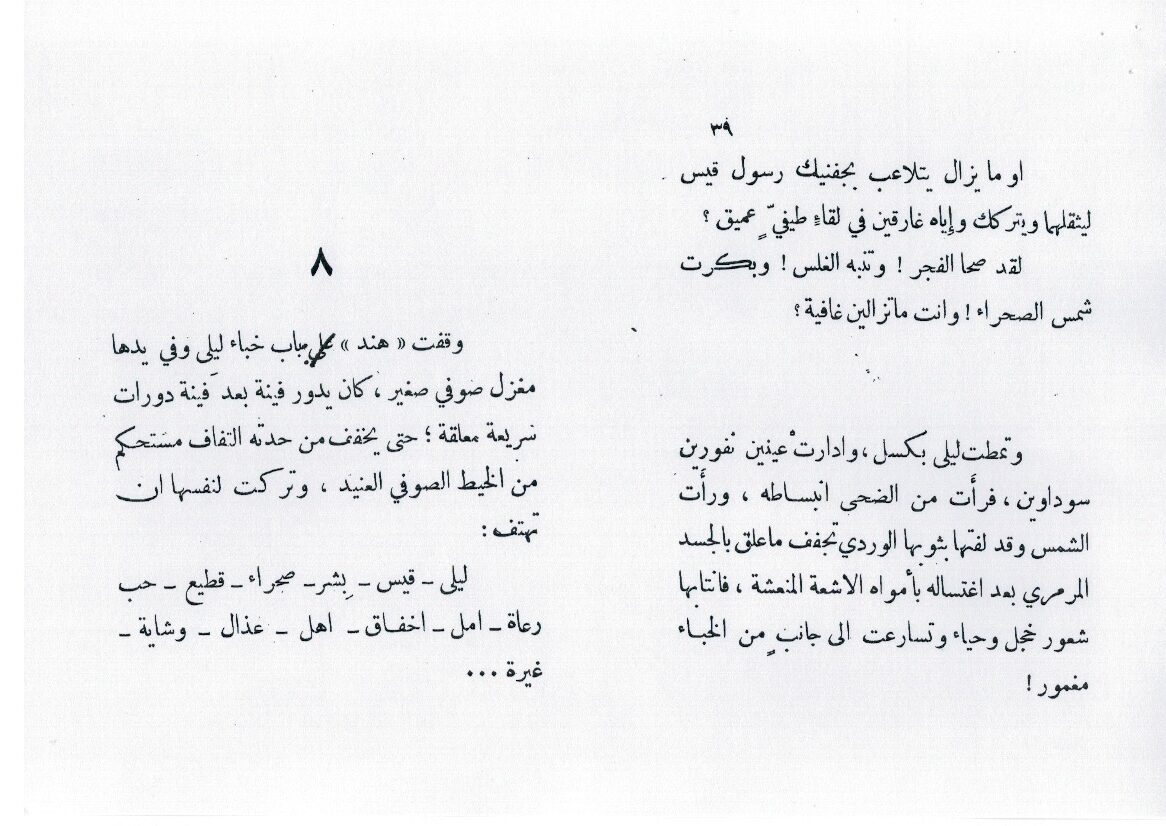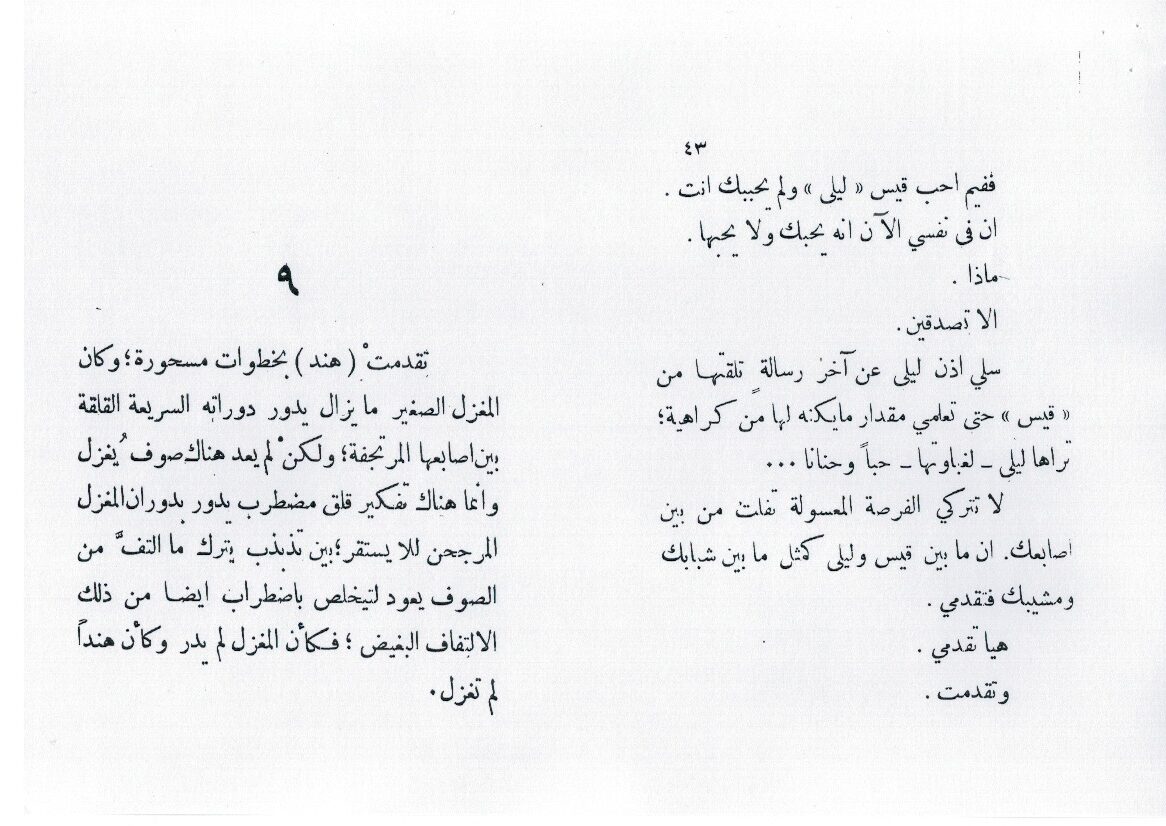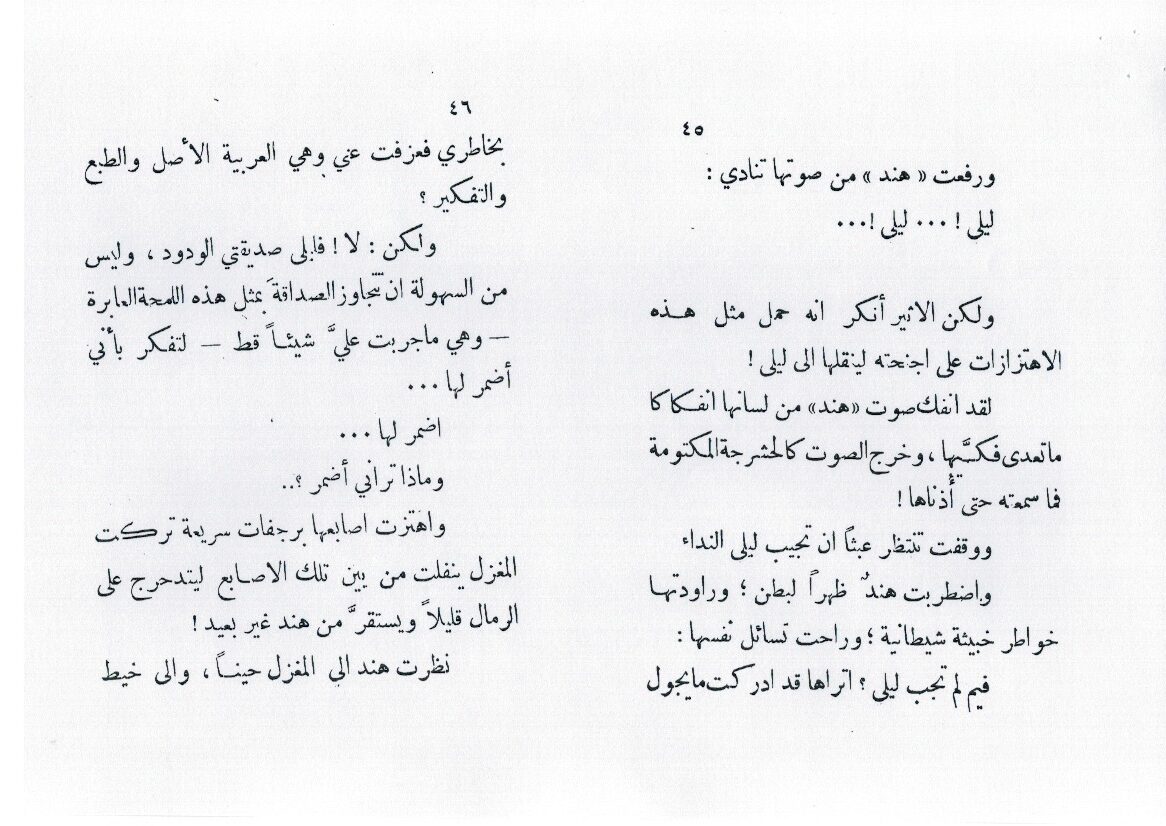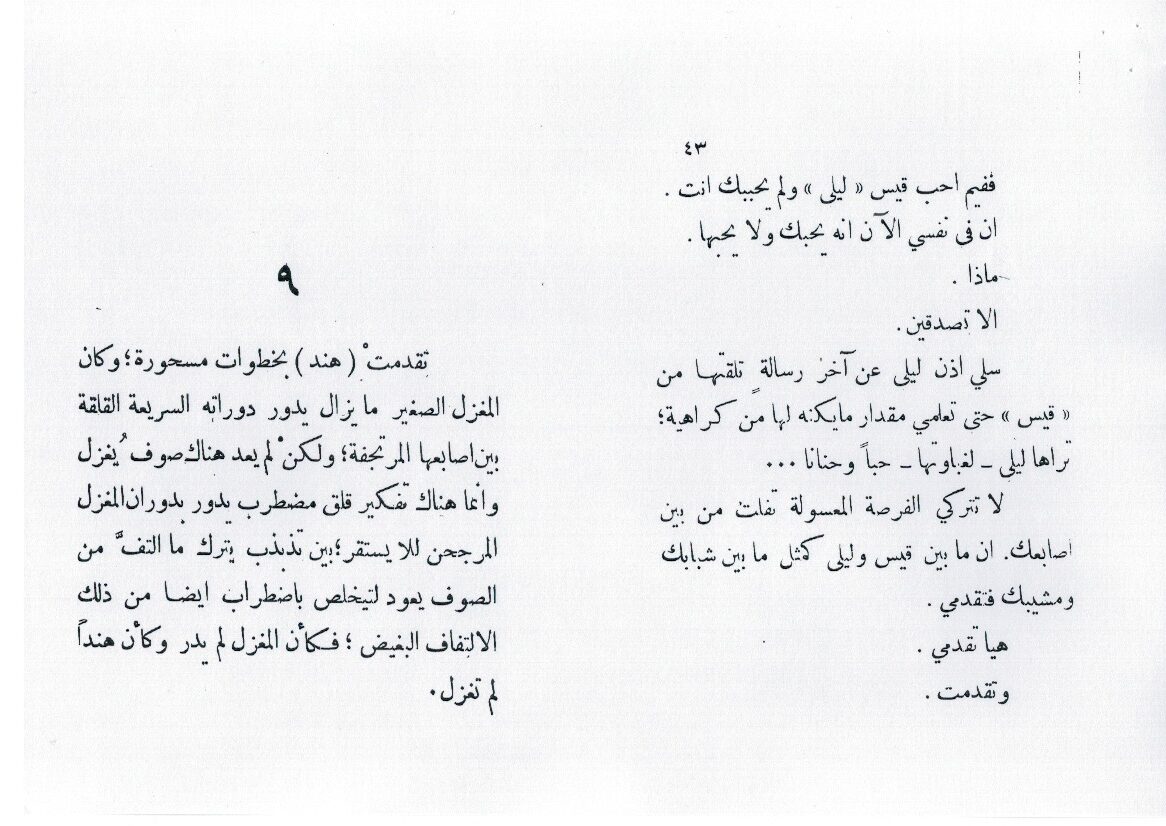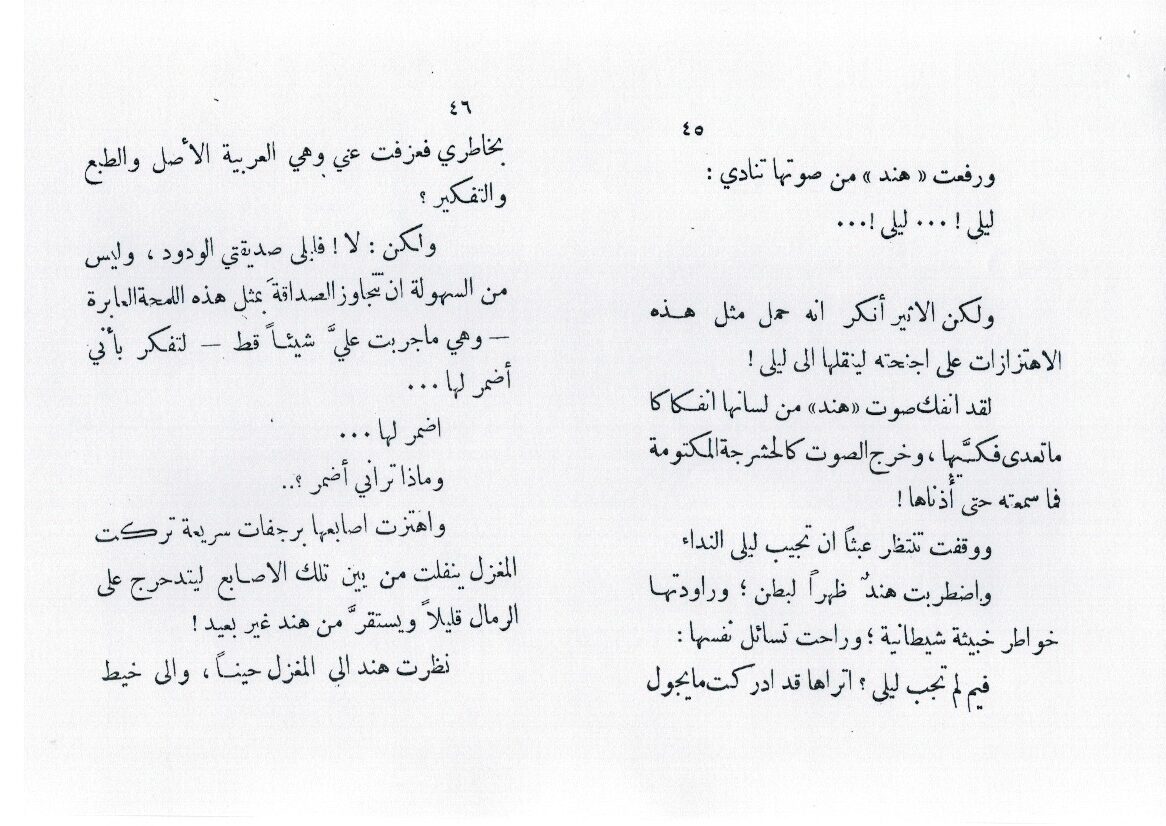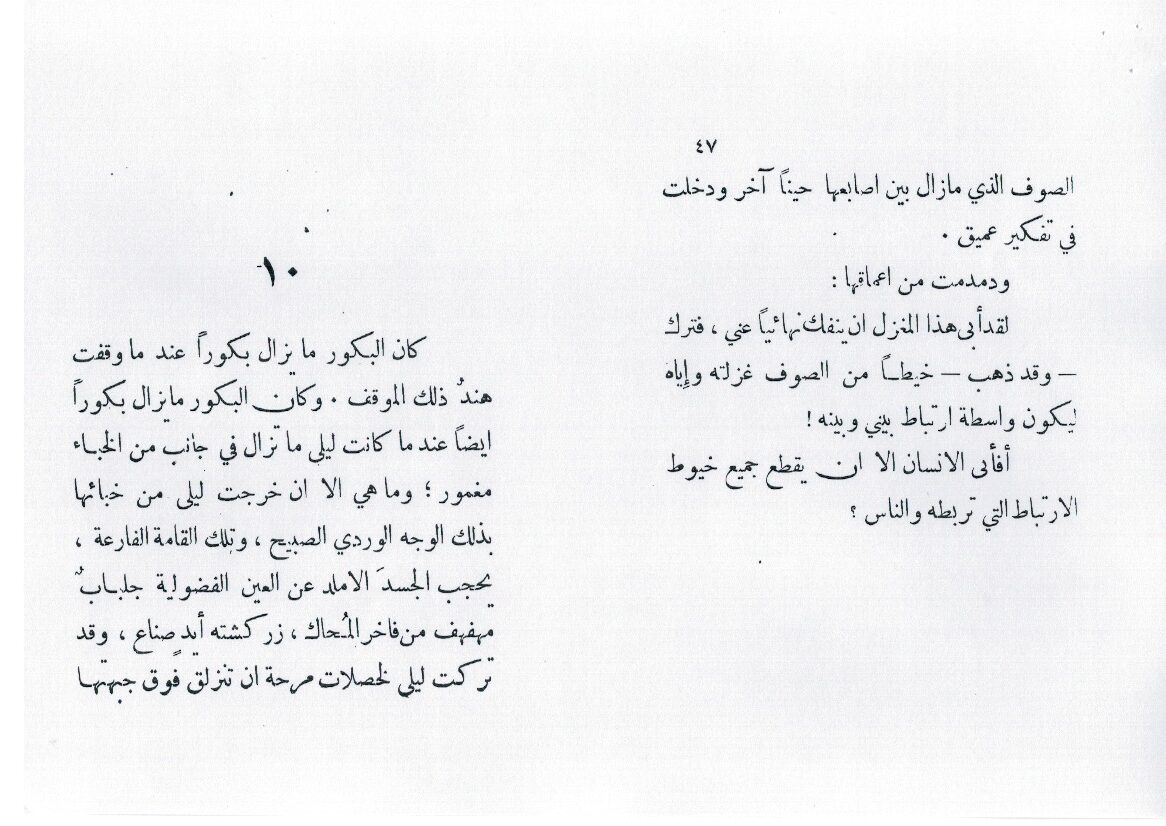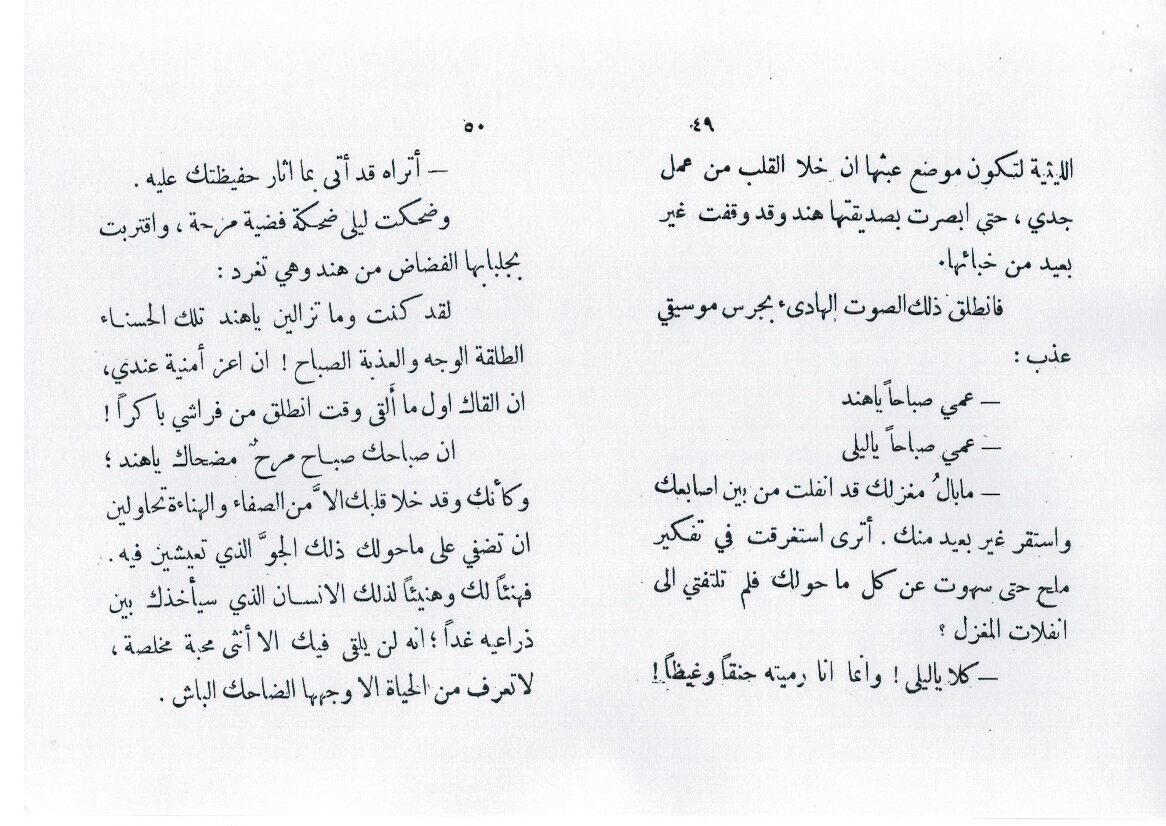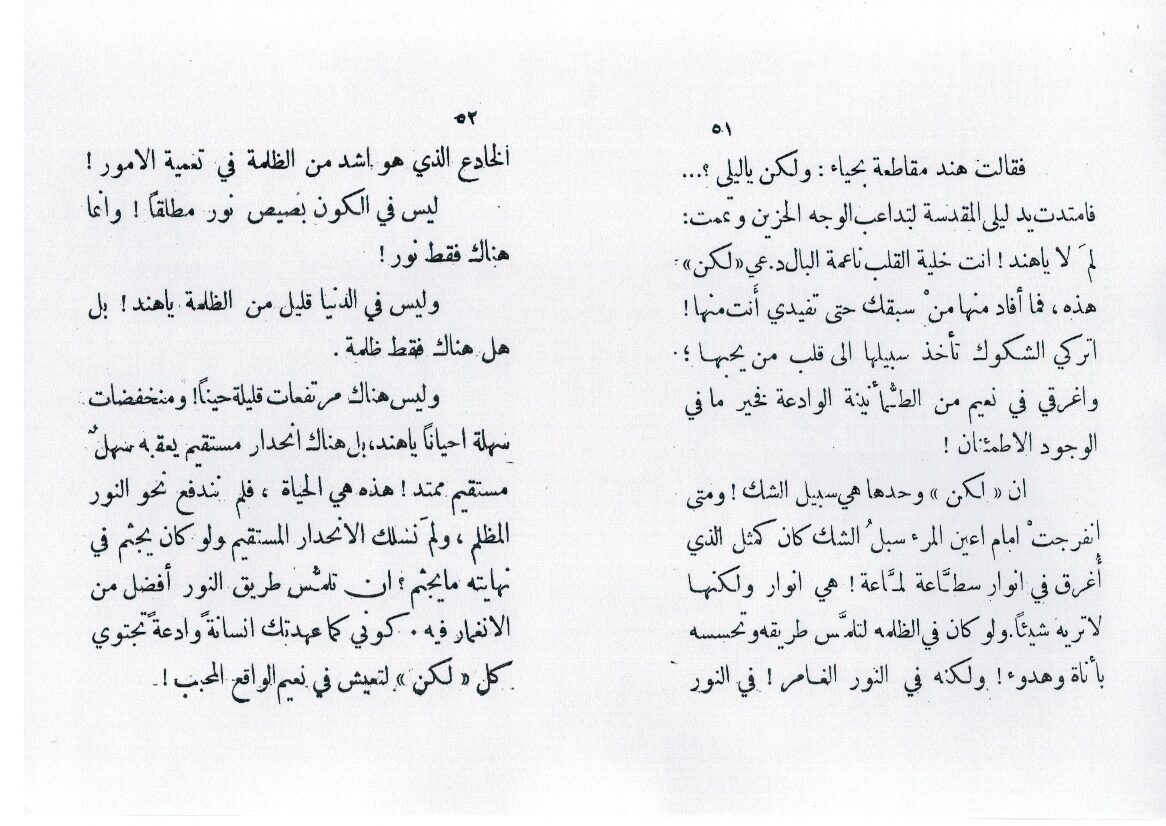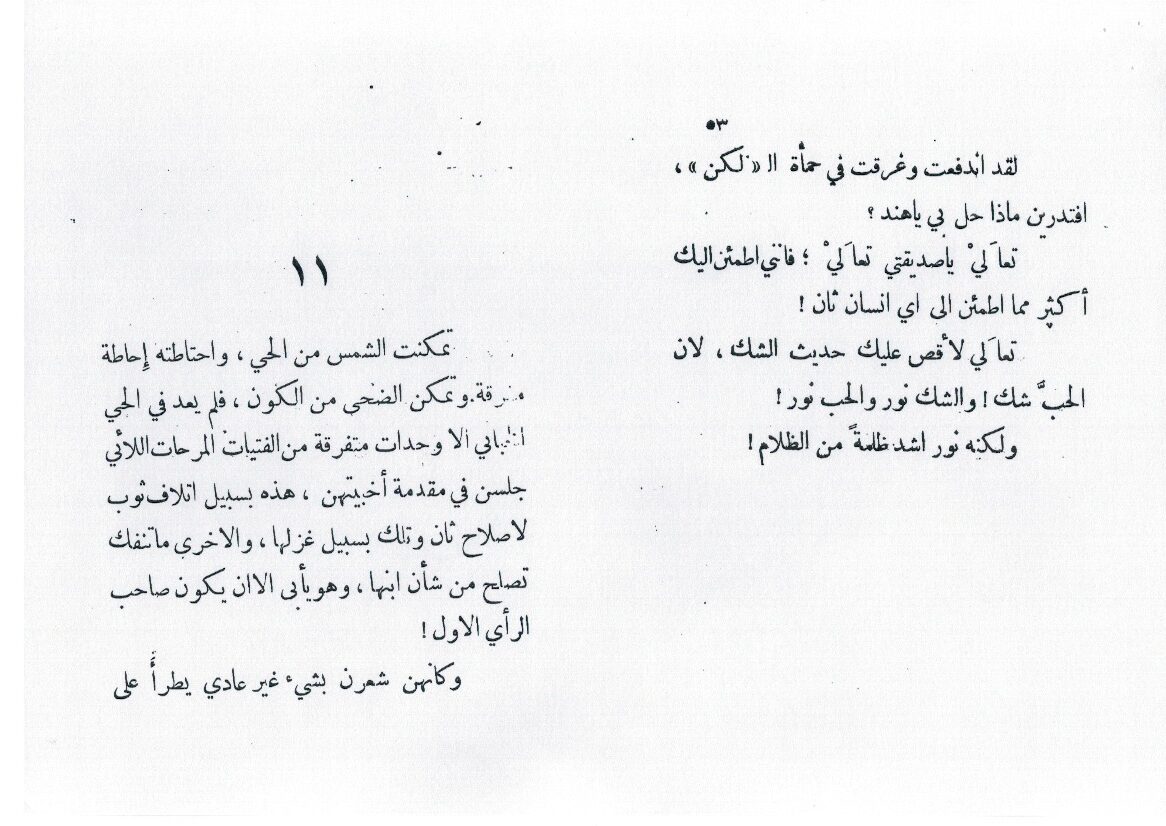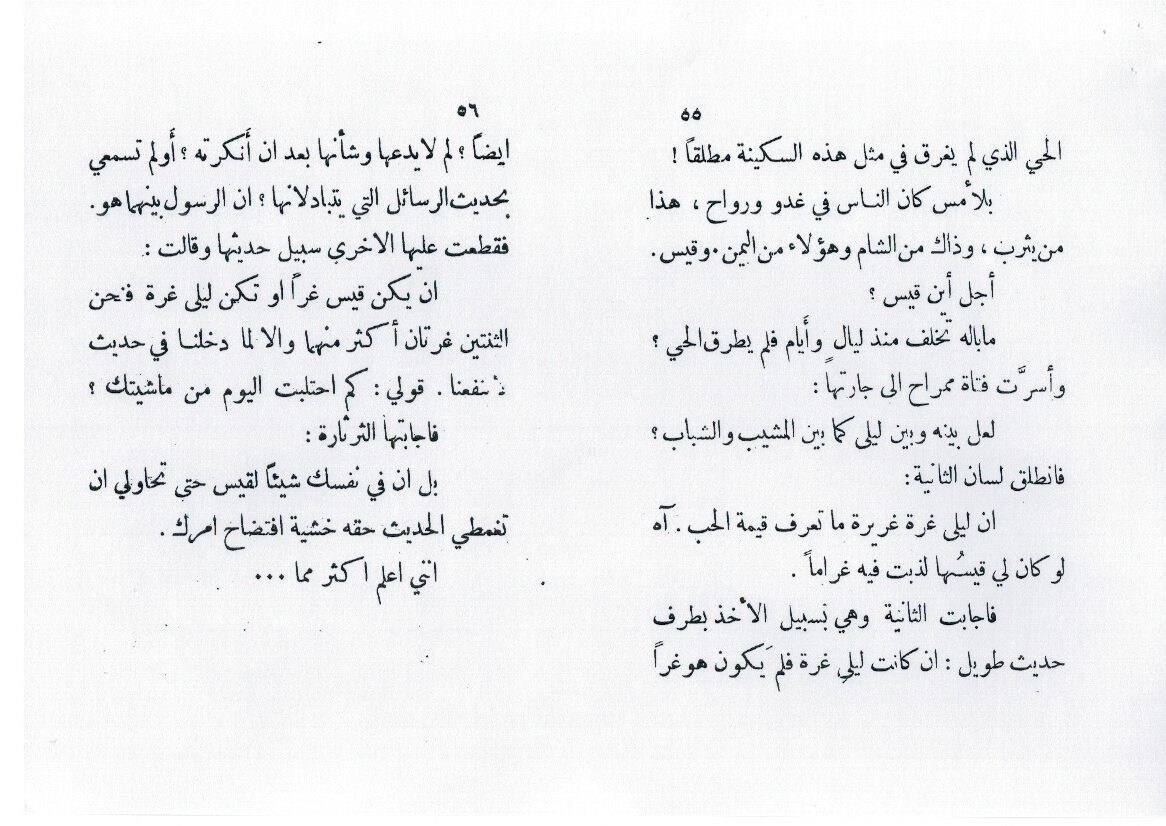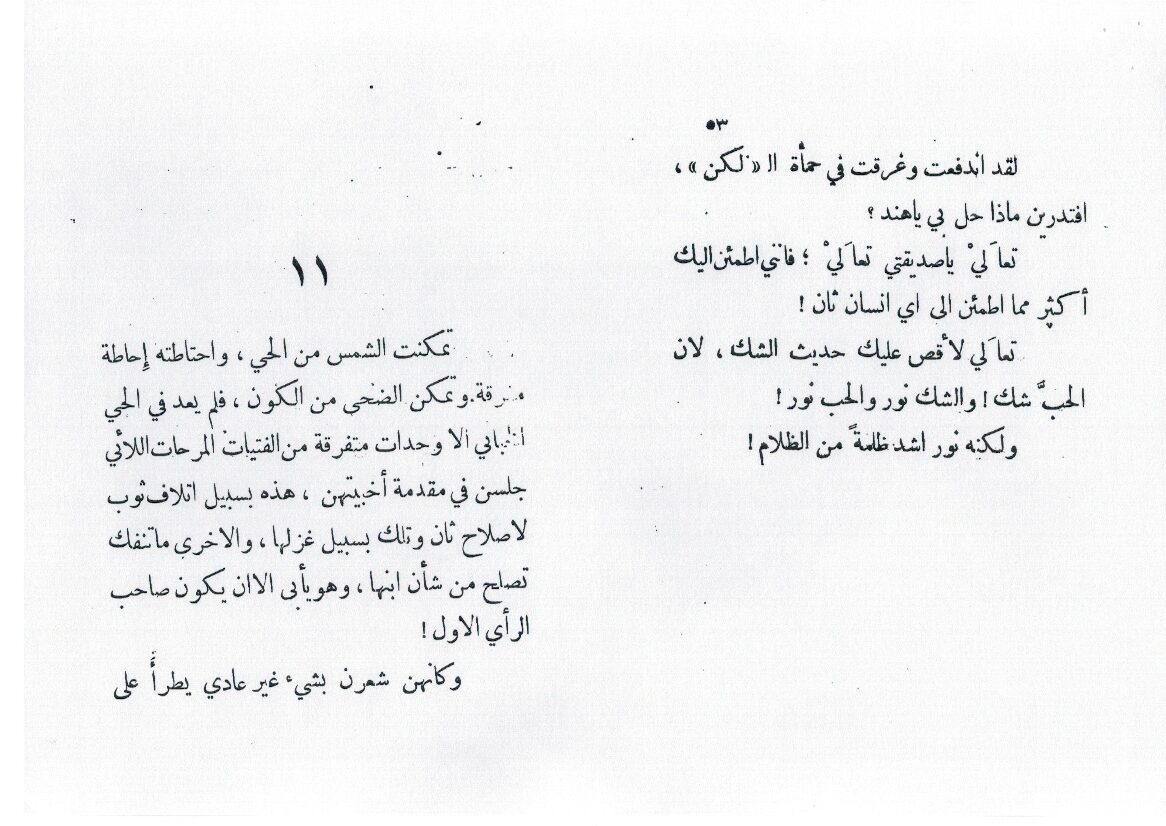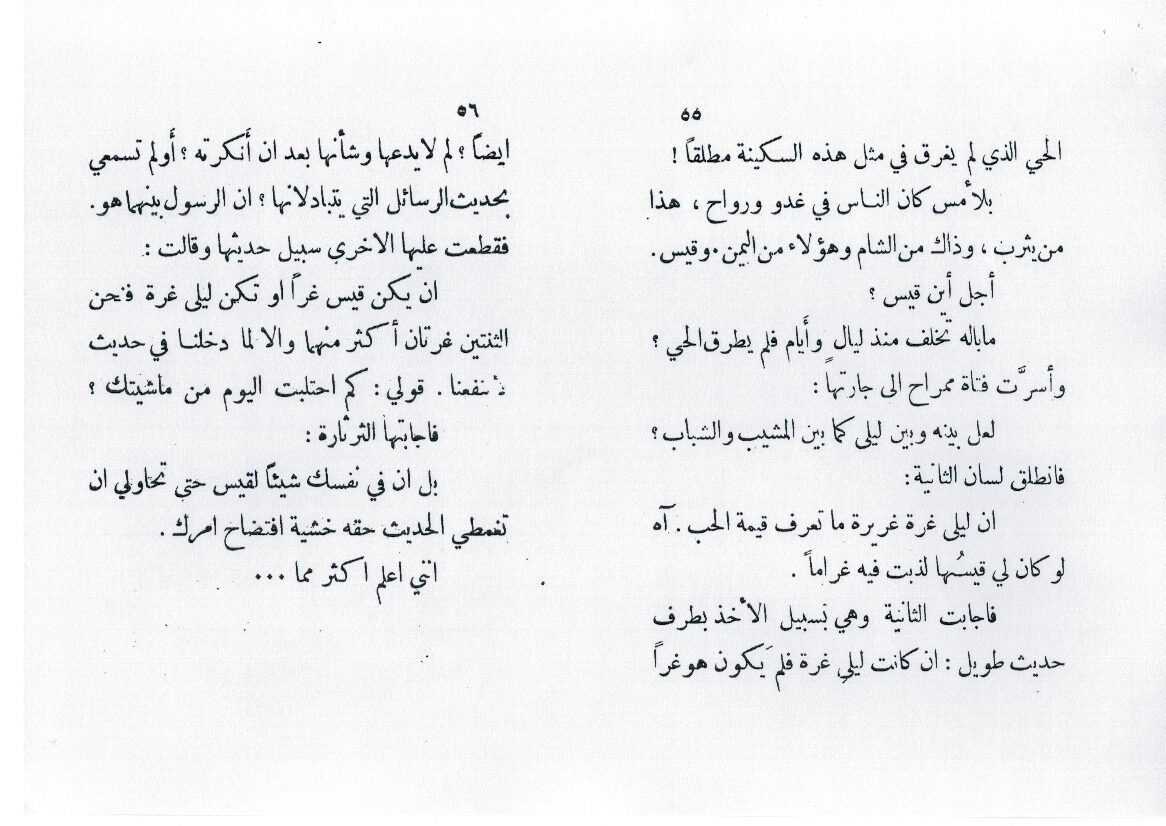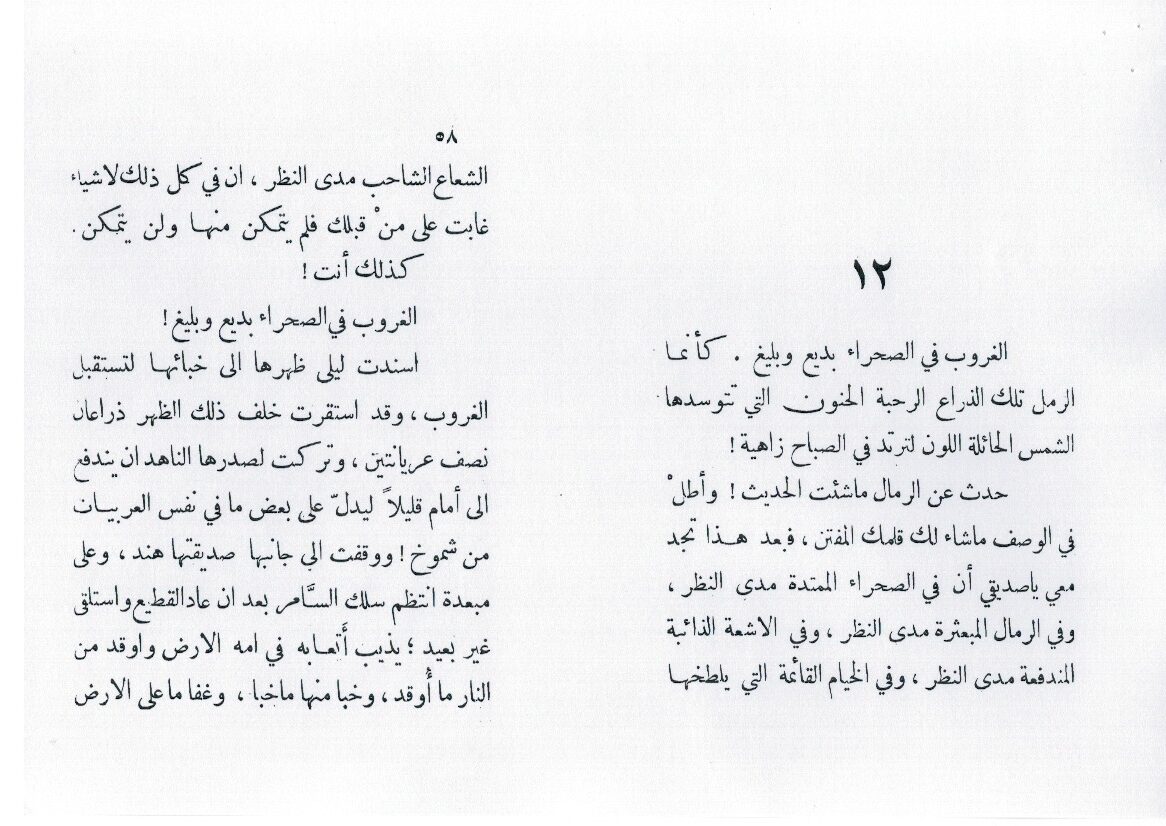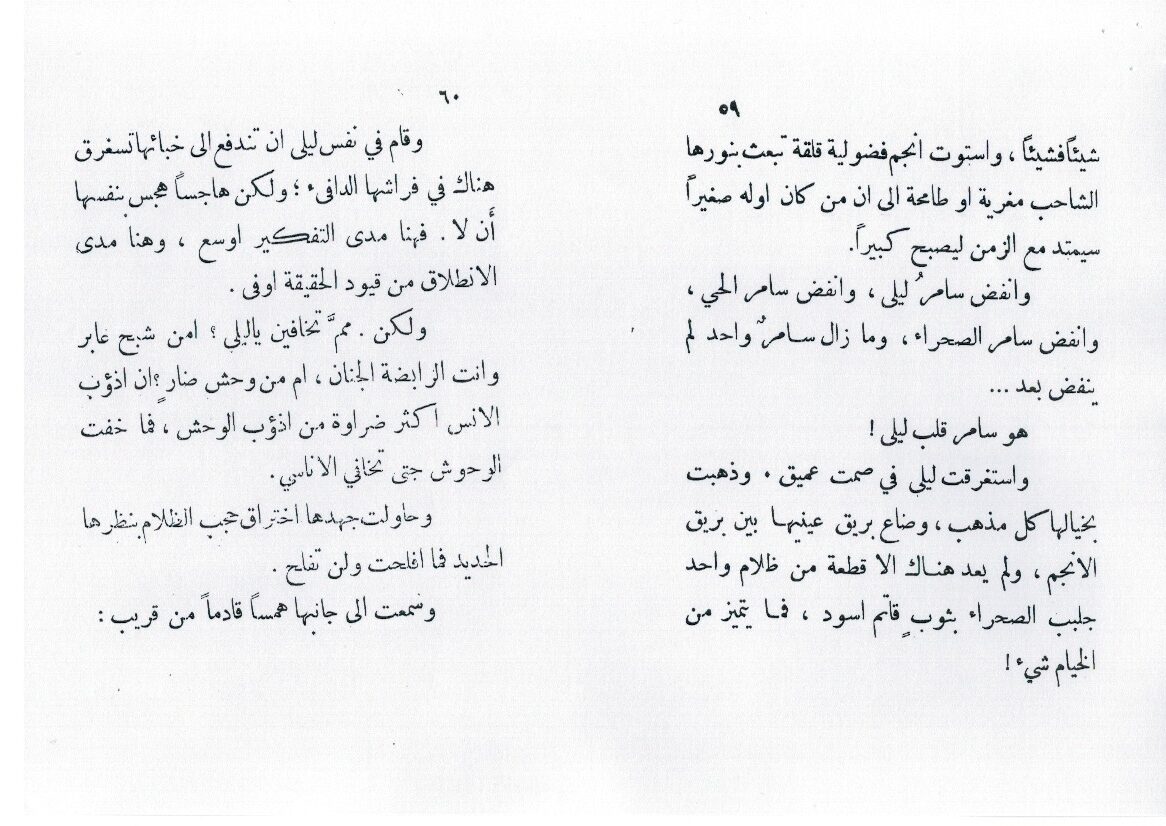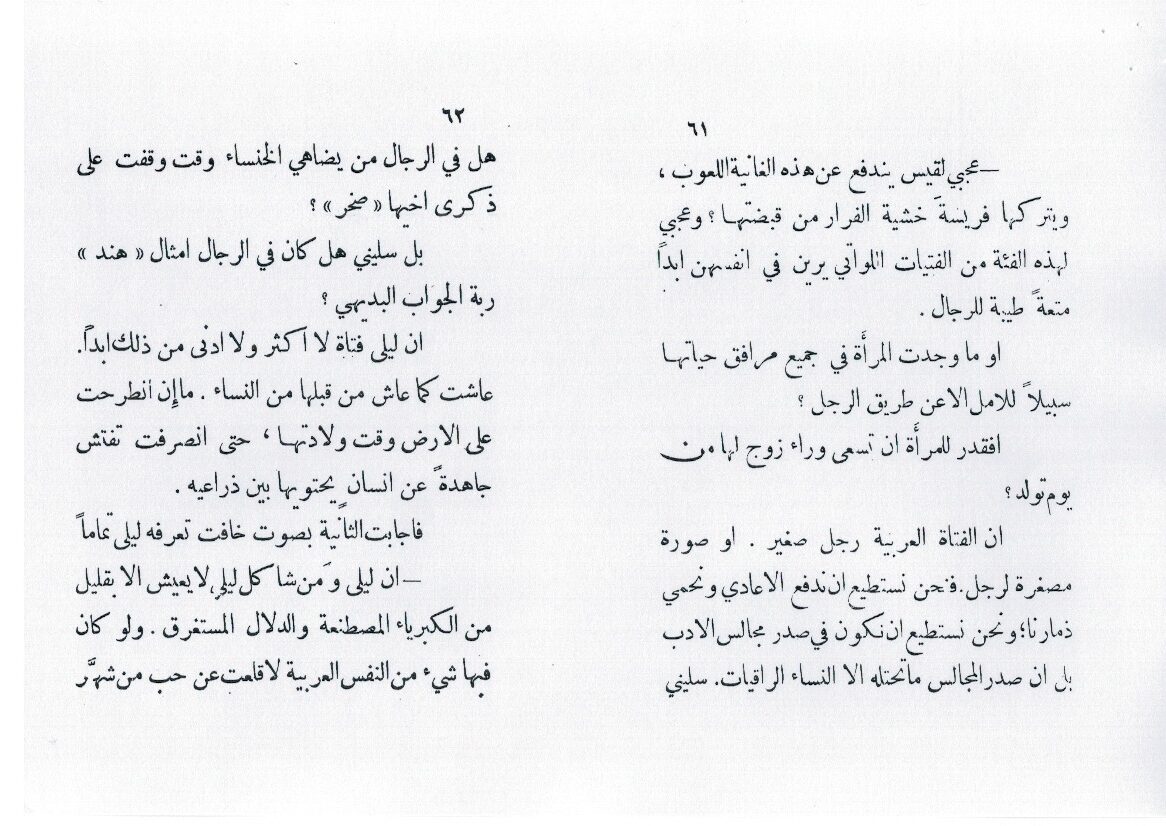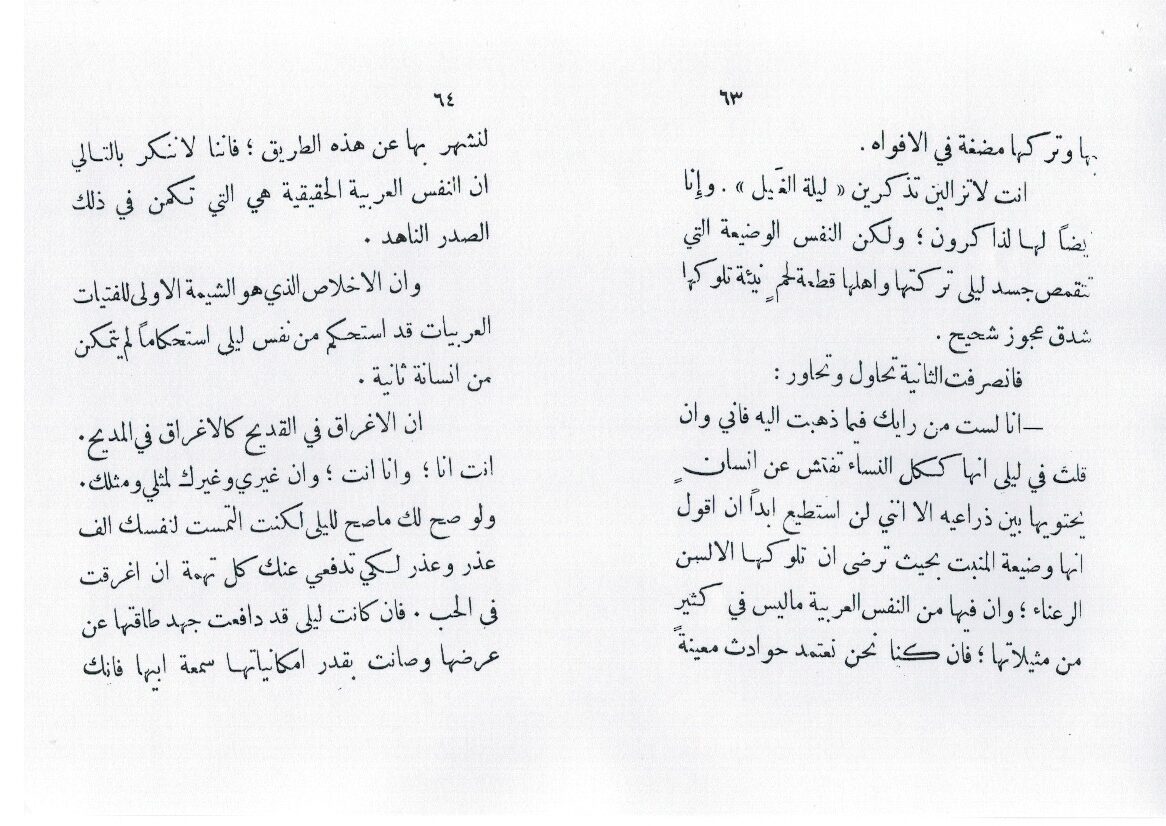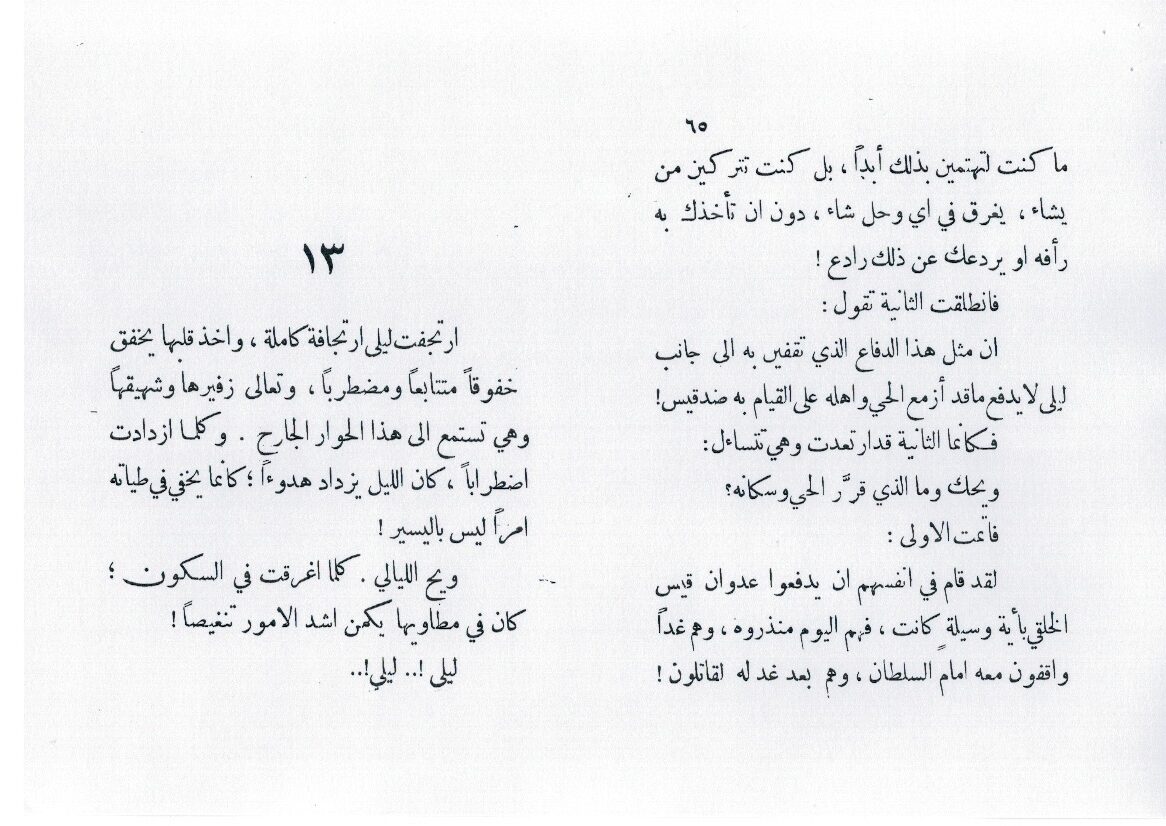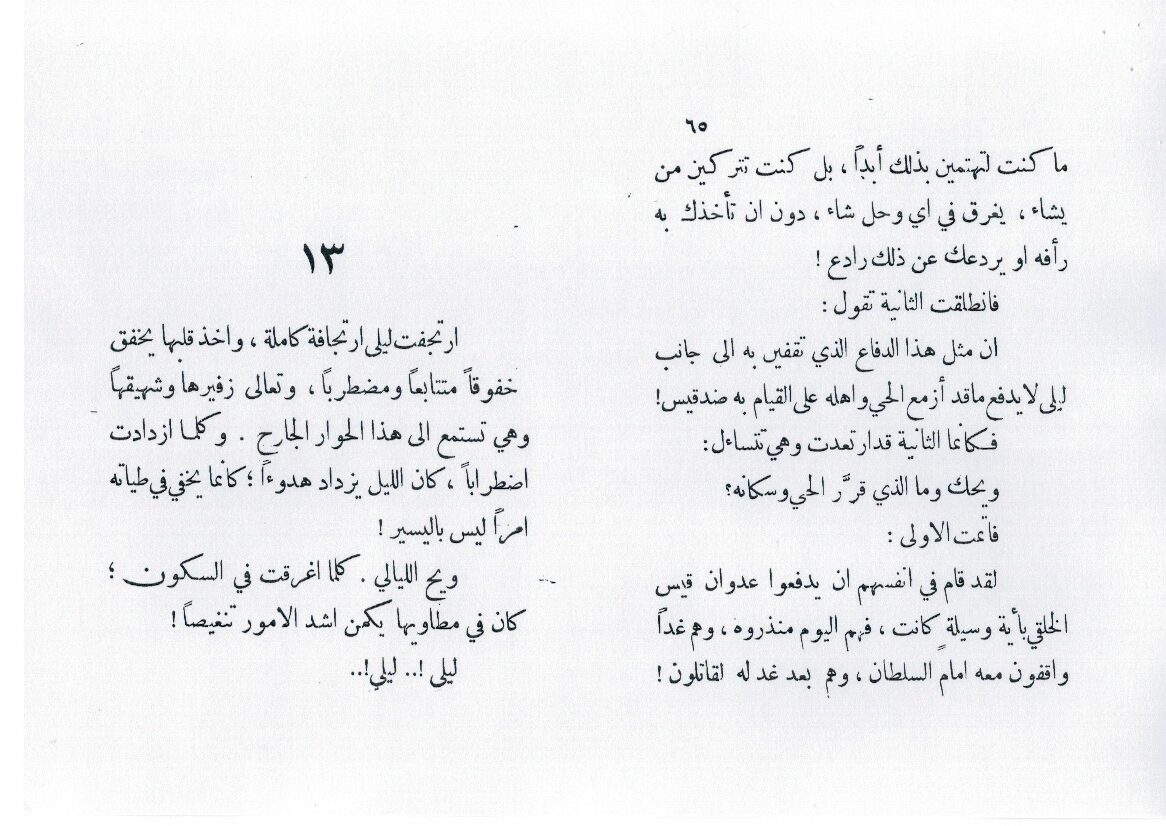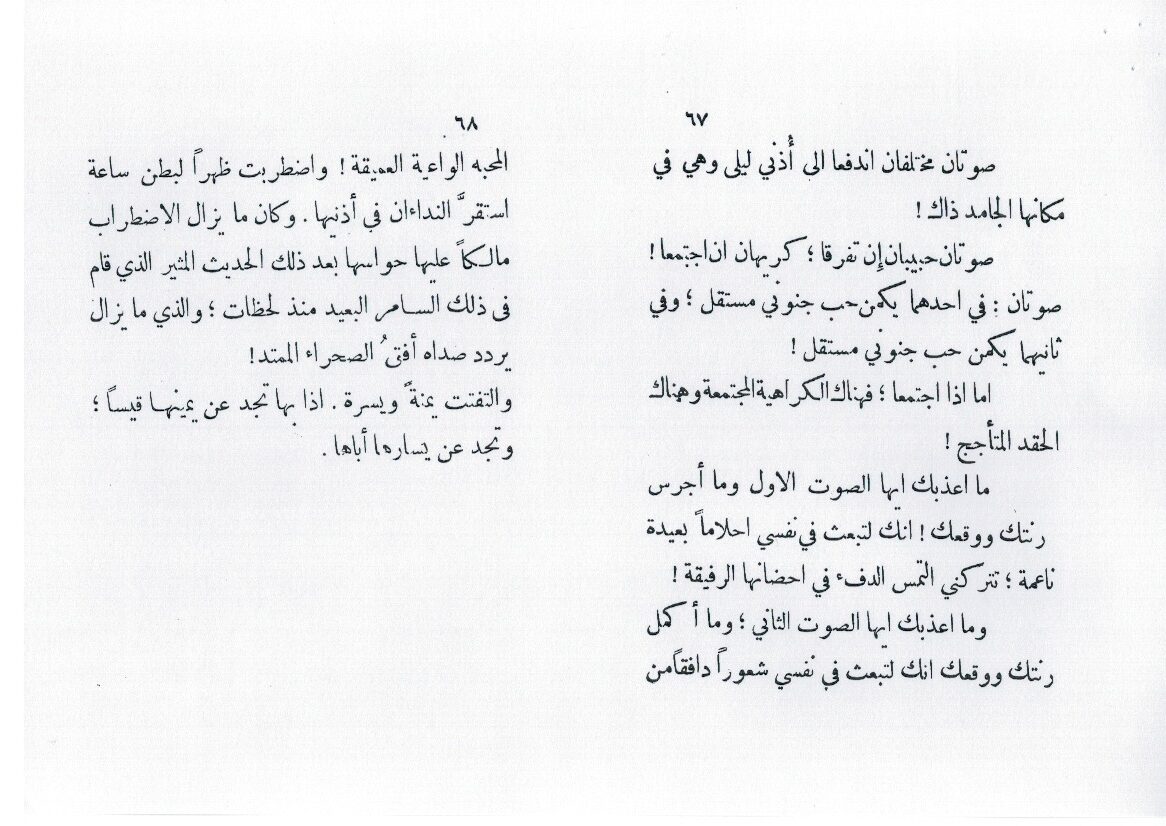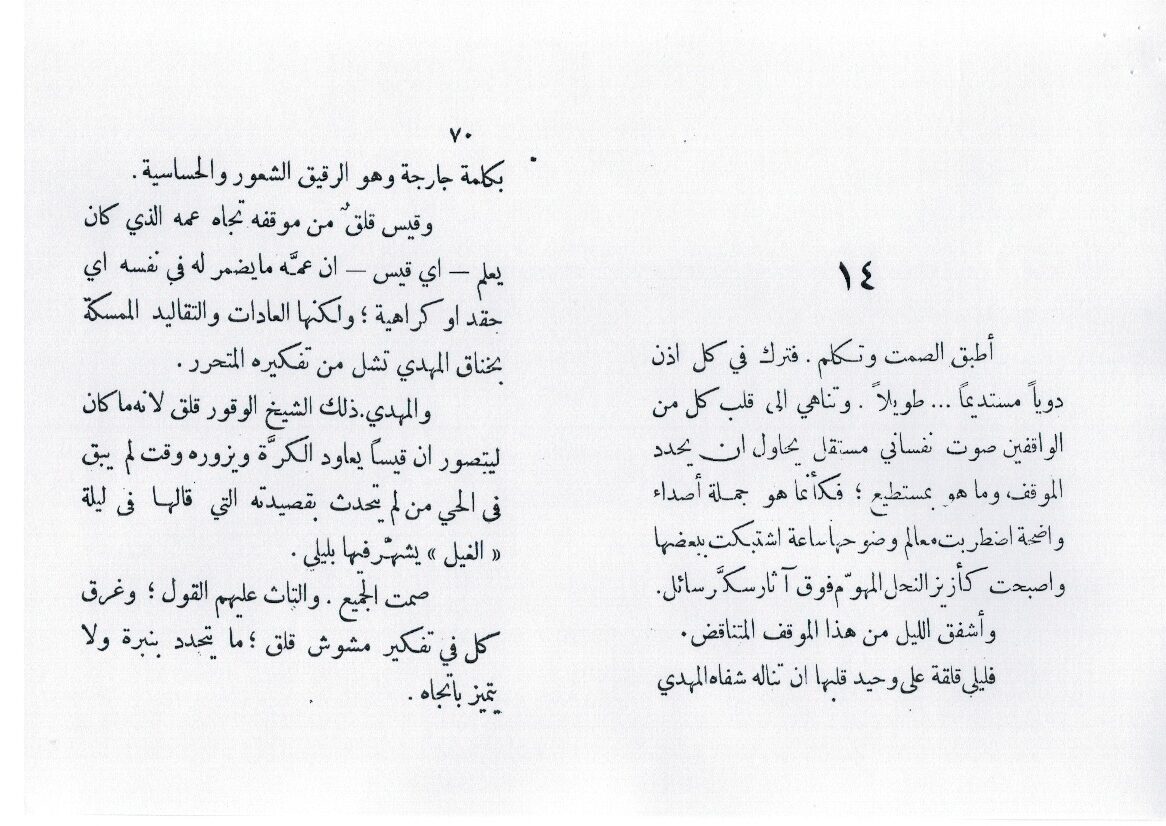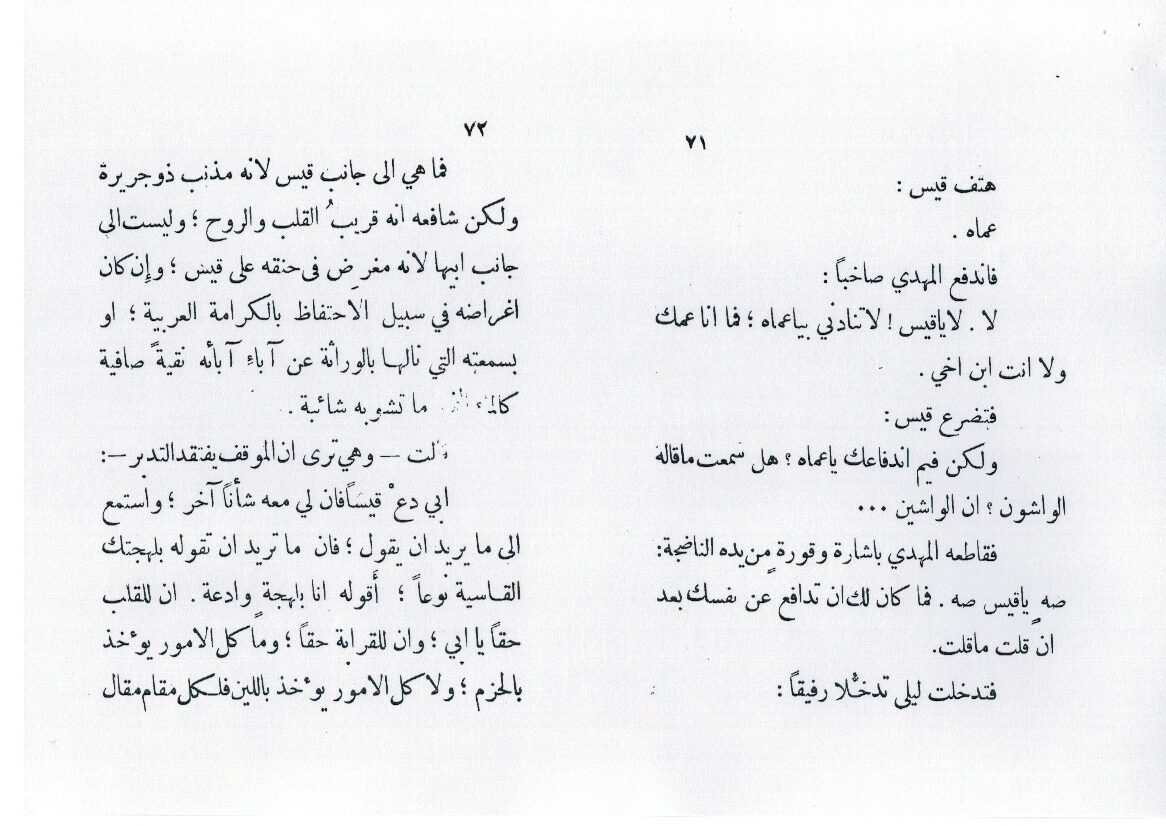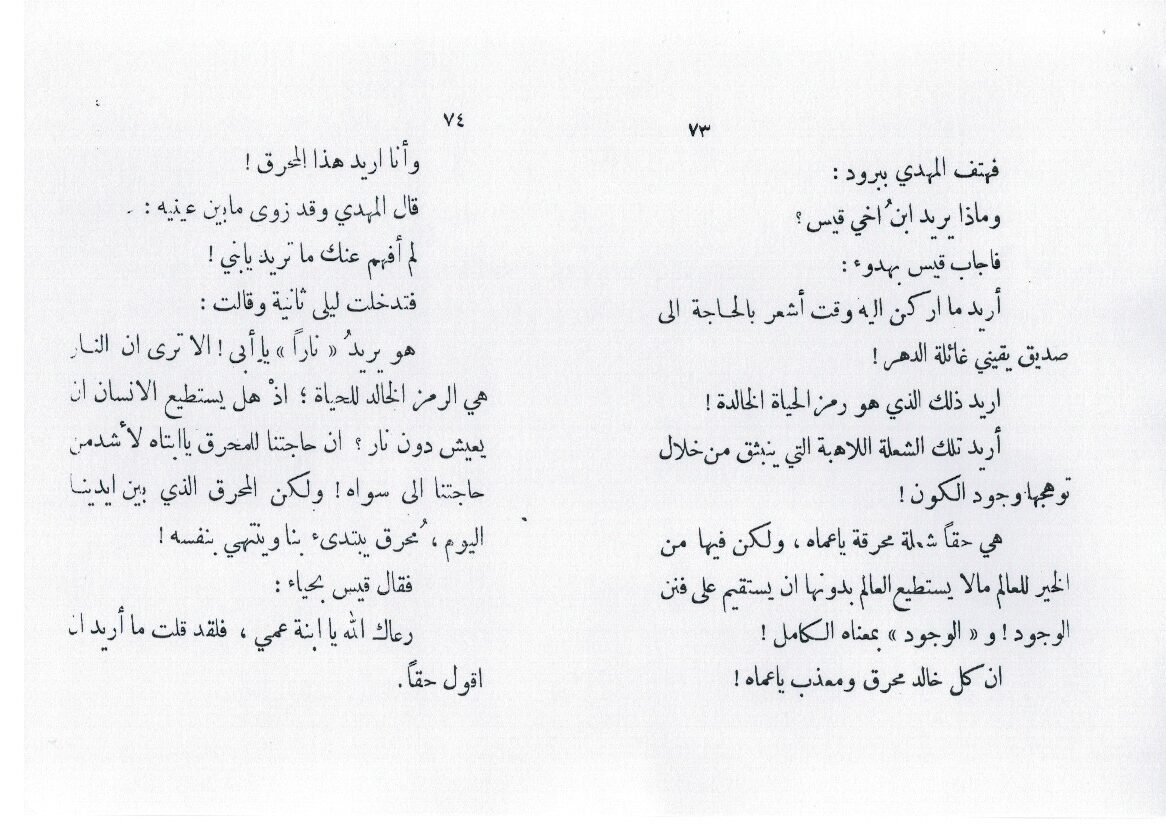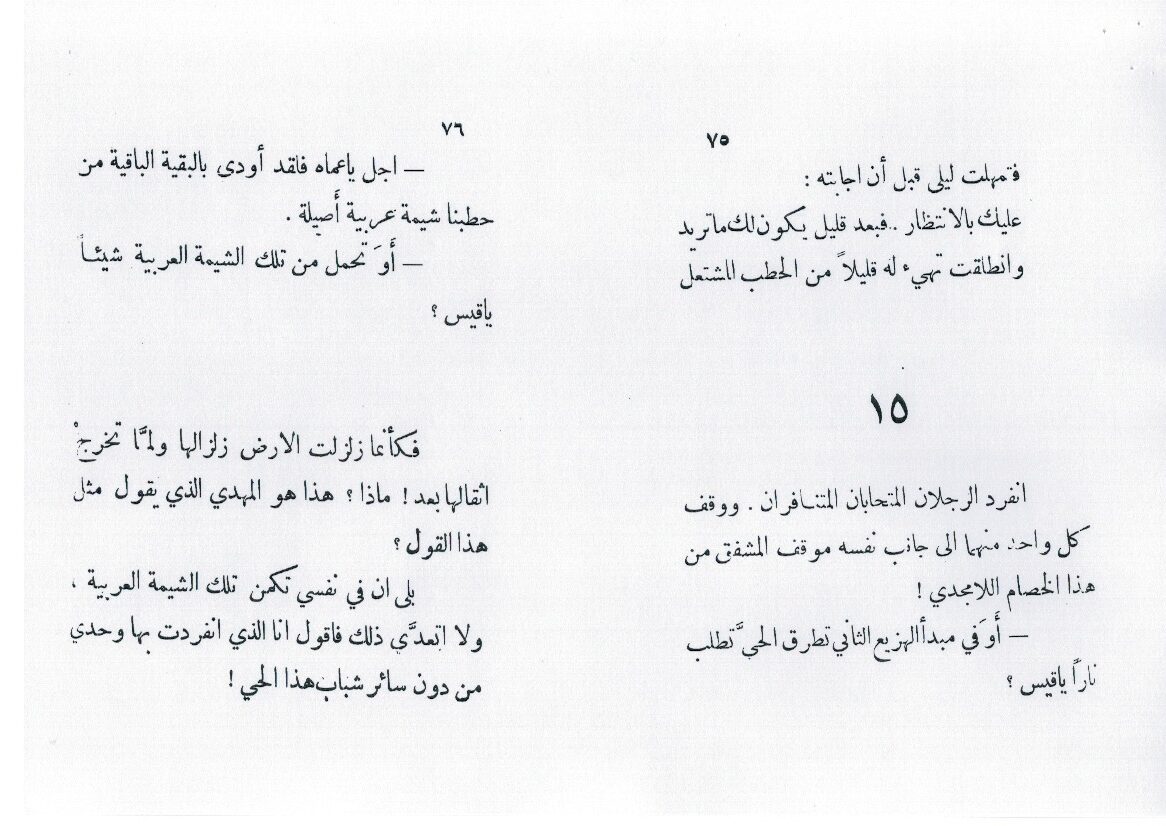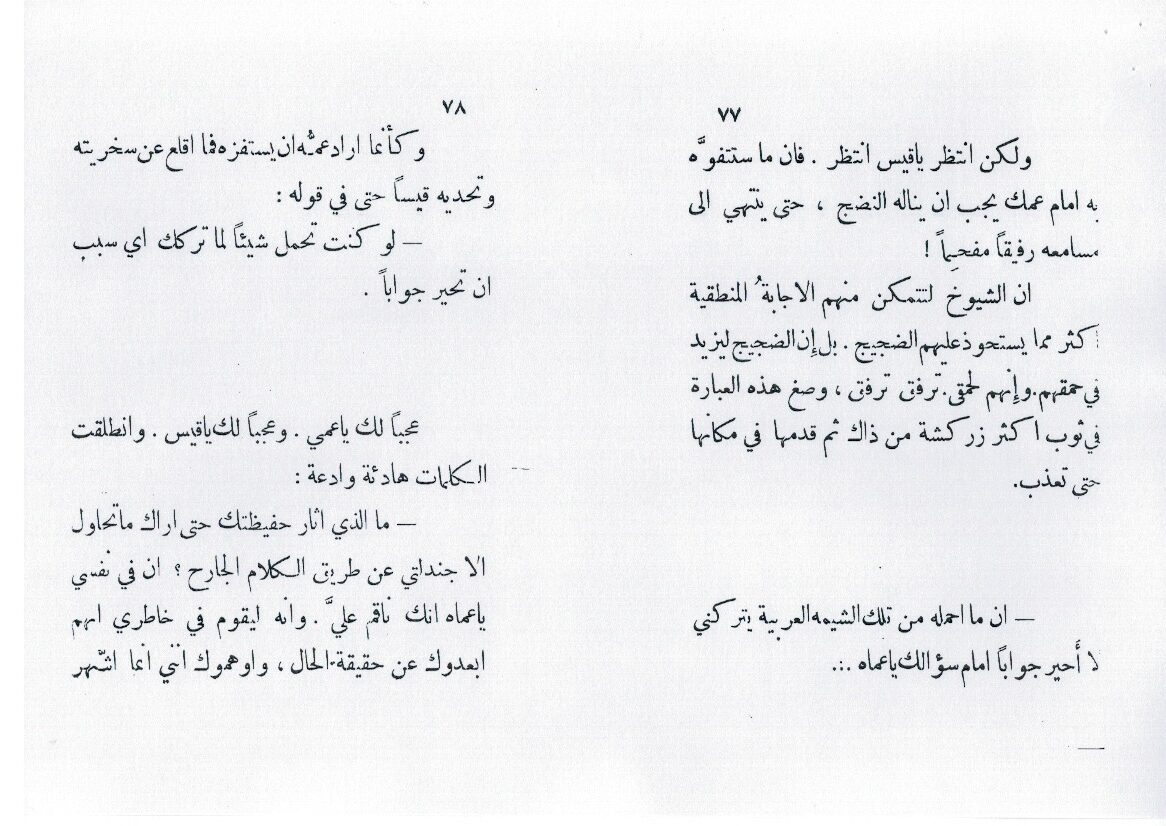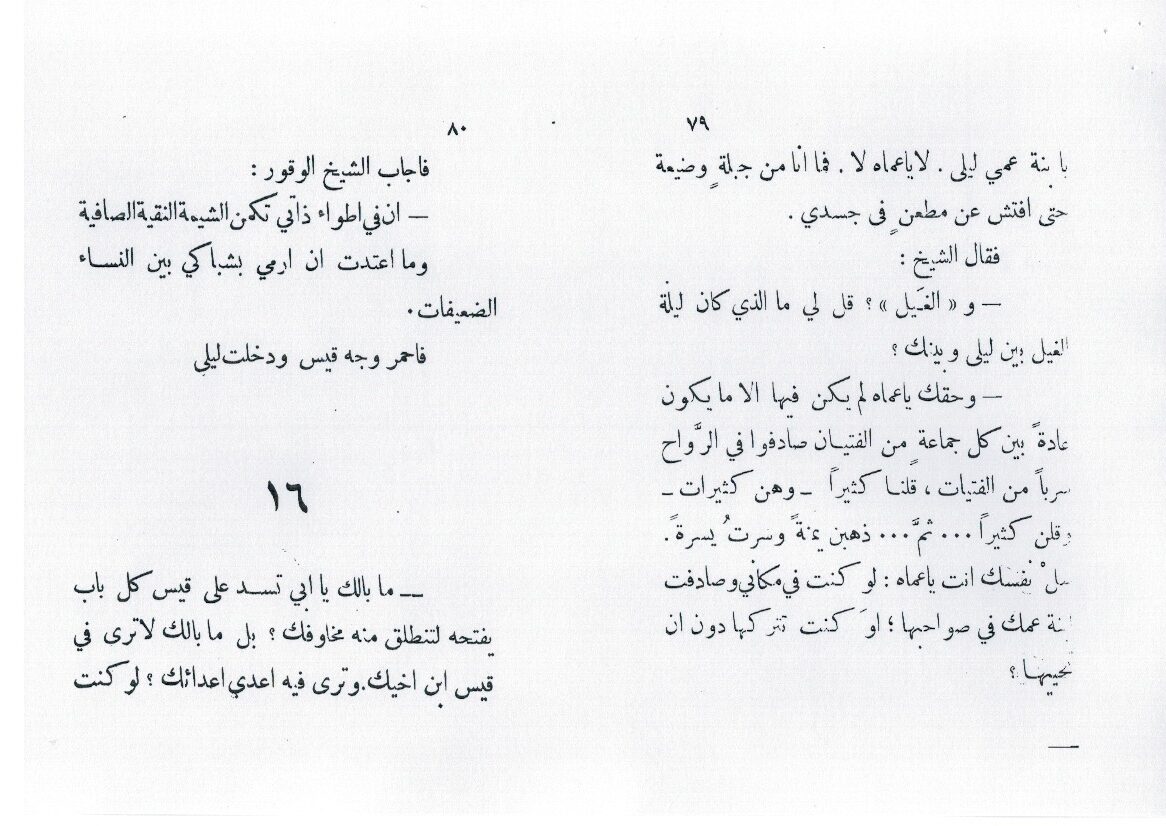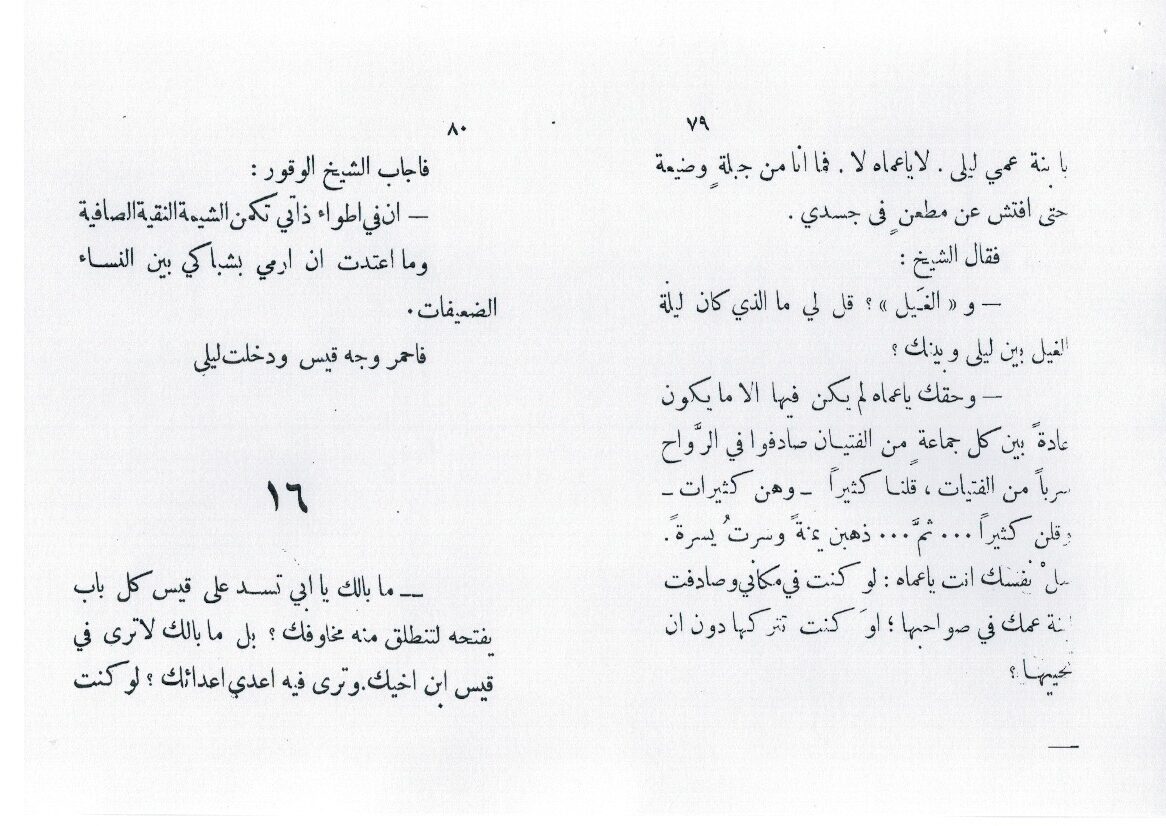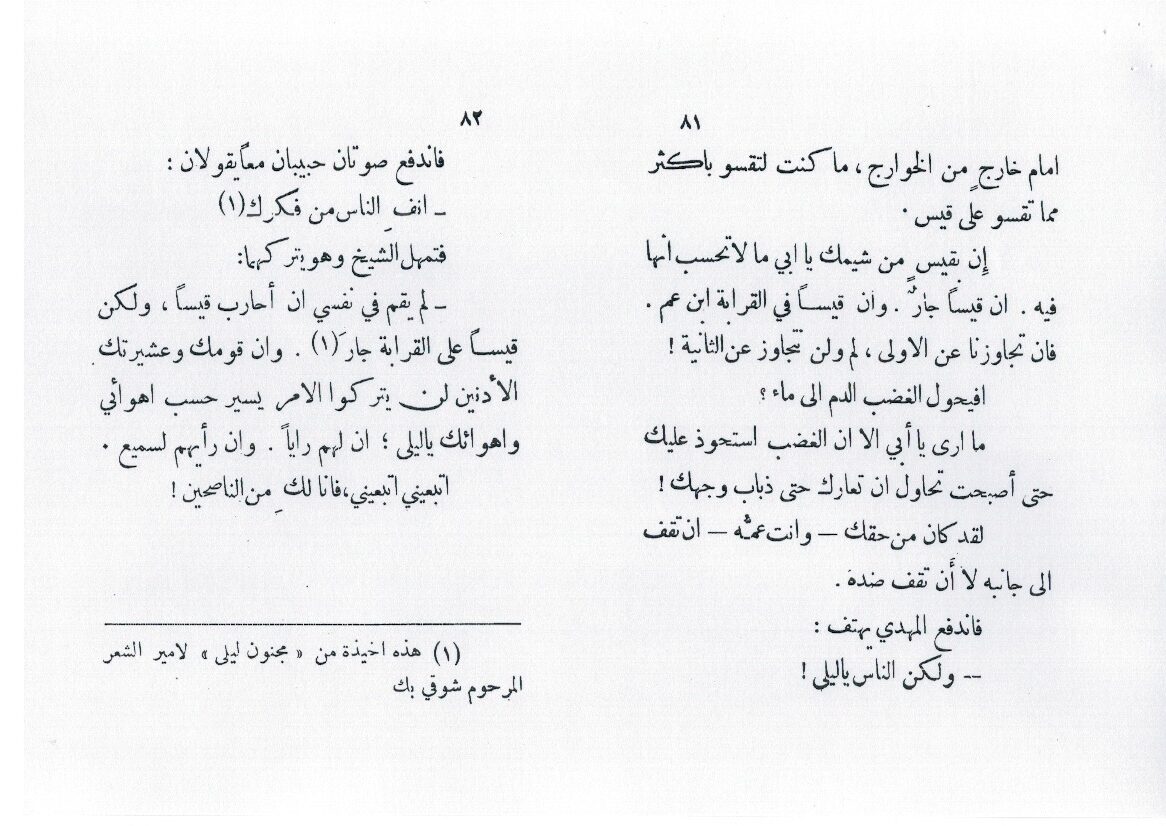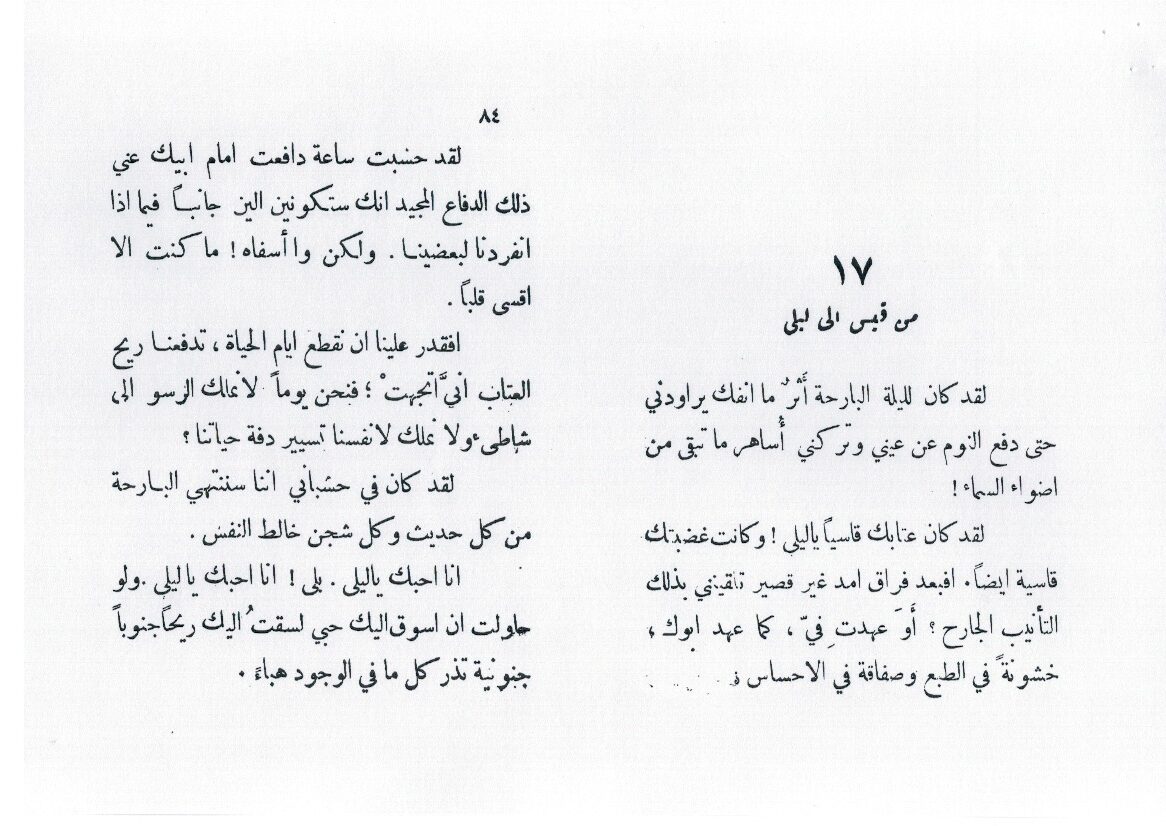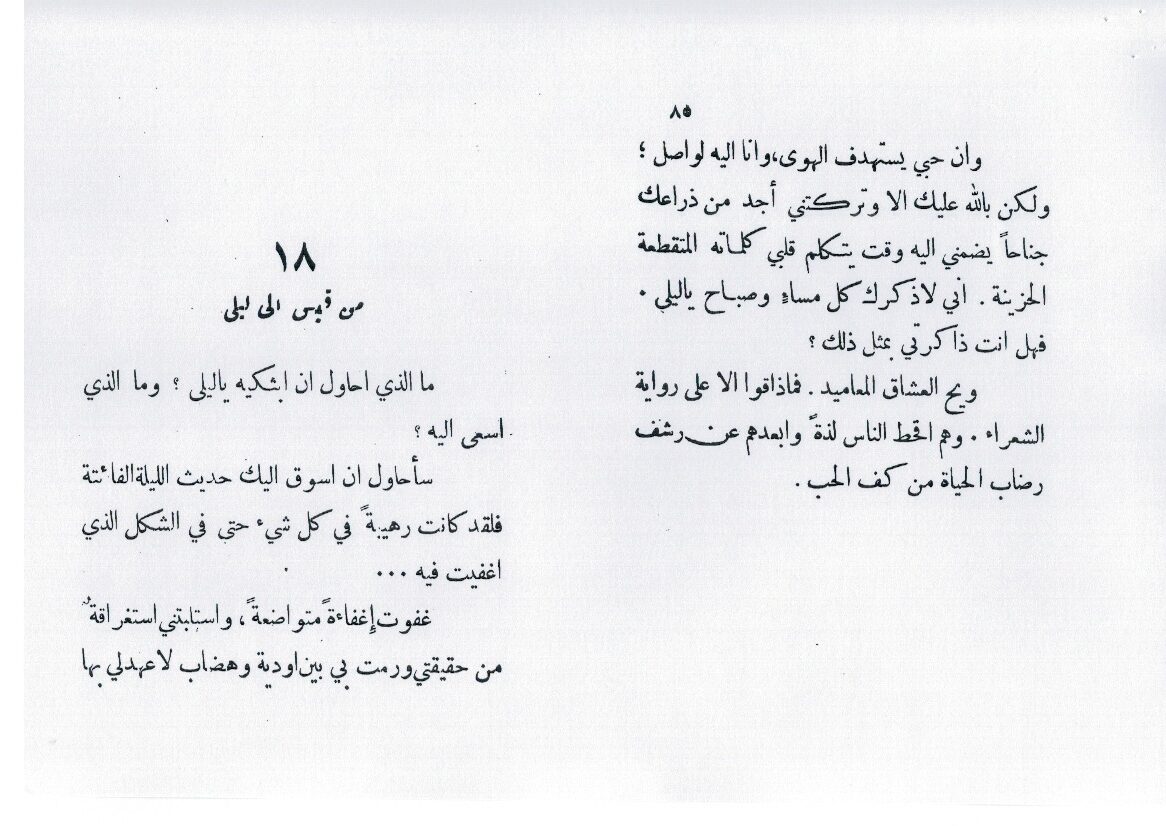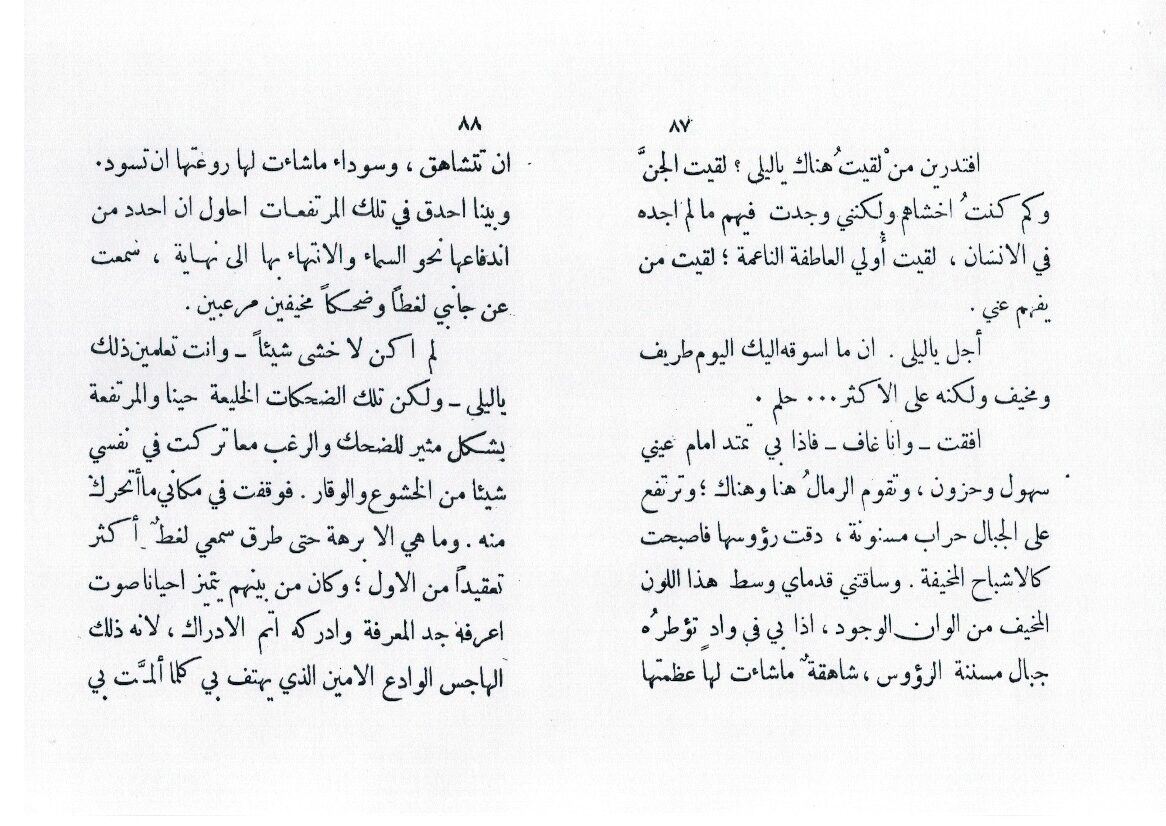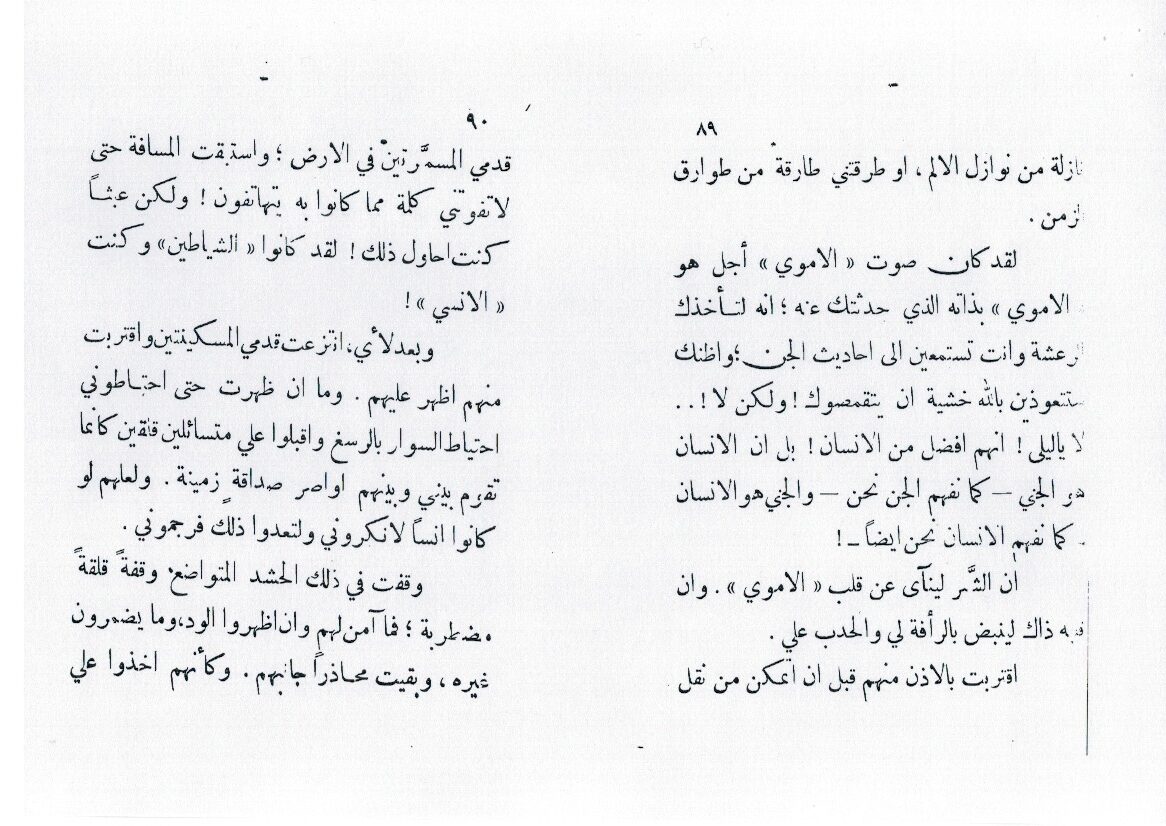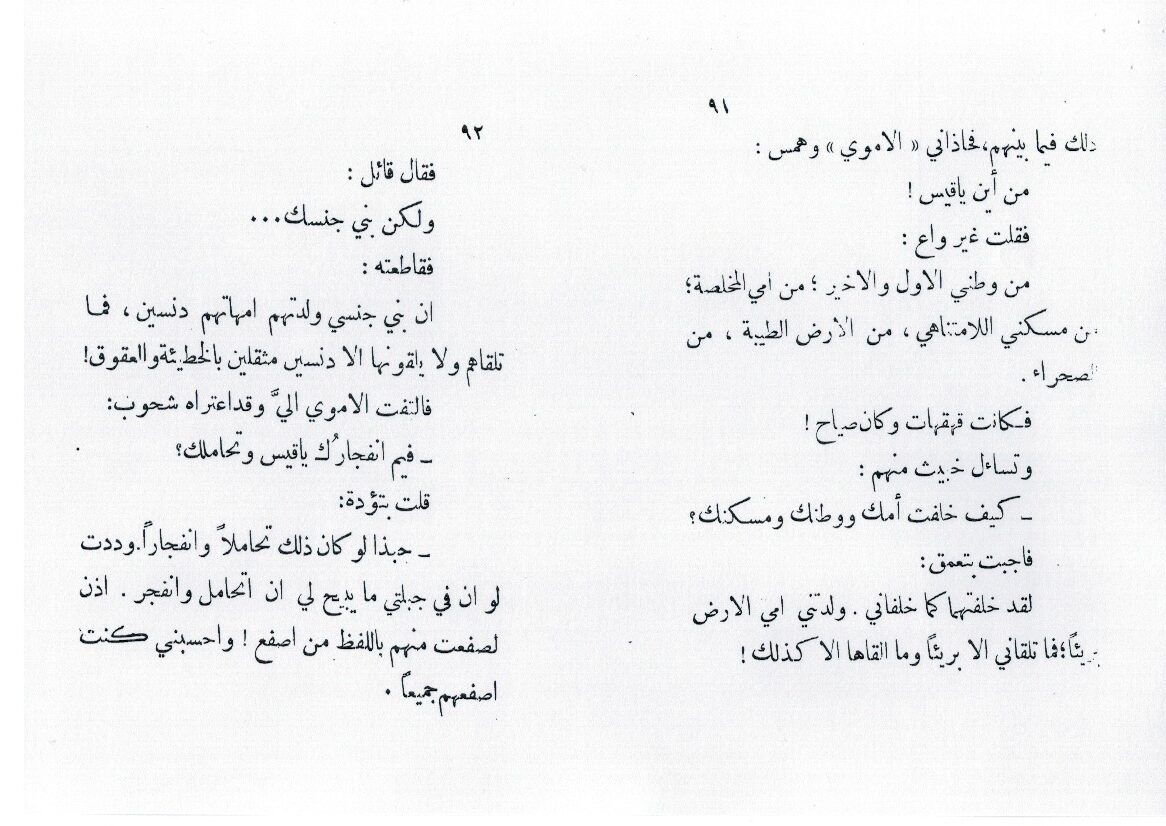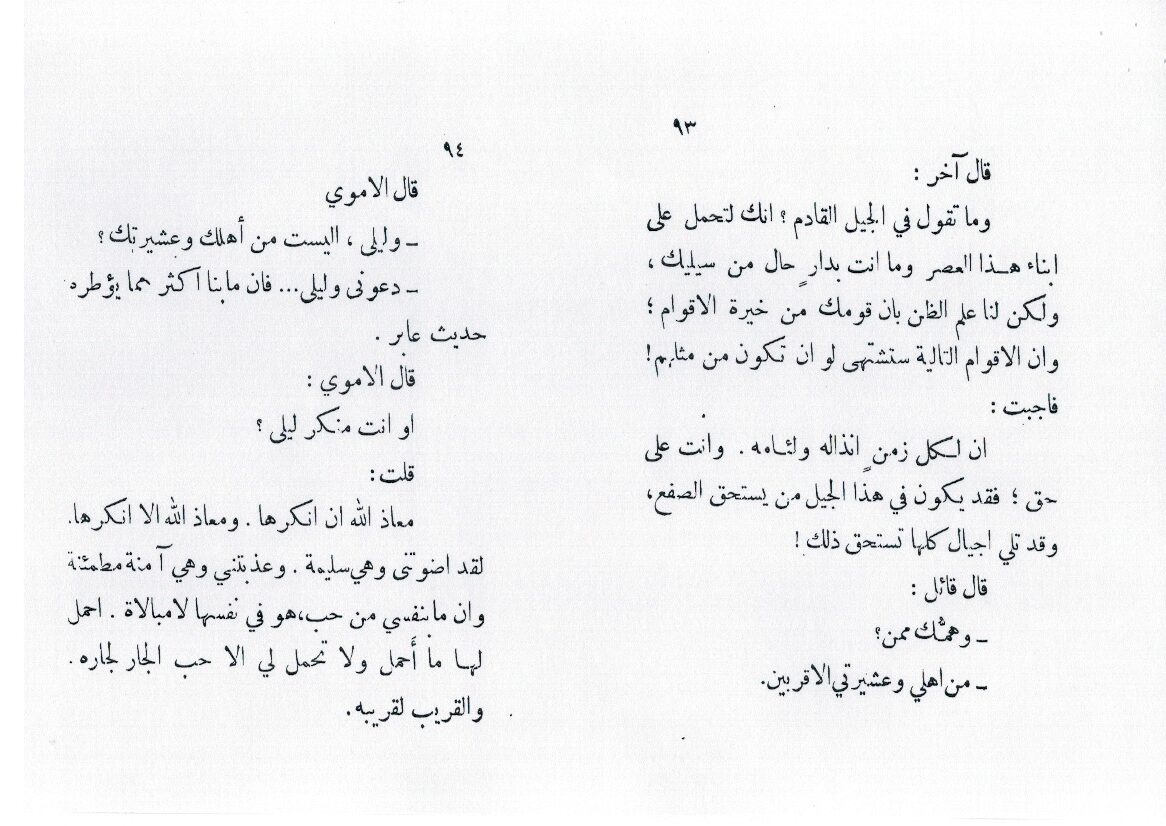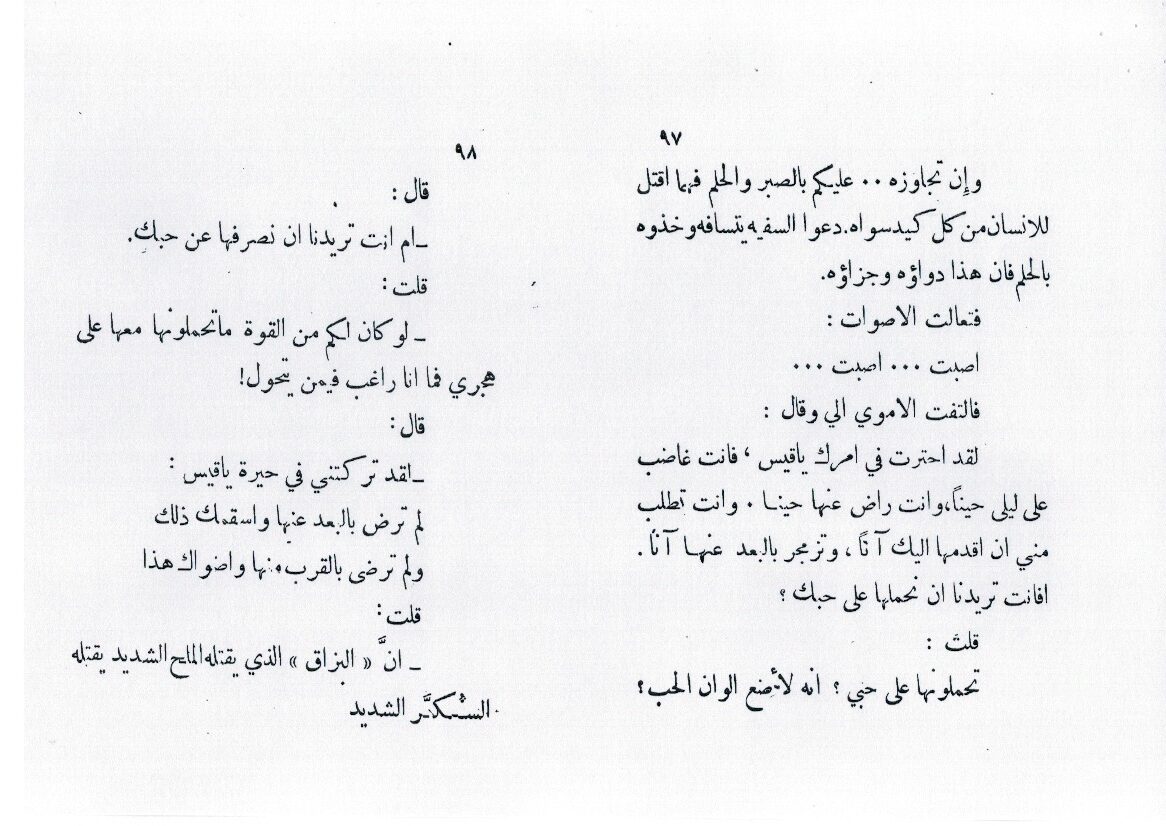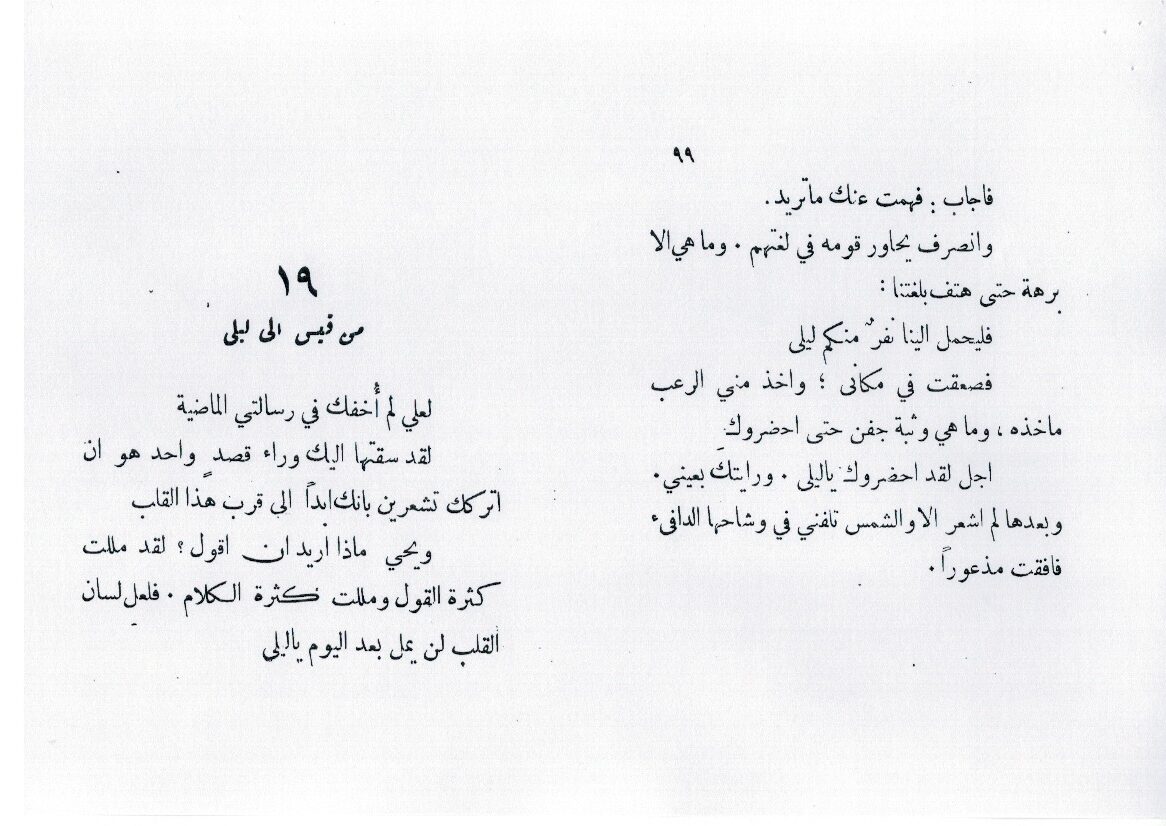الفضيلة العربيّة
المؤلِّف: زهير ميرزا
الناشر : دار اليقظة
“وددتُ لو أنَّ فتياتِ الأرضِ جميعاً كُنَّ ليلى”
“ووددتُ لو أنَّ شبابَ الأرضِ جميعاً كانوا قيساً”
“إذنْ لبرئت الأرضُ من رِجْسِ الخطيئة،”
“واستحمَّت الأنفُسُ في ماءِ الطُّهرِ والحياة !”
زهير ميرزا
الإهــداء
والديَّ الحبيبين “إبراهيم ميرزا” و”سلطانة الأيوبي”
وصديقيَّ الغاليين “ك.ع” و “ع.ح”
لشدَّ ما أشعر بالغبطة العميقة وأنا أقدِّم بين يديكم هذه الثَّمرات من الفِكْر الحيِّ!
ولشدَّ ما أشعر بالسَّعادة الغامرة وأنا أسوق إليكم حديث القلب إلى القلب، وحديث الرُّوح إلى الرُّوح!
إنَّ الحياة يا أصدقائي ملاوةٌ من زمن أرعن، وإنَّنا في هذه الحياة عابرو سبيلٍ خُلِقنا لنشتري ثمَّ نجري.
فإذا ما قُدِّر لكم أن تقرأوا عنّي ما كتبتُه اليوم؛ فحسبي بما قدَّمتُ أنَّني أذعتُ صدى أحاديث كلٍّ منكم إلى خدين روحه ونفسه.
وهل الأدب إلّا أصداء الحياة؟
زهير ميرزا
المقدمة
أن يمسح الإنسان بكفِّه الهائلة على جبهة الماضي ليُزيل بعضاً ممّا علق بها من غبار الزمن؛ وأن يسعى بين يدي الدهر، يراوغه ويداهنه حتى يستلب جزءاً يُقدِّمه لِما تأخَّر منه حتى ينتفع به الآخرون؛ هذا هو “العمل” وهذا هو “الشيء” الذي تقوم عليه أسس الأدب الفنّي!
والدَّهر حفنة من زمنٍ وذكرى! ليس له من أوّل؛ كما أنَّ ليس له من آخر، ماضيه كحاضره وحاضره كآتيه، لا يتميَّز بخطوط، ولا يستقرُّ بنبرة، يُعيد من ذكرياته ما يحلو له وما لا يحلو، جبّارٌ عاتٍ، طاغٍ عنيد، إن لم تفد منه أفاد منك وتركك نسياً مَنسياً. والعاقل مَنْ سعى بين يديه، فاستبقه حيناً، وتأخَّر عنه أحياناً، وراوغه وداهنه حتى يحيك من أجزائه المبعثرة وحدةً كاملةً يقدِّمها في زمنٍ غير زمنها، لأنَّها وجدتْ في غير أوانها، فمن حقِّها أن تستقرَّ تحت شمس معيَّنةٍ، وفي وقتٍ مُعيَّنٍ حتى تُقدَّر لها الحياة!
إنَّ حكاية “الفضيلة العربيّة” حكايةٌ ما استطاع أن يؤطِّرها زمنٌ بعينه؛ ولا استطاع أن يحيط بها سورٌ من أسوار العصور التاريخية، فنحن لسنا بقادرين على الادِّعاء بأنَّ “الفضيلة العربيّة” قائمةٌ في العصر الجاهليّ مثلاً فحسب! أو في العصر الجاهلي المهذَّب (1)، أو في أيِّ عصرٍ بعينه قطّ، وإنَّما هي سلسلة حوادث نفسية خُلِقتْ يوم أن وجد في الكون “عرب”، ويوم تمخَّضت الصَّحراء فولدتْ “عربيّاً”.
فإنْ سألتَ السَّمَوأل عن الفضيلة العربيّة لم تعدم لديه جواباً! أو سألتَ حاتم طيء، أو سألتَ قسَّ بن ساعدةَ الإياديّ أو سألت الخلفاء الراشدين أو سألت قيساً وليلى أو سألت أمراء المؤمنين أو سألت المعتصم أو سألت صلاح الدين، فأنت أبداً لن تعدم جواباً يردُّ على كلِّ سفيهٍ يحاول بخس الناس أشياءهم!!
في دَورٍ من أدوار الجاهليّة المُهذَّبة تمخَّضت الصَّحراء فولدتْ إنساناً بعينه وإنسانة بعينها …
ترعرعا حتى استقام شبابهما على الفنن الغضِّ! إذا بهما تولد وولادتَهما عاطفةٌ تترعرع معهما!
لقد كان حبّاً جنونياًّ جارفاً طاغياً، اكتسح كلَّ التقاليد وحاول أن يقوم بثورةٍ تترك الحبَّ سلطاناً فوق السَّلاطين وجبّاراً فوق الجبابرة! ولكن هذه الثورة – واأسفاه – قُمِعتْ ولمّا تنشب، فحِيلَ بين الحبيب وحبيبه، وحِيلَ بين الحبيب وحيِّ حبيبه، بل وحِيل بين الحبيب والحياة، أو كاد!
نعم لقد قُمعتْ هذه الثورة، وقام السُّلطان يحلِّل دم الحبيب إن طرق حيَّ حبيبه! ولعلَّ السُّلطان لم يدرِ – أيّده الله – أنَّه إنَّما قتل الحبيب تمثيلاً وقت نفاه من مجالي حيِّ حبيبه! بل إنَّ دم الحبيب أُريق!
لقد تعدَّدتْ أسباب إراقة الدّم: فمن بعضها الحرمان القلبيّ، وإخماد أوار ما شبَّ من العاطفة، وإنَّه لأفظع ألوان القتل!
قام في نفس الحبيب أنَّ المنيَّة موافيته إنْ نأى وإنْ اقترب، فاختار أعذب الأمرين على مرارتهما، فزار حبيبه وسط حالكٍ من خيوط الليل، ووقف يحدوه أملٌ طاغ ٍ جارف، وتقلقله من مكانه رعشةٌ أخذتْ بتلابيبه في ذلك الموقف الرهيب:
إنْ فاجأه أعداؤه؟!
واصفارَّ وجهه الحبيب ولكنَّه تجالد ورفع من صوته:
ليلى!
خرجت المسكينة ترتعد فَرَقاً وخوفاً. وأُغلِقتْ في وجهها كلُّ الأبواب، إلّا باب المحبة الطاغية فأخذتْ به من يمينه وساقته إلى خبائها!
يا للتضحية الرائعة!
وأخذا بطرف حديثٍ عشيق!
فجأة إذا بالحيّ يتدجَّج بالسِّلاح ويسير إلى خباء ليلى! ورفع أحدهم من صوته:
ليلى!
مادت الأرض بالعذراء! ولكنَّها لم تمِدْ تحت قدمي الحبيب المفتان! وعاد الصوت يرتفع:
ليلى!
فمادت الأرض بالحبيب ولكنَّها لم تمِدْ تحت قدمي ليلى فخرجت. وأقنعتهم ألّا أحد في الخباء! ولكنَّهم أبوا إلّا أن يتحقَّقوا من ذلك بنفسهم!
أجل! لقد دخلوا وخرجوا كما دخل قيسٌ وخرج، ما رأوا أحداً، ولا رأى شيئاً؟! (2)
هذه هي الفضيلة العربية! وهذا كلُّ ما في الأمر؛ فسلوا الشَّرق والغرب، والشّمال والجنوب، هل أتوا بإنسانين كهذين؟!
إنَّ ابتكار الفضيلة وإلصاقها بإنسانٍ خياليٍّ هو من أسهل الأمور! ولكن إيجاد الفضيلة في إنسانٍ حيٍّ هو من أعقد الأمور وأصعبها.
سلوا “بول وفرجيني” أين وجدا، وأيُّ زمنٍ هو الذي أحدَّهما بحدوده؟
وسلوا “روميو وجوليت” في أيِّ عصرٍ قام حبُّهما؟
إنَّ هذه المجموعة الشهيرة من المُحبّين لم تقم إلّا في رؤوس مؤلِّفيهم فقط!
أمّا قيسٌ وليلى فقد قاما في رأسين اثنين هما رأسا قيسٍ وليلى.
ومَنْ كقيسٍ وليلى في الوجود كلِّه؟
……
إنَّ حكاية “الفضيلة العربية” حكايةٌ استلبتْها كفٌّ ككفِّ الصّائغ الجوهار. فمن أحشاء الماضي تبيَّنتُ شبح حادثٍ جللٍ له قيمته في بعث ما خمد من أوار النخوة العربيّة والنعرة اليعربيّة. ونسي التاريخ أو تناسى ذلك الحادث، وتراكم الغبار فوق أجزاء تلك المأساة المروِّعة، فتراكم اثر ذلك الغبار فوق أجزاء عقول العرب، فنسوا أو تناسوا.
ومَنْ كالتاريخ ينسى ويُنسي حيناً، ويتناسى ويقهر على التناسي أحياناً؟
وهي – الفضيلة العربية – بعد هذا صفحةٌ من “ملفِّ” حياة هذين الإنسانين العميقين “قيس وليلى” أقدِّمُها اليوم في صفحاتٍ معدوداتٍ عليَّ أعود إليها ثانيةً بأكثر ممّا جئتُ بها هذه المرَّة، فما كلُّ صادٍ ترويه قطرة، وما كلُّ جائعٍ تكفيه كسرة.
والله من وراء القصد.
زهير ميرزا
دمشق 22-10-1944
لقدْ أحببتُ ليلى قبلَ أنْ يُحبَّها قيس!
بلْ لعلّي أحببتُ ليلى بعدَ أنْ أحبَّها قيس!
وقدْ أكونُ أحببتُها قبلَ أنْ يُحبَّها وبعدَ أنْ أحبَّها؟
والأصحُّ أنَّني لمْ أُحببْ ليلى “قيسٍ”، ولكنَّني أحببتُ ليلى”نفسي”.
* * * * * * *
1
من قيس إلى ليلى
أصحيحٌ أنَّني خلَّفتُ البارحة في قلبك شيئاً من القلق المضطرب؟ أحقٌّ أنَّني تركتكِ البارحة للّارجعة وقوَّضتُ صرْحَ حُلمٍ ناعمٍ اضطرب به جناني واختلج له شعوري وخفق به قلبي خُفوقاً مرحاً وَثُوبا، كأنَّما هو نعمةٌ من نعَمٍ حلوةٍ مُحبَّبة أتت في زمنٍ مُلائم؟
أحقٌّ كلُّ ذلك يا ليلى؟
خذي بيميني، وترفَّقي بي، وأجيبي بلهجتك الوادعة الرطبة إجابةً فيها من دلِّ النساء شيءٌ كثير، وفيها من المَكْرِ المُحبَّب شيءٌ كثير، وفيها من محاولة تلافي ما حدث شيءٌ كثير. فليس أحبُّ إلى قلب الرجل من كلمةٍ رفيقةٍ تُساق إليه ساعة قلقه، فتُعيد إليه شيئاً من ثقته بنفسه وشيئاً من اطمئنانه ودعته.
ليلى! حسْبيَ أنَّني اندفعت البارحة اندفاعاً مشوباً، وحسبيَ يا ليلى جزاءً أنَّني آلمتك. فإنَّ ما يمكن أن تحاسبيني عليه، سبقك إليه ضميري وقلبي وحاسباني حساباً لم يكن يوماً بأشدّ منه عليَّ اليوم.
لعلَّكِ لم تحملي في نفسك شيئاً يا ليلى!
2
من قيس إلى ليلى
ما بالك البارحة أجبتِ على كتابي إليك إجابةً صامتةً بليغةً؟ وما بالكِ تركتِ الرَّسول يعود عودةً صامتةً حزينةً، لم أفهم منها سوى أنَّ ذاك النَّهار الذي مضى ما إن يعود، وذاك الجرح الذي ألمَّ بك ما إن يندمل ولن يندمل؟
لقد دار في خلَدي أنَّك ستكونين أسرع لمكان لقائنا منّي، وإذا بالشمس تغفو على ساعدي، ويمتدُّ جنح الليل الرَّهيب على كتف الوجود؛ وتتناثر في السماء ثريّات شاحبةٌ كامدة؛ ولمّا تأتي.
إنَّ من القلوب ما يريق من ألمها خطرةٌ من خطرات النفس، وهاجسٌ من هواجس الفكر. فبحسبِ المحبِّ أنْ تمسح الذكرى بكفِّها على جبهته حتى يدع الماضي وآلامه والعتاب وأشجانه ليعود إنساناً جديداً يشعر بتلك الشّعلة اللّاهبة تمرُّ فوق أحزانه فتطهّرها وتتركها رماداً نقيّاً إلّا من الصَّفاء والمحبَّة النّاعمة.
ما بالنا نقيم من التّوافه حواجزَ ما إن تتمزَّق أسسها، ومن الخلافات المتواضعة جدراناً صفيقةً ما إن يتقوَّض بناؤها؟
إنَّ الحياة العاطفية ملاوةٌ من زمنٍ أرعنَ، إنْ لم نستقم لها لا تستقيم لنا، وإنْ لم نأخذها طَوراً باللّين وقت تقسو، وتأخذنا بالقسوة وقت نلينُ، كنّا كمَنْ سعى لحتفه بظلفه، أو كمَنْ يبعث الشرَّ وهو نائم.
إنْ كان لمّا يزل في نفسكِ شيءٌ من ألمٍ كبيت، فإنَّ ما بنفسي لأشدُّ وأقوى. ولكنَّ الحبَّ مسح بكفه السّحرية، وضرب بعصاه النورانيّة ضرباً رفيقاً وزَّع به شمل الأسى، فتصدَّعت جموعه، وترك للعاطفة والحنان سبيلاً ليستقرَّا في وَكْنِهما، ويعملا عملهما الوداع ويبعثا الطمأنينة ويشيعانها في النفس.
3
من قيس إلى ليلى
مهما تصاممتِ يا ليلى، ومهما أغرقتِ في التّصامم، فإنَّني من تلك الفئة القليلة من الناس التي ترى أنَّ الخير كامنٌ في كلِّ نفسٍ، يظهر بمقدار ما في كلِّ نفسٍ من تواضعٍ ورأفةٍ ومحبَّة.
إنَّ المحبَّة قلب الله يا ليلى، وكلُّنا يسعى إنْ بالفكر أو بالقلب أو بالعمل الصّامت؛ لأنْ ينال زاويةً متواضعةً من زوايا ذلك القلب العظيم؛ فلمَ لا تحاولين كلَّما أحاول عسانا نبلغ مجتمعين ما لا نكاد نناله متفرّقين؟
هل تعتقدين أن الله يأبى علينا تقاربنا واندفاعنا في المحبة المقدسة؟
إنَّ الحبَّ أوّل ما كمن كمن في قلب الله ثم وزَّعه على عباده بالتساوي، فأظهر كلٌّ بمقدار استعداده أن يكون إنساناً أو حيواناً. إنَّنا مخلوقاتٌ يا ليلى؛ لبس من خالقنا أجزاء ضئيلة من صفاته الكريمة؛ وإذا ما أخطأنا وحدنا عن جادة الصَّواب؛ كنّا كذلك الذي يرى في المدنيَّة خمرةً وغادة، ولا يرى فيها علماً وعملاً. فالمدنيّة يربض في أحشائها الخير – وما جاء القرآن إلّا مُهذِّباً ومُمهداً لطريق المدنية – ولكنَّنا أخطأنا فهمها وانتزعنا من مجموع خيراتها المبدأ القائل بأنَّ كلَّ شيءٍ ممنوعٌ مرغوب فانغمسنا في ملذَّاتٍ مبتذلةٍ كريهة، وطاش صوابُنا، فأصاب فيما أصاب أخلاقنا فانثنتْ عن جادة الحق وغرقت في حمأة الخطيئة!
لِمَ ير أبوكِ وأهلوكِ في الحبِّ رِجْساً ودنَساً؟ إنَّ الله تعالى يرى الحياة محبّة وسلاماً. وإنَّ الله تعالى لمّا أوحى إلى أنبيائه وأصفيائه برسالاته كانت قوام الرسالات المحبَّة والسَّلام. فَلِمَ يتذرَّع أهلوك بالمحبة ويجعلونها واسطة التفرقة وهي أسُّ الوجود؟
إنَّ قلبكِ غِرٌّ يا ليلى، وإنَّك لطفلة، وإنَّ أهليكِ لمخطئون؛ فعسى أن يُبدِّل الله ما بنفوسهم علَّنا نعود إنسانين يحقِّقان أعزَّ آمال الله!
4
من قيس إلى ليلى
عجباً للمرأة لا ترى في المنطق سبيلاً إلى حسم النّزاع؟ وعجباً للمرأة لا ترى إلّا رأيها، ولا تعتدُّ إلّا به، ولا تسير إلّا بهديه؟
أفأكتب إليكِ مرّاتٍ ومرّات وتُعرِضين عمّا أكتب، وتجعلين في أذنيك وقْراً إذا جئتُ مُتحدِّثاً؟
أهمْ أهلوكِ يا ليلى؟ … أم هو قلبكِ؟ أم هو عقلكِ وتفكيركِ؟
إن كان أهلوك بريئي التفكير؛ وسامرُك غضَّه وقلبكِ يفتقد الثقة، فلمَ مددتِ لي بحبل المحبة حتى تركتني أرى فيك ما رأيتُ؛ وأسلمك أمر قلبي ما سلَّمتُ، وأترك لقلمي العنان ليكتب أولاً وثانياً وثالثاً؟
إنَّ الحبَّ يعتمد الثقة، وأنتِ مُفتقدةٌ إليها، فسلامٌ على ما مضى يا ليلى.
5 من ليلى إلى قيس
حسبُك يا قيس حسبُك! فإنَّ ما بنفسك جزءٌ ممّا بنفسي، ولكنَّ الزمن لم يخفِّف من حدَّة طباعك ولن يخفِّف.
أوأنتَ معتقدٌ أنَّ الحياة هي خصامٌ يوماً يعقبه وئامٌ يوماً؟
أم أنتَ تعتقد أنَّني بين يديك ألعوبةٌ هزيلةٌ ترضى عنها وقت تشاء؛ وتغضب وقت تشاء وأنت مطمئن إلى أنك تعيدها إلى الحظيرة متى أردت؟
لقد أبى للشباب الثائر في نفسك أن يستقرَّ ويهدأ؛ وقد آنى لطيشكَ أن يقف عند حدّ. ففي كلِّ يومٍ بيني وبينك عتابٌ ما يستقيم سببه. وفي كلِّ يومٍ بينك وبين الناس قصيدٌ ما ينتهي لجْبُه. أولستَ بمدرك قيمة كوني عذراء؟
ما الذي أثار حفيظتكَ الأمس حتى تركتَ في جوانحي جرحاً دامياً؟ وما الذي أثار حفيظتك الأمس حتى ركنتَ إلى قلمك تعتذر به عمّا فرط منك؟ أما كان جديراً بك لو احتفظت بما أثارك ووزعته على أجزاء جسدك جزءاً جزءاً حتى تتلاشى معالمه وتتضاءل فاعليته فتأمن لنفسك السقوط والانزلاق، وتحفظ ماء وجهك من أن تريقه بين الأسطر معتذراً تائباً؟
لم لا تفكرون أنتم الشباب بما آل أليه اندفاعكم وراء العاطفة الجموح، فتتركون للغيرة سبيلاً تتسرَّب منه إلى أغاوير أنفسكم وتستقرُّ هناك لتندفع آراؤكم بعد ذلك من رؤوس نخرةٍ أكل من أساسها سوسٌ نتنٌ هو سوس الغيرة والشهوة؟
لقد كان أحرى بنا نحن النساء أن نندفع ونخطئ ونعزف عم جادة الصواب، وأن تكونوا المرشدين المفضلين لأمثالنا لا أن نكون مرشديكم وأنتم الأدنون.
إن الأمر لا يستهدف إلا قليلاً من التؤدة والتفكير وإعمال الرَّويّة وبعدها تجدون أنكم الأعلون!
دعِ الاندفاع جانباً يا قيس، وخذْ بسبيل نفسك علَّها تَرْشدُ بعد غيٍّ، واعلم أنَّ في قلبي متَّسعٌ لألوان العواطف متباينةً إلّا لون اللجاجة والغيرة فإني منهما لنفورةٌ، وعن طلابهما لعازفةٌ، ولو كانت منهم نفسي!
6
من ليلى إلى قيس
عفوك إنْ فرَّطتُ في الحديث البارحة وأغرقتُ، إلّا أنَّني أعتقد تمام الاعتقاد أنَّ التوجيه الصحيح لا يكون إلّا عن طريق امرأة؛ وامرأةٍ صالحة.
7
بكَّر الصَّباح في الصَّحراء، وانسكبت مياه النُّور الأشعث على الرّمال الندية الرطبة؛ والتمع منها ما التمع وبقي الآخر غارقاً في نشوةٍ ناعمةٍ يأبى أن يستفيق، ولو داعبت خدَّيه قطراتُ الشُّعاع المنعشة، والتفَّتْ حزمٌ ضوئيةٌ رشيقةٌ بخيامٍ مضروبةٍ هنا وهناك، وحاولتْ جهدها التغلغل إلى أغوار تلك الخيام علَّها تُداعب ساقاً جميلةً انزلق عنها غطاءٌ خشنٌ؛ أو تُقبِّلُ وجنةً حلوةً ورديّة قبل أن تستيقظ تلك اللعوب فتأبى تلك الحزمة الضوئية الخبيثة أن تُقبِّل إلّا خِلسةً؛ لأنَّ استراق اللذائذ لذَّة أكثر عُمقاً وعذوبةً من تلك المفضوحة. ولكنَّ الحزمة الخبيثة فتَّشتْ عبثاً بين الخيام؛ فقد استيقظ مَن استيقظ مدفوعاً بعامل الخجل الأول من أن ترى خيوط الشمس غفوة الحسناوات. وإنَّ بالنساء العربيّات لحياءً وادعاً يتركهنَّ يأبَينَ على أنفسهنَّ حتى اختلاس الأشعَّة النظر إلى عُريهنَّ، ومَنْ كالنّائم عارٍ وهو مكتسٍ؟
واستطاع خيطٌ مرِحٌ أن يُلامس وجه ليلى الهادئ، فأحسَّتْ به يتمرَّغ على وجهها الأملس البضِّ فما أبعدتْه ولا حاولت أن تُزيحه، بل تركته يتغلغل شيئاً فشيئاً من وجنتيها إلى نحرها العاجيّ إلى صدرها الرَّخص وهي مستغرقةٌ في إغفاءةٍ حلوة، وقد تركت للأطياف أن تحوم حول رأسها لترسم هناك وسماً لحلمٍ وادعٍ، ورشقتْ ذراعيها إلى الأعلى حيث استقرَّت كفّاها متشابكتين تحت رأسها تتغلغلان في الشَّعر الأسود الفاحم وتستقرّان هناك وقد انحسر الثوب عن الذراعين الرشيقين، فاندفعتْ خيوط الشمس تلتفُّ بهما التفاف النسيم بالشجر، فلطَّختهما بأصبغتها الورديّة المُحبَّبة .
فيمَ تفكِّرين يا ليلى وقد استيقظ من أهليك مَنْ استيقظ سعياً وراء القطيع – رمز الحياة -؟
أوَما يزالُ يتلاعب بجفنيك رسول قيسٍ ليثقلهما ويترككِ وإيّاه غارقين في لقاءٍ طيفيٍّ عميق؟
لقد صحا الفجر! وتنبَّه الغَلَس! وبكَّرتْ شمس الصَّحراء! وأنتِ ما تزالينَ غافية؟
وتمطَّتْ ليلى بكسلٍ، وأدارتْ عينين نفورين سوداوين، فرأتْ من الضُّحى انبساطه، ورأت الشمس وقد لفَّتها بثوبها الورديّ تُجفِّفُ ما علق بالجسد المرمريّ بعد اغتساله بأمواه الأشعَّة المُنعشة، فانتابها شعورُ خجلٍ وحياءٌ وتسارعتْ إلى جانبٍ من الخباء مغمور!
8
وقفتْ “هند” بباب خباء ليلى وفي يدها مغزلٌ صوفيٌّ صغير، كان يدور فينةً بعد فينةٍ دوراتٍ سريعةً معلقة؛ حتى يخفِّف من حدَّته التفافٌ مستحكمٌ من الخيط الصوفيّ العنيد، وتركتْ لنفسها أن تهتف:
ليلى ـ قيس ـ بِشرـ صحراء ـ قطيع ـ حب ـ رعاة ـ أمل ـ إخفاق ـ أهل ـ عذال ـ وشاية ـ غيرة …
غيرة؟
أجل هي الغيرة يا هند.
هي وحدها التي تركتكِ هنا قائمةً ترقبين. مَنْ تُراه ذلك الإنسان الذي ترتقبين قدومه؟ عفواً لعلي أردتُ أن أقول: مَنْ هي تلك الإنسانة التي ترتقبين خروجها إليك من الخِباء؟ أتُراني حقّاً رجعتُ إلى صواب الحقيقة؟
أهو قيـ …. عفواً. أهي ليلى التي تنتظرين؟ ـ إنْ يكن مَنْ تنتظرين قيـ … ـ أوّاه كم أخطئ: إنْ تكن من تنتظرين ليلى؛ فإنَّ ليلى ما يزال يعقد جفنيها طيف قيسٍ الجميل.
أجل يا هند.. هو قيسٌ، وهي ليلى، وكلاهما سار بحديثه زمانُه، وكلاهما يرى في الثاني نصفه الضائع.
قيس. هو نعمة الله التي أسبغها على ليلى.
ليلى. هي نعمة الله التي أسبغها على قيس.
حبَّذا لو كان لقلبكِ “قيسٌ” آخر يتولى تقليم أشواكه ليغدو قلباً كقلب “ليلى”.
أو حبَّذا لو كان لقلبك “قيس” بذاته عسى يقول فيك قصيداً تسير بذكره الرُّكبان.
إنْ كان في الجمال. فأنت أنعم منظراً من … ليلى.
وإنْ كان في الكمال؛ فإنَّ اسمكِ بعدُ لم يُلطَّخ بقصيدٍ عن مثل ليلة “الغَيل”….
وإنْ كان في الحسَب والنَّسب؛ فإنَّ لك فيهما جاهاً كبيراً.
ففيمَ أحبَّ قيسٌ “ليلى” ولم يُحببكِ أنتِ؟!
إنَّ في نفسي الآن أنَّه يحبُّكِ ولا يُحبُّها…
ماذا؟
ألا تصدِّقين!!
سَلي إذنْ ليلى عن آخر رسالةٍ تلقَّتها من “قيس” حتى تعلمي مقدار ما يكنُّه لها من كراهية؛ تراها ليلى ـ لغباوتها ـ حبّاً وحناناً….
لا تتركي الفرصة المعسولة تفلت من بين أصابعك، إنَّ ما بين قيسٍ وليلى كمثل ما بين شبابك ومشيبك، فتقدَّمي.
هيّا تقدَّمي.
وتقدَّمت.
9
تقدَّمتْ (هند) بخطواتٍ مسحورةً؛ وكان المغزل الصغير ما يزال يدور دوراته السريعة القلقة بين أصابعها المُرتجفة؛ ولكنْ لم يعد هناك صوفٌ يُغزَل، وإنَّما هناك تفكيرٌ قلقٌ مضطربٌ يدور بدوران المغزل المُرجحنِّ لئلا يستقرَّ؛ بين تذبذُبٍ يترك ما التفَّ من الصُّوف يعود ليتخلَّص باضطرابٍ أيضاً من ذلك الالتفاف البغيض؛ فكأنَّ المغزل لم يدُرْ، وكأنَّ هنداً لم تغزل.
ورفعتْ “هند” من صوتها تُنادي: ليلى!… ليلى! …
ولكنَّ الأثير أنكر أنَّه حمل مثل هذه الاهتزازات على أجنحته لينقلها إلى ليلى!
لقد انفكَّ صوت “هند” من لسانها انفكاكاً ما تعدَّى فكَّيها، وخرج الصوت كالحشرجة المكتومة فما سمعته حتى أذناها!
ووقفت تنتظر عبثاً أن تجيب ليلى النداء.
واضطربت هندٌ ظهراً لبطنٍ؛ وراودتها خواطر خبيثةٌ شيطانيّة؛ وراحت تُسائل نفسها:
فيمَ لم تُجبْ ليلى؟ أتُراها قد أدركتْ ما يجول بخاطري فعزفتْ عنّي وهي العربيّة الأصل والطّبع والتفكير؟
ولكن: لا! فليلى صديقتي الودود، وليس من السهولة أنْ تتجاوز الصداقة بمثل هذه اللّمحة العابرة ـ وهي ما جرَّبتْ عليَّ شيئاً قطُّ ـ لتفكّر بأنّي أضمر لها….
أضمر لها …
وماذا تُراني أضمر؟…
واهتزَّت أصابعها برجفاتٍ سريعةٍ تركت المغزل ينفلتُ من بين تلك الأصابع ليتدحرج على الرّمال قليلاً ويستقرَّ من هندٍ غير بعيد!
نظرتْ هندٌ إلى المغزل حيناً وإلى خيط الصوف الذي مازال بين أصابعها حيناً آخر ودخلتْ في تفكيرٍ عميق.
ودمدمتْ من أعماقها:
لقد أبى هذا المغزل أن ينفكَّ نهائيّاً عني، فترك – وقد ذهب – خيطاً من الصوف غزلتُه وإيّاه ليكون واسطة ارتباطٍ بيني وبينه!
أفأبى الإنسان إلّا أن يقطع جميع خيوط الارتباط التي تربطه والناس؟
10
كان البكور ما يزال بكوراً عند ما وقفتْ هند ذلك الموقف. وكان البكور ما يزال بكوراً أيضاً عندما كانت ليلى ما تزال في جانبٍ من الخباء مغمور؛ وما هي إلّا أن خرجت ليلى من خبائها بذلك الوجه الورديّ الصَّبيح، وتلك القامة الفارعة، يحجب الجسد الأملد عن العين الفضوليّة جلبابٌ مهفهفٌ من فاخر المُحاك، زركشته أيدٍ صناع، وقد تركت ليلى لخصلاتٍ مرحةٍ أن تنزلق فوق جبهتها الليثية لتكون موضع عبثها إنْ خلا القلب من عملٍ جديٍّ، حتى أبصرتْ بصديقتها هند وقد وقفت غير بعيدٍ من خبائها.
فانطلق ذلك الصوت الهادئ بجرْسٍ موسيقيٍّ عذب:
ـ عِمي صباحاً يا هند
– عِمي صباحاً يا ليلى
– ما بالُ مغزلك قد انفلتَ من بين أصابعك واستقرَّ غير بعيدٍ منك؟ أتُرى استغرقتِ في تفكيرٍ مُلِحٍّ حتى سهَوتِ عن كلِّ ما حولك فلم تلتفتي إلى انفلات المغزل؟
– كلّا يا ليلى! وإنَّما أنا رميتُه حُنقاً وغيظاً!
– أتُراه قد أتى بما أثار حفيظتك عليه؟
وضحكت ليلى ضحكةً فضيّةً مرحة، واقتربت بجلبابها الفضفاض من هند وهي تُغرِّد:
لقد كنتِ وما تزالين يا هند تلك الحسناء الطَّلقة الوجه والعذبة الصَّباح! إنَّ أعزَّ أمنيةٍ عندي أن ألقاك أوّل ما ألقى وقت أنطلق من فراشي باكراً!
إنَّ صباحك صباحٌ مرحٌ مضحاكٌ يا هند، وكأنَّك وقد خلا قلبك إلّا من الصَّفاء والهناءة تحاولين أن تضفي على ما حولك ذلك الجوَّ الذي تعيشين فيه، فهنيئاً لك وهنيئاً لذلك الإنسان الذي سيأخذك بين ذراعيه غداً؛ إنَّه لن يلقى فيك إلّا أنثى محبَّة مخلصة، لا تعرف من الحياة إلّا وجهها الضَّاحك الباشّ.
فقالت هند مقاطعة بحياء: ولكن يا ليلى؟… فامتدَّت يد ليلى المُقدَّسة لتداعب الوجه الحزين وتمتمت: لمَ لا يا هند! أنتِ خليَّة القلب ناعمة البال، دعي “لكن” هذه، فما أفاد منها مَنْ سبقكِ حتى تفيدي أنت منها! اتركي الشّكوك تأخذ سبيلها إلى قلب مَنْ يحبُّها؛ واغرقي في نعيمٍ من الطُّمأنينة الوادعة فخير ما في الوجود الاطمئنان!
إنَّ “لكن” وحدها هي سبيل الشكّ! ومتى انفرجتْ أمام أعين المرء سبُل الشكِّ كان كمثل الذي أُغرِقَ في أنوارٍ سطّاعةٍ لمّاعة! هي أنوارٌ ولكنَّها لا تُريه شيئاً. ولو كان في الظُّلمة لتلمَّس طريقه وتحسَّسه بأناةٍ وهدوء! ولكنَّه في النور الغامر! في النور الخادع الذي هو أشدُّ من الظُّلمة في تعمية الأمور.
ليس في الكون بصيص نورٍ مطلقاً! وإنَّما هناك فقط نور!
وليس في الدنيا قليلٌ من الظُّلمة يا هند! بل هناك فقط ظلمة.
وليس هناك مرتفعاتٌ قليلة حيناً! ومنخفضاتٌ سهلة أحياناً يا هند، بل هناك انحدارٌ مستقيمٌ يعقبه سهلٌ مستقيمٌ ممتدٌّ! هذه هي الحياة، فلمَ نندفع نحو النُّور المُظلم، ولمَ نسلك الانحدار المستقيم ولو كان يجثم في نهايته ما يجثم؟ إنَّ تلمُّس طريق النور أفضل من الانغمار فيه. كوني كما عهدتك إنسانةً وادعةً تجتوي كلَّ “لكن” لتعيش في نعيم الواقع المحبب.
لقد اندفعت وغرقت في حمأة الـ “لكن”، أفتدرين ماذا حلَّ بي يا هند؟
تعالي يا صديقتي تعالي؛ فإنني أطمئنُّ إليك أكثر مما أطمئنُّ إلى أيِّ إنسانٍ ثانٍ!
تعالي لأقصّ عليك حديث الشكِّ، لأنَّ الحبَّ شكٌّ! والشكُّ نورٌ، والحبُّ نور!
ولكنَّه نورٌ أشدُّ ظلمةً من الظلام!
11
تمكَّنت الشمس من الحيّ، واحتاطته إحاطةً مُغرقة، وتمكَّن الضُّحى من الكون، فلم يعد في الحيّ الخبائيّ إلّا وحداتٌ متفرِّقة من الفتيات المرحات اللائي جلسن في مُقدِّمة أخبيتهنَّ، هذه بسبيل إتلاف ثوبٍ لإصلاح ثانٍ، وتلك بسبيل غزلها، والأُخرى ما تنفكُّ تُصلح من شأن ابنها، وهو يأبى إلّا أن يكون صاحب الرأي الأول!
وكأنهنَّ شعرن بشيءٍ غير عاديٍّ يطرأ على الحيّ الذي لم يغرق في مثل هذه السكينة مطلقاً!
بالأمس كان الناس في غدوٍّ ورواح، هذا من يثرب، وذاك من الشام وهؤلاء من اليمن، وقيسٌ … أجل أين قيس؟
ما باله تخلَّف منذ ليالٍ وأيام فلم يطرق الحيّ؟ وأسرَّتْ فتاةٌ ممراحٌ إلى جارتها:
لعلَّ بينه وبين ليلى كما بين المشيب والشباب؟ فانطلق لسان الثانية:
إنَّ ليلى غِرَّةٌ غرِّيرة، ما تعرف قيمة الحبِّ، آه لو كان لي قيسُها لذبتُ فيه غراماً.
فأجابت الثانية وهي بسبيل الأخذ بطرف حديثٍ طويل: إنْ كانت ليلى غِرَّةً فلمَ يكون هو غِرّاً أيضاً؟ لمَ لا يدعها وشأنها بعد أن أنكرتْه؟ أولمْ تسمعي بحديث الرسائل التي يتبادلانها؟ إنَّ الرَّسول بينهما هو….
فقطعت عليها الأخرى سبيل حديثها وقالت:
إن يكن قيسٌ غِرّاً، أو تكن ليلى غِرَّةً فنحن الثنتين غِرَّتان أكثر منهما وإلّا لما دخلنا في حديثٍ لا ينفعنا، قولي: كم احتلبتِ اليوم من ماشيتك؟
فأجابتها الثرثارة:
بل إنَّ في نفسك شيئاً لقيسٍ حتى تحاولي أن تُغمطي الحديث حقَّه خشية افتضاح أمرك، إنَّني أعلم أكثر ممّا…
12
الغروب في الصَّحراء بديعٌ وبليغ، كأنَّما الرمل تلك الذراع الرَّحبة الحنون التي تتوسَّدها الشمس الحائلة اللون لترتدَّ في الصَّباح زاهية!
حدِّثْ عن تلك الرّمال ما شئتَ الحديث! وأطلْ الوصف ما شاء لك قلمك المفتن، فبعد هذا تجد معي يا صديقي أنَّ في الصَّحراء الممتدَّة مدى النظر، وفي الرِّمال المبعثرة مدى النظر، وفي الأشعَّة الذّائبة المندفعة مدى النظر، وفي الخيام القائمة التي يلطِّخها الشُّعاع الشَّاحب مدى النظر، إن في كلِّ ذلك لأشياء غابتْ على مَنْ قبلك فلم يتمكَّن منها، ولن يتمكَّن.
كذلك أنت!
الغروب في الصَّحراء بديعٌ وبليغ!
أسندت ليلى ظهرها إلى خبائها لتستقبل الغروب، وقد استقرَّت خلف ذلك الظهر ذراعان نصف عريانتين، وتركت لصدرها الناهد أن يندفع إلى أمام قليلاً ليدُلَّ على بعض ما في نفس العربية من شموخ! ووقفتْ إلى جانبها صديقتها هند، وعلى مبعدةٍ انتظم سلك السَّامر بعد أن عاد القطيع واستلقى غير بعيد؛ يُذيب أتعابه في أمِّه الأرض، وأوقد من النار ما أُوقد، وخبا منها ما خبا، وغفا ما على الأرض شيئاً فشيئاً، واستوتْ أنجمٌ فضوليّةٌ قلقة تبعث بنورها الشَّاحب مُغرية أو طامحة إلى أنَّ مَنْ كان أوَّله صغيراً سيمتدُّ مع الزمن ليصبح كبيراً.
وانفضَّ سامرُ ليلى، وانفضَّ سامرُ الحيِّ، وانفضَّ سامرُ الصَّحراء، وما زال سامرٌ واحدٌ لم ينفضّ بعد…
هو سامرُ قلب ليلى!
واستغرقت ليلى في صمتٍ عميق، وذهبتْ بخيالها كلَّ مذهب، وضاع بريق عينيها بين بريق الأنجم، ولم يعد هناك إلّا قطعة من ظلامٍ واحدٍ جلبب الصحراء بثوبٍ قاتمٍ أسود، فما يتميَّز من الخيام شيء!
وقام في نفس ليلى أن تندفع إلى خبائها تسغرق هناك في فراشها الدافئ؛ ولكنَّ هاجساً هجس بنفسها أن لا؛ فهنا مدى التفكير أوسع، وهنا مدى الانطلاق من قيود الحقيقة أوفى.
ولكنْ، ممَّ تخافين يا ليلى؟ أمن شبحٍ عابرٍ؟ وأنت الرابضة الجَنان، أم من وحشٍ ضارٍ؟ إنَّ أذؤب الإنس أكثر ضراوةً من أذؤب الوحش، فما خفتِ الوحوش حتى تخافي الأناسيّ!
وحاولت جهدها اختراق حجُب الظَّلام بنظرةٍ من الحديد، فما أفلحتْ.. ولن تُفلح.
وسمعت إلى جانبها همساً قادماً من قريب:
ـ عجبي لقيسٍ يندفع عن هذه الغالية اللعوب، ويتركها فريسةَ خشيةِ الفِرار من قبضتها؟ وعجبي لهذه الفئة من الفتيات اللواتي يرين في أنفسهنَّ أبداً متعةً طيبةً للرِّجال.
أوَما وجدت المرأة في جميع مرافق حياتها سبيلاً للأمل إلّا عن طريق الرجل؟
أفقدِّر للمرأة أن تسعى وراء زوج لها من يوم تولد؟
إنَّ الفتاة العربية رجلٌ صغير، أو صورةٌ مصغرةٌ لرجل؛ فنحن نستطيع أن ندفع الأعادي ونحمى ذمارنا؛ ونحن نستطيع أن نكون في صدر مجالس الأدب؛ بل إنَّ صدر المجالس ما تحتلُّه إلّا النساء الرّاقيات. سليني هل في الرجال مَنْ يُضاهي الخنساء وقت وقفت على ذكرى أخيها “صخر”؟
بل سليني هل كان في الرِّجال أمثال “هندٍ” ربَّة الجواب البديهيّ؟
إنَّ ليلى فتاةٌ لا أكثر ولا أدنى من ذلك أبداً؛ عاشت كما عاش من قبلها من النساء، ما إن انطرحت على الأرض وقت ولادتها، حتى انصرفت تفتّش جاهدةً عن إنسانٍ يحتويها بين ذراعيه.
فأجابت الثانية بصوتٍ خافتٍ تعرفه ليلى تماماً:
– إنَّ ليلى ومَنْ شاكلَ ليلى لا يعيش إلّا بقليلٍ من الكبرياء المُصطنَعة والدلال المُستغرق، ولو كان فيها شيءٌ من النفس العربيّة لأقلعت عن حبِّ مَنْ شهَّر بها وتركها مُضغةً في الأفواه.
أنت لا تزالين تذكرين ليلة “الغَيل” وإنَّا أيضاً (ص 62) لها لذاكرون؛ ولكنَّ النفس الوضيعة التي تتقمَّص جسد ليلى تركتْها وأهلها قطعة لحمٍ نيّئةٍ تلوكها شدق عجوزٍ شحيح.
فانصرفت الثانية تحاول وتحاور:
– أنا لستُ من رأيكِ فيما ذهبتِ إليه، فإنّي وإنْ قلتُ في ليلى أنَّها ككلِّ النساء تفتّش عن إنسانٍ يحتويها بين ذراعيه إلّا أنَّني لن أستطيع أبداً أن أقول إنَّها وضيعة المنبت بحيث ترضى أن تلوكها الألسن الرَّعناء وإنَّ فيها من النفس العربيّة ما ليس في كثيرٍ من مثيلاتها؛ فإن كنّا نعتمد حوادث معيّنةً لنشهِّر بها عن هذه الطريق؛ فإنَّنا لا ننكر أنَّ النفس العربيّة الحقيقيّة هي التي تكمن في ذلك الصَّدر النّاهد.
وإنَّ الإخلاص الذي هو الشيمة الأولى للفتيات العربيات قد استحكم من نفس ليلى استحكاماً لم يتمكَّن من إنسانةٍ ثانيةٍ.
– إنَّ الإغراق في القديح كالإغراق في المديح؛ أنتِ أنا؛ وأنا أنتِ؛ وإنَّ غيري وغيرك لَمثلي ومثلك، ولو صحَّ لك ما صحَّ لليلى لكنتِ التمستِ لنفسك ألف عذرٍ وعذر لكي تدفعي عنك كلَّ تهمةٍ إنْ أغرقتِ في الحبّ؛ فإن كانت ليلى قد دافعتْ جهد طاقتها عن عِرضها، وصانت بقدر إمكانيّاتها سمعة أبيها، فإنَّك ما كنت لتهتمّين بذلك أبداً، بل كنت تتركين مَنْ يشاء، يغرق في أيّ وحلٍ شاء، دون أن تأخذك به رأفة أو يردعك عن ذلك رادع.
فانطلقت الثانية تقول:
ـ إنَّ مثل هذا الدفاع الذي تقفين به إلى جانب ليلى لا يدفع ما قد أزمع الحيّ وأهله على القيام به ضدَّ قيس!
فكأنَّما الثانية قد ارتعدت وهي تتساءل:
ـ وَيحَكِ، وما الذي قرَّر الحيُّ وسكَّانه؟
فأتمَّت الأولى:
ـ لقد قام في أنفسهم أن يدفعوا عدوان قيسٍ الخلقيّ بأيّة وسيلةٍ كانت، فهم اليوم مُنذِروه، وهم غداً واقفون معه أمام السلطان، وهم بعد غدٍ لقاتلون.
13
ارتجفت ليلى ارتجافةً كاملةً، وأخذ قلبها يخفق خفوقاً متتابعاً ومضطرباً، وتعالى زفيرها وشهيقها وهي تستمع إلى هذا الحوار الجارح، وكلَّما ازدادت اضطراباً، كان الليل يزداد هدوءاً؛ كأنَّما يخفي في طيّاته أمراً ليس باليسير!
وَيحَ الليالي؛ كلَّما أغرقتْ في السكون؛ كان في مطاويها يكمن أشدُّ الأمور تنغيصاً!
ليلى!.. ليلى!…
صوتان مختلفان اندفعا إلى أذني ليلى وهي في مكانها الجامد ذاك!
صوتان حبيبان إنْ تفرَّقا؛ كريهان إنْ اجتمعا! صوتان: في أحدهما يكمن حبٌّ جنونيٌّ مستقلٌّ؛ وفي ثانيهما يكمن حبٌّ جنونيٌّ مستقلٌّ!
أمّا إذا اجتمعا؛ فهناك الكراهية المجتمعة وهناك الحقد المتأجّج!
ما أعذبك أيها الصوت الأول وما أجرس رنَّتك ووقعك! إنَّك لتبعث في نفسي أحلاماً بعيدةً ناعمة؛ تتركني ألتمس الدفء في أحضانها الرّفيقة!
وما أعذبك أيها الصوت الثاني؛ وما أكمل رنَّتك ووقعك! إنَّك لتبعث في نفسي شعوراً دافقاً من المحبة الواعية العميقة! واضطربت ظهراً لبطنٍ ساعة استقرَّ النداءان في أذنيها. وكان ما زال الاضطراب مالكاً عليها حواسَّها بعد ذلك الحديث المثير الذي قام في ذلك السّامر البعيد منذ لحظات؛ والذي ما يزال يُردِّدُ صداه أفقُ الصَّحراء الممتدِّ! والتفتتْ يمنةً ويسرة، إذا بها تجد عن يمنيها قيساً؛ وتجد عن يسارها أباها.
14
أطبق الصمت وتكلَّم، فترك في كلِّ أذُنٍ دويّاً مُستديماً … طويلاً، وتناهى إلى قلب كلٍّ من الواقفين صوتٌ نفسانيٌّ مستقلٌّ يحاول أن يحدِّد الموقف وما هو بمُستطيع؛ فكأنَّما هو جملة أصداءٍ واضحةٍ اضطربت معالم وضوحها ساعة اشتبكت ببعضها وأصبحت كأزيز النَّحل المهوِّم فوق آثار سكَّرٍ سائلٍ. وأشفق الليل من هذا الموقف المُتناقض.
فليلى قلقة على وحيد قلبها أن تناله شفاه المهديّ بكلمةٍ جارحةٍ وهو الرقيق الشعور والحساسية.
وقيسٌ قلقٌ من موقفه تجاه عمِّه الذي كان يعلم ـ أي قيس ـ أنَّ عمَّه ما يضمر له في نفسه أيّ حقدٍ أو كراهية؛ ولكنَّها العادات والتقاليد المُمسكة بخناق المهديّ تشلُّ من تفكيره المتحرِّر.
والمهديّ، ذلك الشيخ الوقور، قلقٌ لأنَّه ما كان ليتصوَّر أنَّ قيساً يُعاود الكرَّة ويزوره وقت لم يبقَ في الحيّ مَنْ لم يتحدَّث بقصيدته التي قالها في ليلة “الغَيل” يشهِّر فيها بليلى.
صمتَ الجميع، والتاثَ عليهم القول؛ وغرق كلٌّ في تفكيرٍ مشوَّشٍ قلقٍ؛ ما يتحدَّد بنبرةٍ ولا يتميَّز باتجاه.
هتف قيس: عمّاه!
فاندفع المهديّ صاخباً: لا.. لا يا قيس! لا تنادني بيا عمّاه؛ فما أنا عمُّك ولا أنتَ ابن أخي.
فتضرَّع قيسٌ: ولكن فيمَ اندفاعك يا عماه؟ هل سمعتَ ما قاله الواشون؟ إنَّ الواشين …
فقاطعه المهديّ بإشارةٍ وقورةٍ من يده الناضجة: صَهٍ يا قيس صَهٍ، فما كان لك أن تُدافع عن نفسك بعد أن قلتَ ما قلتَ.
فتدخَّلتْ ليلى تدخُّلاً رفيقاً:
فما هي إلى جانب قيسٍ لأنَّه مُذنبٌ ذو جريرة، ولكنَّ شافعه أنَّه قريب القلب والرُّوح؛ وليست إلى جانب أبيها لأنَّه مغرِضٌ في حنقه على قيس؛ وإن كان إغراضه في سبيل الاحتفاظ بالكرامة العربيّة؛ أو بسُمعته التي نالها بالوراثة عن آباء آبائه نقيّةً صافيةً كالماء النَّمير ما تشوبه شائبة.
قالت ـ وهي ترى أن الموقف يفتقد التدبُّرـ : أبي دعْ قيساً فإنَّ لي معه شأناً آخر؛ واستمع إلى ما يريد أن يقول؛ فإنَّ ما تريد أن تقوله بلهجتك القاسية نوعاً؛ أقوله أنا بلهجة وادعة؛ إنَّ للقلب حقّاً يا أبي؛ وإنَّ للقرابة حقّاً؛ وما كلُّ الأمور يؤخذ بالحزم ولا كلُّ الأمور يؤخذ باللّين، فلكلِّ مقامٍ مقال.
فهتف المهديُّ ببرود:
وماذا يريد ابنُ أخي قيس؟
فأجاب قيسٌ بهدوء:
أريد ما أركن إليه وقت أشعر بالحاجة إلى صديقٍ يقيني غائلة الدّهر!
أريد ذلك الذي هو رمز الحياة الخالدة!
أريد تلك الشُّعلة اللّاهبة التي ينبثق من خلال توهُّجها الكون!
هي حقّاً شعلةٌ محرِقةٌ يا عمّاه، ولكنْ فيها من الخير للعالم ما لا يستطيع العالم بدونها أن يستقيم على فنن الوجود! و”الوجود” بمعناه الكامل!
إنَّ كلَّ خالدٍ مُحرِقٌ ومُعذِّبٌ يا عمّاه!
وأنا أريد هذا المُحرِق!
قال المهديّ وقد زوى ما بين عينيه:
لم أفهم عنك ما تريد يا بُنيّ!
فتدخَّلتْ ليلى ثانيةً وقالتْ:
هو يريد “ناراً” يا أبي! ألا ترى أنَّ النار هي الرَّمز الخالد للحياة؛ إذْ هل يستطيع الإنسان أن يعيش دون نار؟ إنَّ حاجتنا للمُحرِق يا أبتاه لأشدُّ من حاجتنا إلى سواه! ولكنَّ المُحرِق الذي بين أيدينا اليوم، مُحرقٌ يبتدئ بنا وينتهي بنفسه!
فقال قيسٌ بحياء:
رعاكِ الله يا ابنة عمّي، فلقد قلتِ ما أريد أن أقوله حقّاً.
فتمهَّلت ليلى قبل أن أجابته:
عليك بالانتظار، فبعد قليلٍ يكون لك ما تريد. وانطلقتْ تُهيئ له قليلاً من الحطب المُشتعِل.
15
انفرد الرجلان المتحابّان المتنافران، ووقف كلُّ واحدٍ منهم إلى جانب نفسه موقف المُشفق من هذا الخصام اللامُجدي!
ـ أوَفي مبدأ الهزيع الثاني تطرق الحيَّ تطلب ناراً يا قيس؟
ـ أجل يا عمّاه فلقد أودى بالبقية الباقية من حطبنا شيمةٌ عربيةٌ أصيلة.
ـ أوَ تحمل من تلك الشيمة العربية شيئاً يا قيس؟
فكأنَّما زلزلت الأرض زلزالها ولمّا تُخرِج أثقالها بعد! ماذا؟ هذا هو المهديّ الذي يقول …. هذا القول؟
بلى إنَّ في نفسي تكمن تلك الشيمة العربيّة، ولا اتعدَّى ذلك فأقول أنا الذي انفردت بها وحدي من دون سائر شباب هذا الحيّ!
ولكن انتظر يا قيس انتظر، فإنَّ ما ستتفوَّه به أمام عمِّك يجب أن يناله النضج، حتى ينتهي إلى مسامعه رفيقاً مُفحما! إنَّ الشيوخ لتتمكَّن منهم الإجابة المنطقية أكثر ممّا يستحوذ عليهم الضجيج؛ بل إنَّ الضجيج ليزيد في حمقهم، وإنَّهم لحمقى.. ترفَّقْ ترفَّقْ، وصُغ هذه العبارة في ثوبٍ أكثر زركشةٍ من ذاك، ثم قدّمها في مكانها حتى تعذُب.
ـ إنَّ ما أحمله من تلك الشيمة العربية يتركني لا أحير جواباً أمام سؤالك يا عمّاه …
وكأنَّما أراد عمُّه أن يستفزَّه فما أقلع عن سخريته وتحدّيه قيساً حتى في قوله:
ـ لو كنتَ تحمل شيئاً لما ترككَ أيُّ سببٍ أن تحير جواباً.
عجباً لك يا عمّي، وعجباً لك يا قيس. وانطلقت الكلمات هادئة وادعة:
ـ ما الذي أثار حفيظتكَ حتى أراك ما تحاول إلّا جندلتي عن طريق الكلام الجارح؟ إنَّ في نفسي يا عمّاه أنَّك ناقمٌ عليَّ، وإنَّه ليقوم في خاطري أنَّهم أبعدوك عن حقيقة الحال، وأوهموك أنني إنَّما أشهِّر بابنة عمّي ليلى، لا يا عمّاه لا؛ فما أنا من جبلَّةٍ وضيعةٍ حتى أفتش عن مَطعنٍ في جسدي.
فقال الشيخ:
ـ و “الغَيل”؟ قلْ لي ما الذي كان ليلة الغَيل بين ليلى وبينك؟
ـ وحقِّك يا عمّاه لم يكن فيها إلّا ما يكون عادةً بين كلِّ جماعةٍ من الفتيان صادفوا في الرَّواح سِرباً من الفتيات، قلنا كثيراً ـ وهنَّ كثيرات ـ وقلنَ كثيراً … ثمَّ … ذهبنَ يمنةً وسرتُ يسرةً. سلْ نفسكَ أنتَ يا عمّاه: لو كنتَ في مكاني وصادفتَ ابنة عمِّك في صواحبها؛ أوَ كنتَ تتركها دون أن تحيّيها؟
فأجاب الشيخ الوقور:
ـ إنَّ في أطواء ذاتي تكمن الشيمة النقيّة الصافية وما اعتدتُ أن أرمي بشباكي بين النساء الضعيفات فاحمرَّ وجه قيس، ودخلتْ ليلى …
16
ـ ما بالُك يا أبي تسدُّ على قيسٍ كلَّ بابٍ يفتحه لتنطلق منه مخاوفك؟ بل ما بالُك لا ترى في قيسٍ ابن أخيك، وترى فيه أعدى أعدائك؟ لو كنتَ أمام خارجٍ من الخوارج ما كنتَ لتقسو بأكثر ممّا تقسو على قيس.
إنَّ بقيسٍ من شيَمك يا أبي ما لا تحسب أنَّها فيه؛ إنَّ قيساً جارٌ، وإنَّ قيساً في القرابة ابنُ عمٍّ، فإن تجاوزنا عن الأولى لم ولن نتجاوز عن الثانية!
أفيحوّل الغضب الدم إلى ماء؟
ما أرى يا أبي إلّا أنَّ الغضب استحوذ عليك حتى أصبحت تحاول أن تُعارك حتى ذباب وجهك!
لقد كان من حقِّك ـ وأنتَ عمُّه ـ أن تقف إلى جانبه لا أن تقف ضدَّه.
فاندفع المهديّ يهتف:
ولكنَّ الناس يا ليلى!
فاندفع صوتان حبيبان معاً يقولان:
ـ انفِ الناس من فكرك (3).
فتمهَّل الشيخ وهو يتركهما:
ـ لم يقم في نفسي أن أحارب قيساً، ولكنَّ قيساً على القرابة جارَ(3). وإنَّ قومك وعشيرتك الأدنين لن يتركوا الأمر يسير حسب أهوائي وأهوائك يا ليلى؛ إنَّ لهم رأياً، وإنَّ رأيهم لسميع. اتبعيني اتبعيني، فأنا لك من الناصحين!
17
من قيس إلى ليلى
لقد كان لليلة البارحة أثرٌ ما انفكَّ يُراودني حتى دفع النوم عن عيني وتركني أساهر ما تبقَّى من أضواء السماء!
لقد كان عتابك قاسياً يا ليلى! وكانت غضبتك قاسيةً أيضاً؛ أفبعدَ فراق أمدٍ غير قصير تلقينني بذلك التأنيب الجارح؟ أوَ عهدتِ فيَّ، كما عهد أبوك، خشونةً في الطبع وصفاقةً في الإحساس؟
لقد حسبتُ ساعة دافعتِ أمام أبيك عنّي ذلك الدفاع المجيد، أنَّك ستكونين أليَن جانباً فيما إذا انفردنا لبعضَينا، ولكن واأسفاه! ما كنتِ إلّا أقسى قلباً.
أفقُدِّر علينا أن نقطع أيام الحياة، تدفعنا ريح العتاب أنَّى اتّجهتْ؛ فنحن يوماً لا نملك الرسوَّ إلى شاطئ، ولا نملك لأنفسنا تسيير دفَّة حياتنا؟
لقد كان في حسباني أنَّنا سننتهي البارحة من كلِّ حديثٍ وكلِّ شجنٍ خالط النفس.
أنا أحبُّك يا ليلى. بلى! أنا أحبُّك يا ليلى؛ ولو حاولتُ أن أسوق إليك حبّي، لسقتُ إليك ريحاً جنوباً جنونيّةً تذَر كلَّ ما في الوجود هباء.
وإنَّ حبّي يستهدف الهوى، وإنّي إليه لواصل؛ ولكن بالله عليكِ ألا وتركتني أجد من ذراعك جناحاً يضمُّني إليه وقت يتكلَّم قلبي كلماته المتقطّعة الحزينة. إنّي لأذكرك كلَّ مساءٍ وصباح يا ليلى، فهل أنتِ ذاكرتي بمثل ذلك؟
ويحَ العشّاق المعاميد؛ فما ذاقوا إلّا على رواية الشعراء، وهم أقحط الناس لذَّةً وأبعدهم عن رشف رضاب الحياة من كفِّ الحبّ.
18
من قيس إلى ليلى
ما الذي أحاول أن أ بثَّكيه يا ليلى؟ وما الذي أسعى إليه؟
سأحاول أن أسوق إليك حديث الليلة الفائتة؛ فلقد كانت رهيبةً في كلِّ شيء، حتى في الشكل الذي أغفيتُ فيه …
غفوتُ إغفاءةً متواضعةً، واستلبتني استغراقةٌ من حقيقتي ورمتْ بي بين أوديةٍ وهضاب لا عهد لي بها.
أفتدرين مَنْ لقيتُ هناك يا ليلى؟ لقيتُ الجنَّ ـ وكم كنتُ أخشاهم ـ ولكنني وجدتُ فيهم ما لم أجده في الإنسان؛ لقيتُ أُولي العاطفة الناعمة؛ لقيتُ من يفهم عني.
أجل يا ليلى، إنَّ ما أسوقه إليك اليوم طريفٌ ومخيف، ولكنَّه على الأكثر … حلم.
أفقتُ ـ وأنا غافٍ ـ فإذا بي تمتدُّ أمام عيني سهولٌ وحزون، وتقوم الرمال هنا وهناك؛ وترتفع على الجبال حرابٌ مسنونة، دقَّتْ رؤوسها فأصبحت كالأشباح المُخيفة. وساقتني قدماي وسط هذا اللون المخيف من ألوان الوجود، إذا بي في وادٍ تؤطِّره جبالٌ مسنَّنة الرؤوس، شاهقةٌ ما شاءت لها عظمتها أن تتشاهق، وسوداء ما شاءت لها روعتها أن تسودَّ. وبينا أحدِّق في تلك المرتفعات أحاول أن أحدِّد من اندفاعها نحو السماء والانتهاء بها إلى نهاية، سمعتُ عن جانبي لغطاً وضحكاً مُخيفين مُرعبيَن.
لم أكن لأخشى شيئاً ـ وأنتِ تعلمين ذلك يا ليلى ـ ولكنَّ تلك الضحكات الخليعة حيناً والمرتفعة بشكلٍ مثيرٍ للضَّحك والرُّعب معاً تركتْ في نفسي شيئاً من الخشوع والوقار، فوقفتُ في مكاني ما أتحرَّك منه. وما هي إلّا بُرهةٌ حتى طرق سمعي لغطٌ أكثر تعقيداً من الأول؛ وكان من بينهم يتميَّز أحياناً صوتٌ أعرفه جدّ المعرفة وأدركه أتمَّ الإدراك، لأنَّه ذلك الهاجس الوادع الأمين الذي يهتف بي كلَّما ألمَّت بي نازلةٌ من نوازل الألم، أو طرقتني طارقةٌ من طوارق الزمن.
لقد كان صوت “الأمويّ”، أجل هو “الأمويّ” بذاته الذي حدَّثتكِ عنه؛ إنَّه لتأخذكِ الرَّعشة وأنت تستمعين إلى أحاديث الجنِّ؛ وأظنُّكِ ستتعوَّذين بالله خشية أن يتقمَّصوك! ولكن لا!… لا يا ليلى! إنَّهم أفضل من الإنسان! بل إنَّ الإنسان هو الجنيُّ ـ كما نفهم الجنَّ نحن ـ والجنّي هو الإنسان ـ كما نفهم الإنسان نحن أيضاً ـ!
إنَّ الشرَّ لينأى عن قلب “الأمويّ”، وإنَّ قلبه ذاك لينبض بالرَّأفة لي والحدب عليّ.
اقتربتُ بالإذن منهم قبل أن أتمكَّن من نقل قدميَّ المسمَّرتين في الأرض؛ واستبقتُ المسافة حتى لا تفوتني كلمةٌ ممّا كانوا به يتهاتفون! ولكن عبثاً كنتُ أحاول ذلك! لقد كانوا “الشياطين” وكنتُ “الإنسيّ”!
وبعد لأيٍ، انتزعتُ قدميَّ المسكينتين واقتربتُ منهم أظهر عليهم، وما إن ظهرتُ عليهم حتى احتاطوني احتياط السِّوار بالرُّسغ، وأقبلوا عليَّ مُتسائلين قلقين، كأنَّما تقوم بيني وبينهم أواصر صداقةٍ زمنيّة. ولعلَّهم لو كانوا إنساً لأنكروني ولتعدَّوا ذلك فرجموني.
وقفتُ في ذلك الحشد المتواضع وقفةً قلقةً مضطربةً؛ فما آمنُ لهم وإن أظهروا الودَّ، وما يضمرون غيره، وبقيتُ محاذراً جانبهم، وكأنَّهم أخذوا عليَّ ذلك فيما بينهم، فحاذاني “الأمويُّ” وهمس:
ـ من أين يا قيس!
فقلتُ غير واعٍ:
ـ من وطني الأول والأخير؛ من أُمّي المخلصة؛ من مسكني اللامتناهي، من الأرض الطيّبة، من الصَّحراء.
فكانت قهقهاتٌ وكان صياح!
وتساءل خبيثٌ منهم:
ـ كيف خلَّفتَ أمّك ووطنك ومسكنك؟
فأجبتُ بتعمُّقٍ:
ـ لقد خلَّفتهما كما خلَّفاني؛ ولدتني أمّي الأرض بريئاً، فما تلقاني إلّا بريئاً وما ألقاها إلّا كذلك.
فقال قائلٌ: ـ ولكنَّ بني جنسك …
فقاطعته:
ـ إنَّ بني جنسي ولدتهم أمّهاتهم دنسين، فما تلقاهم ولا يلقونها إلّا دنسين مُثقلين بالخطيئة والعقوق.
فالتفت ” الأمويُّ” إليَّ وقد اعتراه شحوب:
ـ فيمَ انفجارُك يا قيس وتحاملُك؟
قلتُ بتؤدة:
ـ حبَّذا لو كان ذلك تحاملاً وانفجاراً، وددتُ لو في جبلَّتي ما يبيح لي أن أتحامل وأنفجر، إذن لصفعتُ منهم باللفظ مَنْ أصفع! وأحسبُني كنتْ أصفعهم جميعاً.
قال آخر:
ـ ما تقول في الجيل القادم؟ إنَّك لتحمل على أبناء هذا العصر، وما أنتَ بدارٍ حالَ مَنْ سَيَليكَ، ولكنْ لنا علم الظنِّ بأنَّ قومك من خيرة الأقوام؛ وأنَّ الأقوام التالية ستشتهي لو أن تكون من مثلهم!
فأجبت:
ـ إنَّ لكلِّ زمنٍ أنذاله ولئامه، وأنتَ على حقٍّ؛ فقد يكون في هذا الجيل مَنْ يستحقُّ الصَّفع، وقد تلي أجيالٌ كلُّها تستحقُّ ذلك.
قال قائل:
ـ وهمُّك ممَّنْ؟
ـ من أهلي وعشيرتي الأقربين.
قال “الأمويّ”:
ـ وليلى، أليست من أهلك وعشيرتك؟
ـ دعوني وليلى … فإنَّ ما بنا أكثر ممّا يؤطِّره حديثٌ عابرٌ.
قال “الأموي”:
ـ أَوَأنتَ مُنكِرٌ ليلى؟
قلتُ:
ـ معاذ الله أن أنكرها، ومعاذ الله ألّا أنكرها؛ لقد أضوتني وهي سليمة، وعذَّبتني وهي آمنةٌ مطمئنَّة، وإنَّ ما بنفسي من حبٍّ، هو في نفسها لا مبالاة؛ أحمل لها ما أحمل ولا تحمل لي إلّا حبَّ الجار لجاره والقريب لقريبه.
قال آخر:
ـ ويحك يا قيس ويحك.. لأنت تهرف كأنَّما أصابك مَسٌّ.
قلت:
ـ إن كان ذلك، فمنكم المصدر.
فاندفع آخر:
ـ إنَّه يحاول أن يمسَّ كرامتنا.
وقال آخر:
ـ بل يحاول شتمنا.
وقال آخر:
ـ سحقاً لكلِّ غِرٍّ مفتان، كنا نحمل لك أطيب العواطف وأصدقها، وكلُّنا يحبُّك ويحدب عليك، وما أنتَ إلّا إنسانٌ يأبى إلّا أن يتمرَّغ في وحل جنسه الخسيس.
وقال آخر:
ـ اطردوه، فما حلَّ بيننا مَنْ يؤذينا، ولو شئنا لآذيناك، ولكنْ اذهب حتى نبرهن لك أنَّنا أسمى من الإنسان ـ طينتك الوسخةـ.
فاندفع “الأمويُّ”:
ـ العزَّة للحلْم، ما بالكم اندفعتم وراء عواطفكم؟ إنْ كنتم تحاولون أن تبرهنوا على أنَّكم أسمى من الإنسان، فلمَ انخرطتم في أرذل طباعه وهو الحمق؟
قال قائل:
ـ ولكنَّه تجاوز الحدَّ!
فأجاب “الأمويُّ”:
وإنْ تجاوزه … عليكم بالصبر والحلْم فهما أقتل للإنسان من كلِّ كيدٍ سواه، دعوا السَّفيه يتسافه، وخذوه بالحلْم، فإنَّ هذا دواؤه وجزاؤه.
فتعالت الأصوات:
ـ أصبتَ…. أصبت…
فالتفت “الأمويُّ” إليَّ وقال:
ـ لقد احترتُ في أمركَ يا قيس، فأنتَ غاضبٌ على ليلى حيناً، وأنت راضٍ عنها حيناً، وأنت تطلب منّي أن أقدِّمها إليك آناً، وتزمجر بالبعد عنها آناً. أفأنتَ تريدنا أن نحملها على حبِّك؟
قلت:
ـ تحملونها على حبّي؟ إنَّه لأنصع ألوان الحبّ؟
قال:
ـ أم تريدنا أن نصرفها عن حبك.
قلت:
ـ لو كان لكم من القوّة ما تحملونها معها على هجري فما أنا راغبٌ فيمَنْ يتحوَّل!
قال:
ـ لقد تركتني في حيرةٍ يا قيس:
لم ترضَ بالبُعد عنها وأسقمك ذلك، ولم ترضَ بالقُرب منها وأضواك هذا.
قلت:
ـ إن “البزّاق” الذي يقتله الملح الشديد يقتله السُّكَّرِ الشديد.
فأجاب:
ـ فهمت عنك ما تريد.
وانصرف يحاور قومه في لغتهم. وما هي إلّا برهةٌ حتى هتف بلغتنا:
ـ فليحمل إلينا نفرٌ منكم ليلى.
فصُعقتُ في مكاني؛ وأخذ منّي الرُّعب مأخذه، وما هي وثبة جفنٍ حتى أحضروكِ.
أجلْ لقد أحضروك يا ليلى؛ ورأيتك بعيني، وبعدها لم أشعر إلّا والشمس تلفُّني في وشاحها الدافىء فأفقتُ مذعوراً.
19
من قيس الى ليلى
لعلّي لم أُخِفْكِ في رسالتي الماضية،
لقد سقتها إليك وراء قصدٍ واحدٍ هو أن أتركك تشعرين بأنَّك أبداً إلى قُرْب هذا القلب …
ويحي ماذا أريد أن أقول؟ لقد مللتُ كثرة القول، ومللتُ كثرة الكلام؛ فلعلَّ لسان القلب لن يملَّ بعد اليوم يا ليلى.
20
من هند إلى ليلى
سوف تأخذين عليَّ الكثير من الأمور وأنت تُطالعين رسالتي هذه إليك يا ليلى.
سوف تأخذين عليَّ انصرافي عنك أمداً ليس بالقريبِ حتى إذا ما جئتُ أكتب، جئتُ أسوق من الأخبار ما يؤلمك ويثير فيك الشَّجن.
أحقيقٌ أنَّ أبا قيسٍ جاء يطلب يدك ورفض أبوك قبول قيسٍ صهراً؟…
كيف ذلك يا ليلى كيف؟ أقيسٌ وعظمة مجده، وقيسٌ وعراقة أصله ومنبته، وقيسٌ وشرف محتده، وقيسٌ ورقّة إحساسه، وقيسٌ وعميق حبِّه وإخلاصه، وقيسٌ … وقيسٌ …هو الذي ترفضين طلبه، وتردِّين أباه على أعقابه ذليلاً كسير النفس والرُّوح، فقيد الكرامة؟
أوَ ما دار في خلَدكِ أنَّ طلب أبي قيسٍ يدك هو شرفٌ لك لن تحلمي بمثله أبداً؟
لقد كنتُ أولى عاذلاتك يا ليلى، وكنتُ أولى مشتهياتٍ قيساً ليكون لي، ولكني الآن بدل أن أقيم ممّا حدث ستاراً أُخفي خلفه أفراحي، فإني أقيم في نفسي الرّثاء لك ولأبيك، لأنكما لم تدركا حقيقة قيس.
لقد افتقد المسكين عقله أو كاد من حبِّك! ولكني ما أحسبه إلّا مجنوناً مُغرِقاً في الجنون؛ لا في حبك، ولكنْ لشروعه في هذا الحبّ الذي لم يتكافأ فيه الطرفان! فأين أنت يا ليلى من قيس! أين!
أوَ ما سمعتِ حديث الناس كيف أن قيساً انفلتَ من أمدٍ وتاه في الفيافي والبلاقع ضائع الاتجاه حتى أصبح يهذي هذياناً متواصلاً في أنَّه اجتمع إلى نفرٍ من الجنِّ يحادثونه عنك ويحادثهم…
لقد أكَّد أنه اجتمع إلى ذلك النَّفر من الشياطين وقال إنه رآهم رأي العين!
فهل تصدّقين أنه رأى ذلك؟
إنه افتقد عقله أو كاد يا ليلى!
21
من دعد إلى ليلى
لقد أشفقت أن أكتب إليك ولمّا يقم بيننا من الصداقة ما يسمح لي بالشروع في ذلك. ولكنَّ الذي دهاني ما تتناقله ألسنة السابلة من أنَّ أباك قد أبى أن يكون قيسٌ صهره!
لقد قام في نفسي أن أنصحك. ولكنْ عذراً ليلى؛ فما أنا بالقادرة على ذلك وفي نفسك ما فيها من الكبر والأنانية، فإلى أن يدور الزمن دورته، وإلى أن يسمح الدهر لي بالانفراد بك انفراداً روحيّاً كلياًّ عندها – يكون قد فات الأوان تماماً – أستطيع أن أقول ما أنتِ مُدركته تماماً الآن. وإلى اللقاء.
22
من عفراء إلى ليلى
إنَّ كثيراً من الأمور يجد المرء نفسه أمامها وجهاً لوجه فلا يستطيع لإغرائها دفعاً ولا لهجرها استطاعة.
ووجدتني البارحة أمام هذا الإغراء المتماسك والعنيد معاً وقت انفضَّ السَّامر ليخلِّف دويّاً متواصلاً: من أنَّ أباك صدَّ أبا قيس!
أأبوكِ؟..
أبوكِ يصدُّ أبا قيس؟
إنَّ من الناس مَنْ يهبهم الله النعمة الغامرة فيُعرِضون عنها وهم لا يستحقُّونها.
وإنَّ من الناس مَنْ يمنع الله عنهم النعمة المتواضعة فيُقبلون عليها وهم أهلوها!
جلَّ شأن الخالق!
إنَّ مَنْ ترككِ ترفضين قيساً بعلاً؛ هو الذي ترك قيساً يرضى بكِ لنفسه زوجاً!
23
من… ومن… ومن …. إلى ليلى