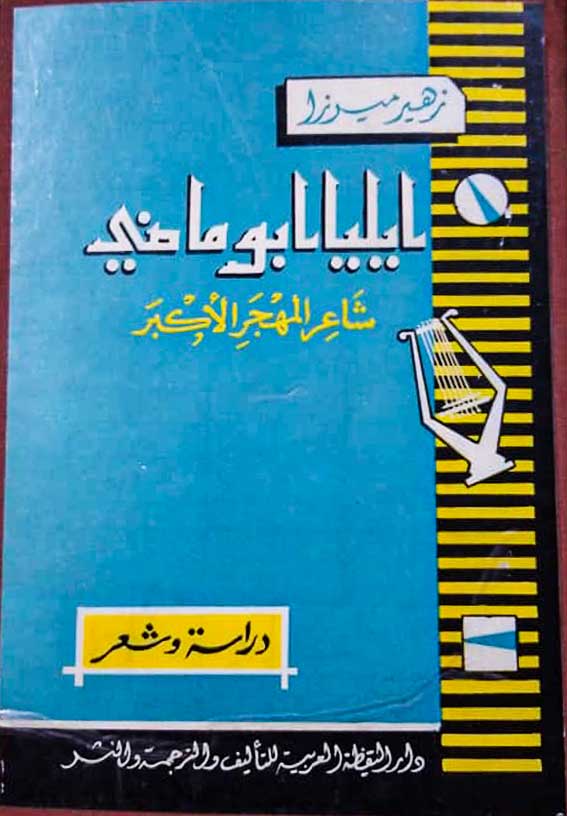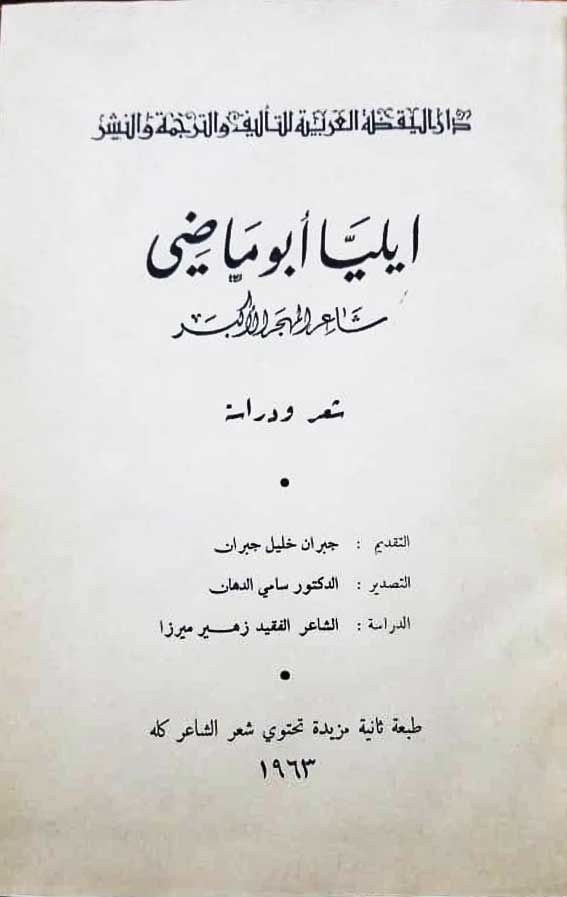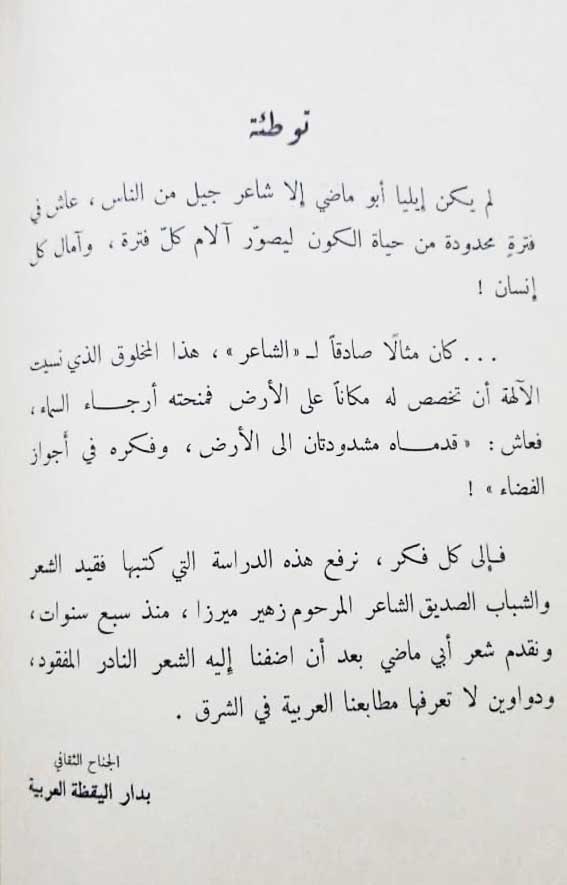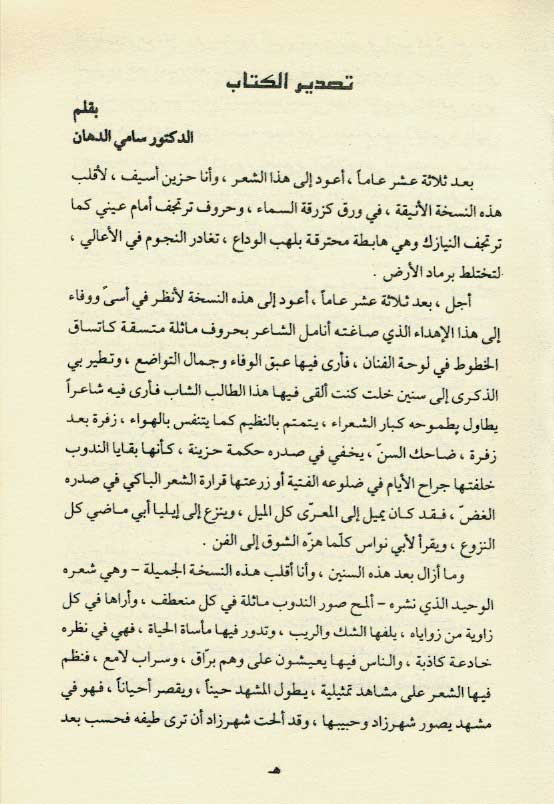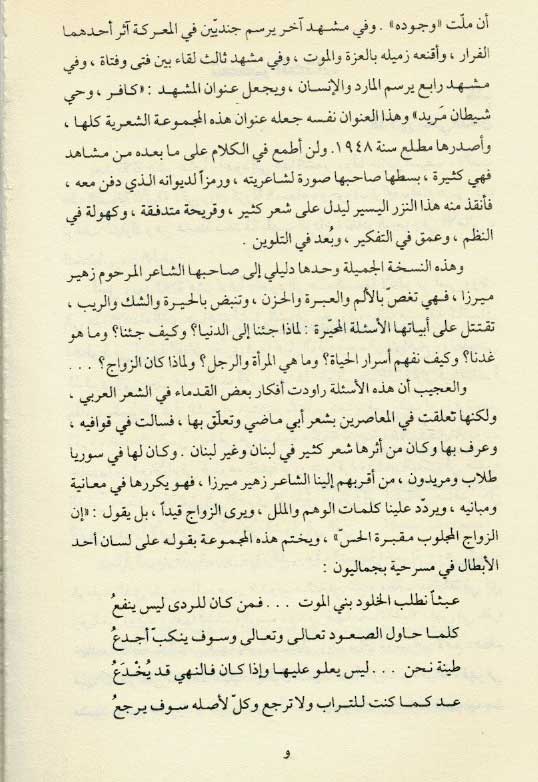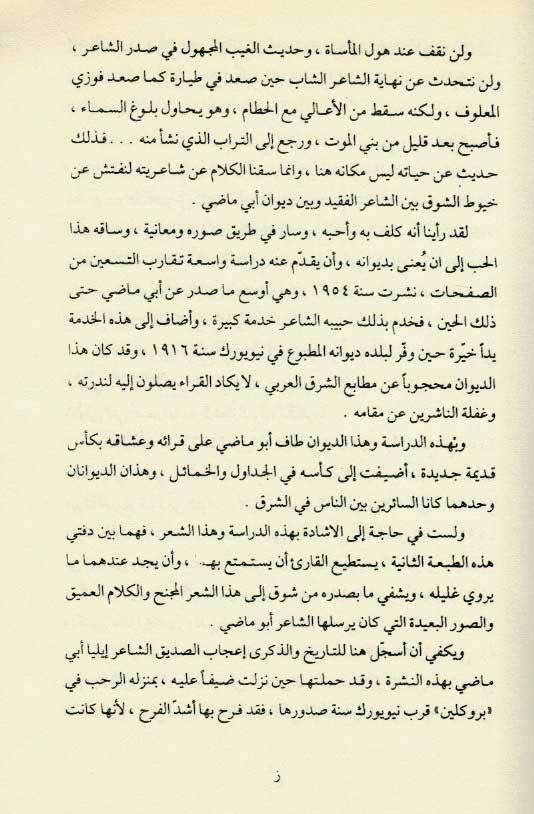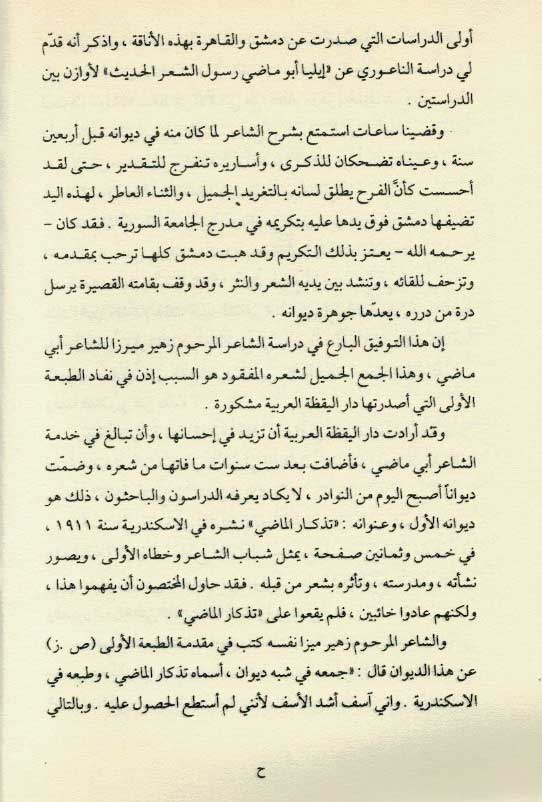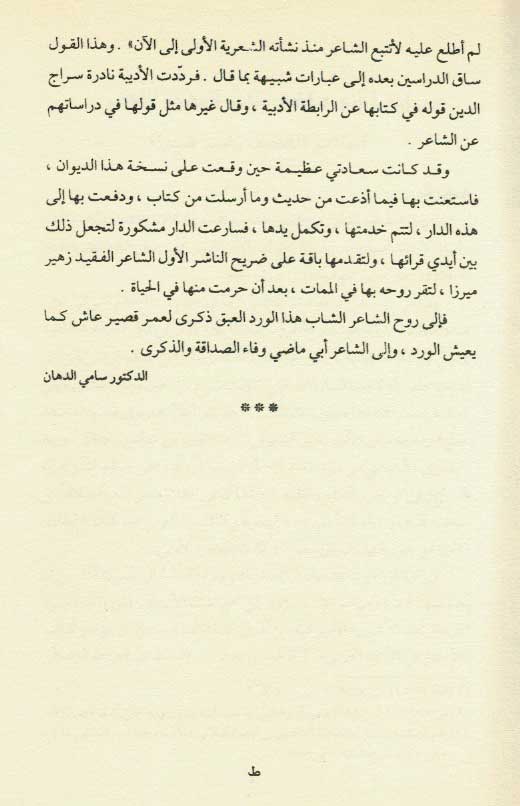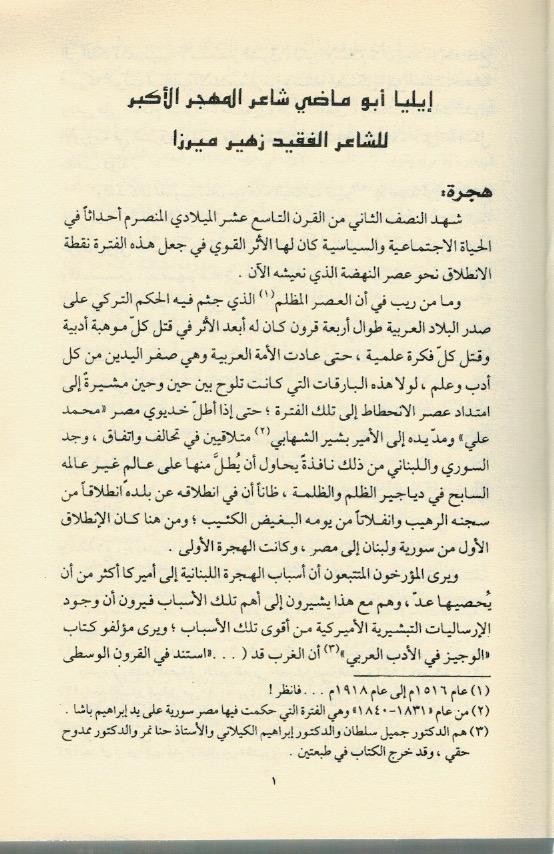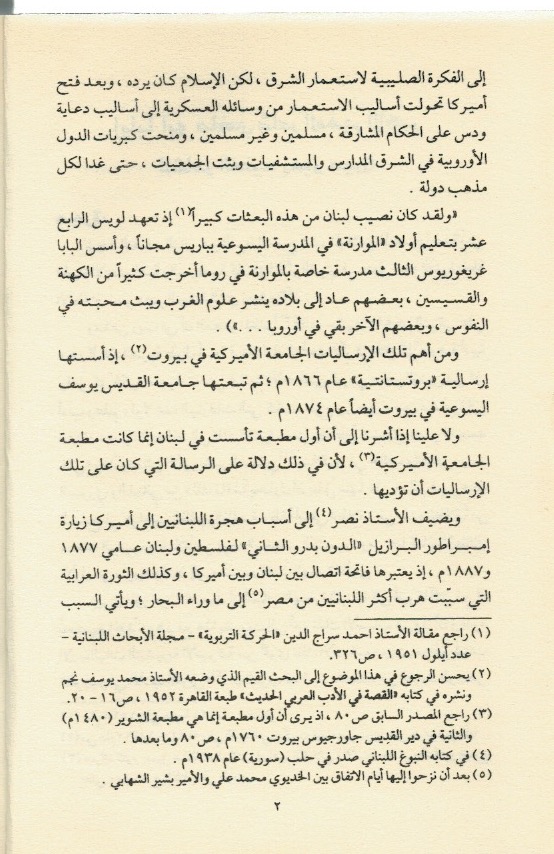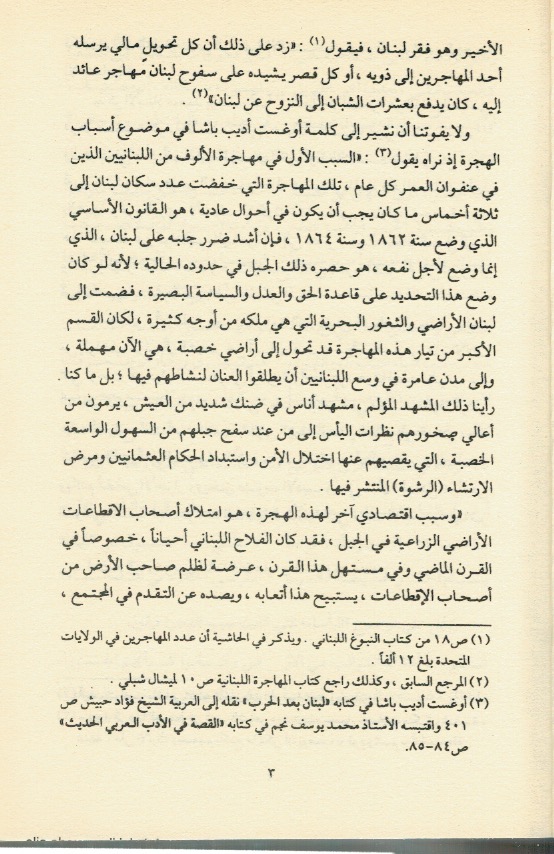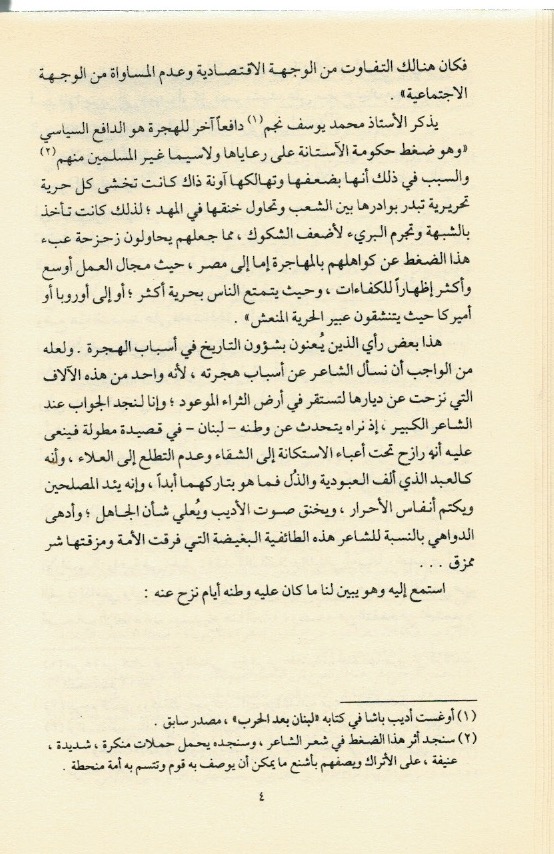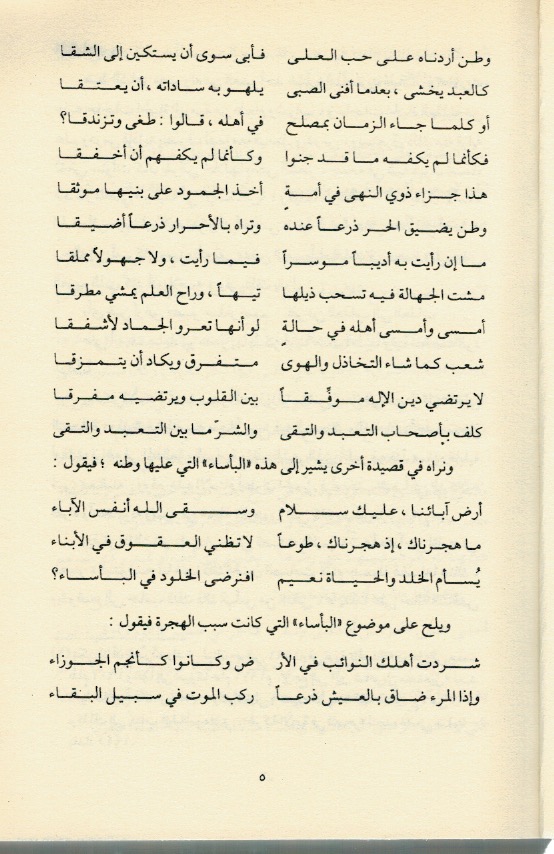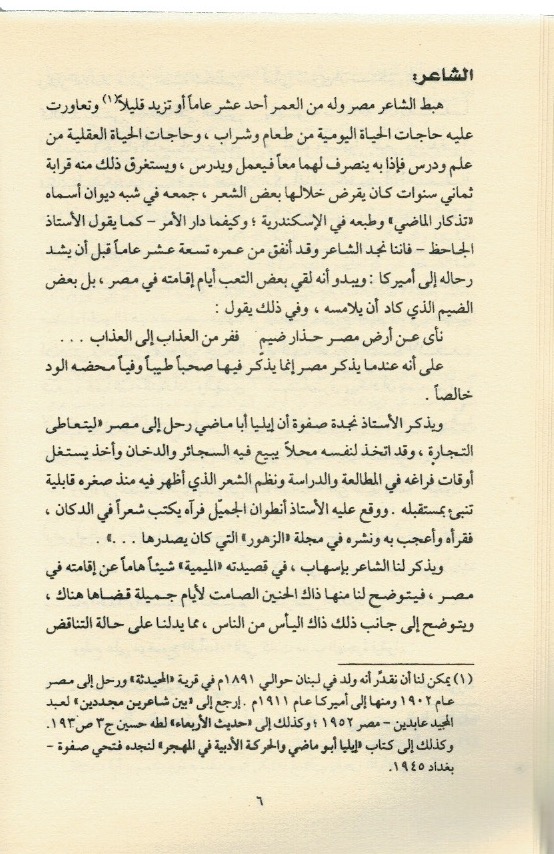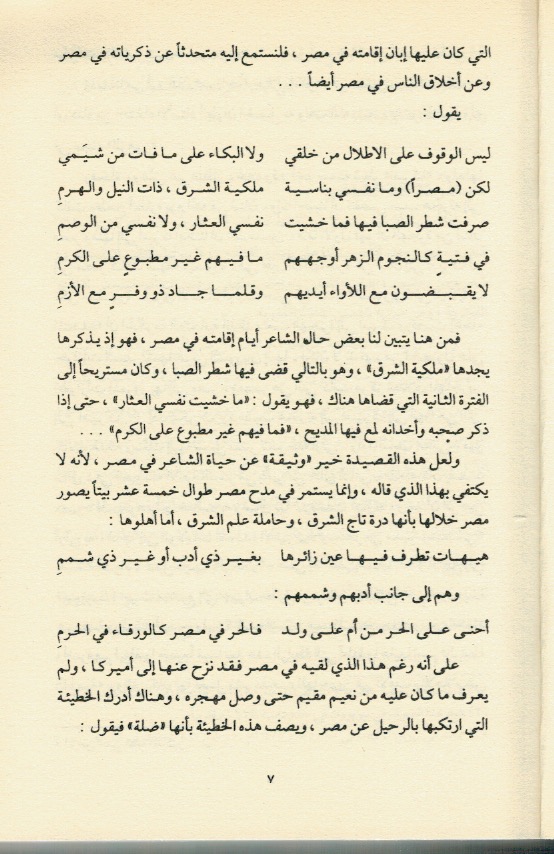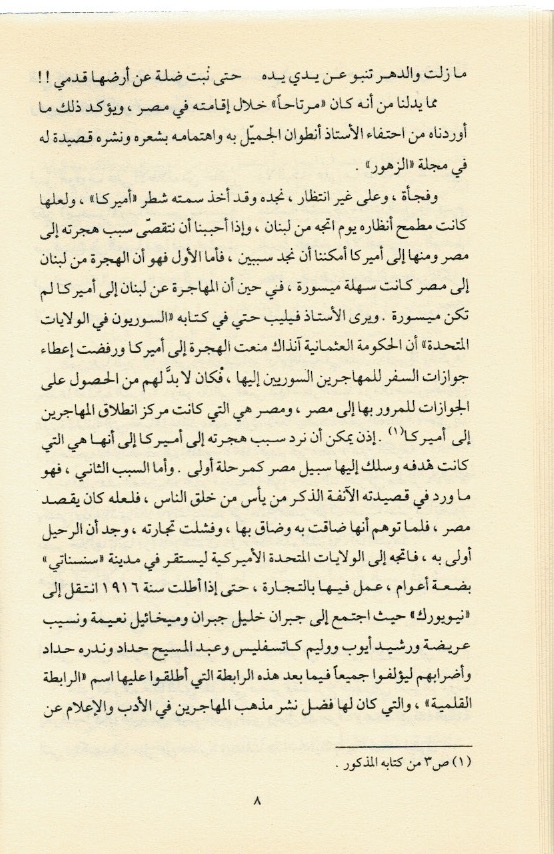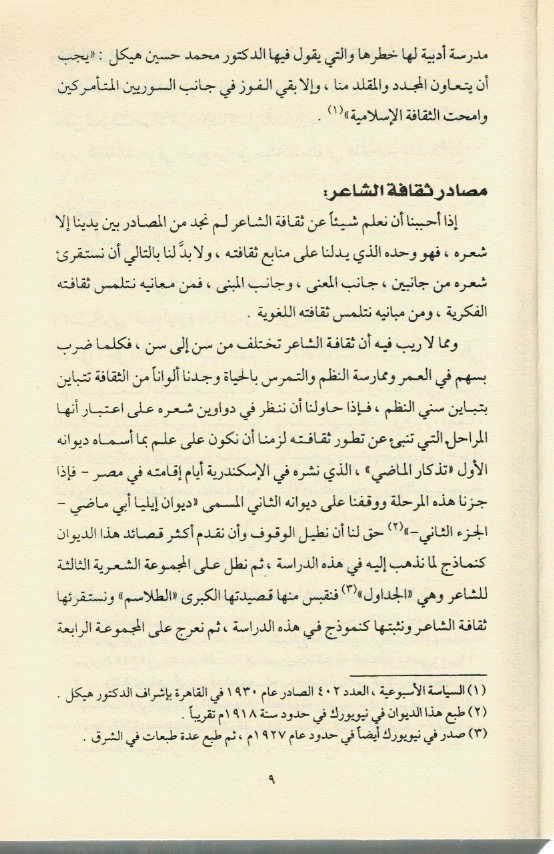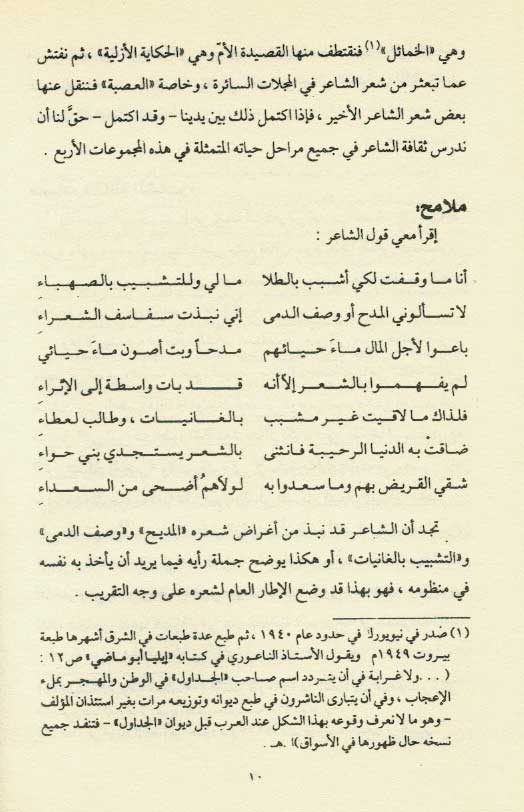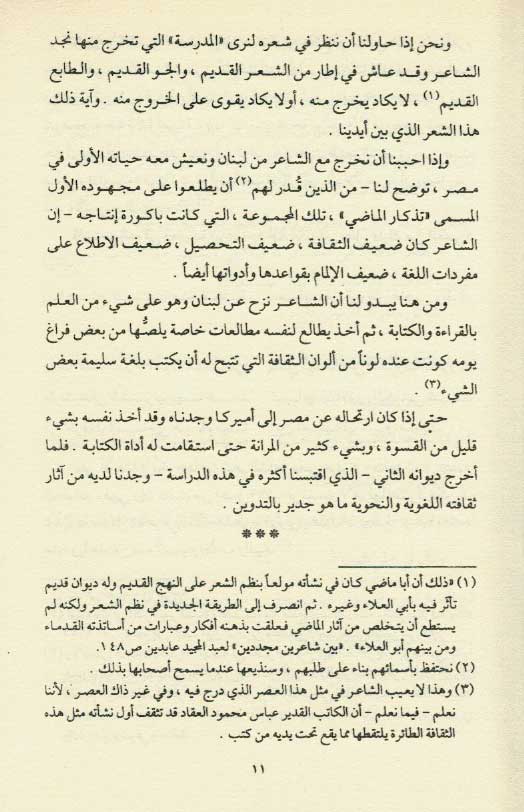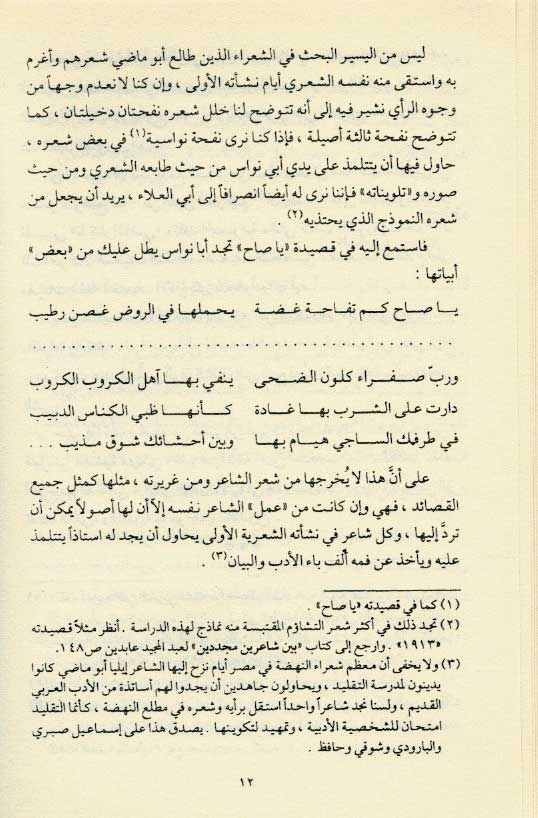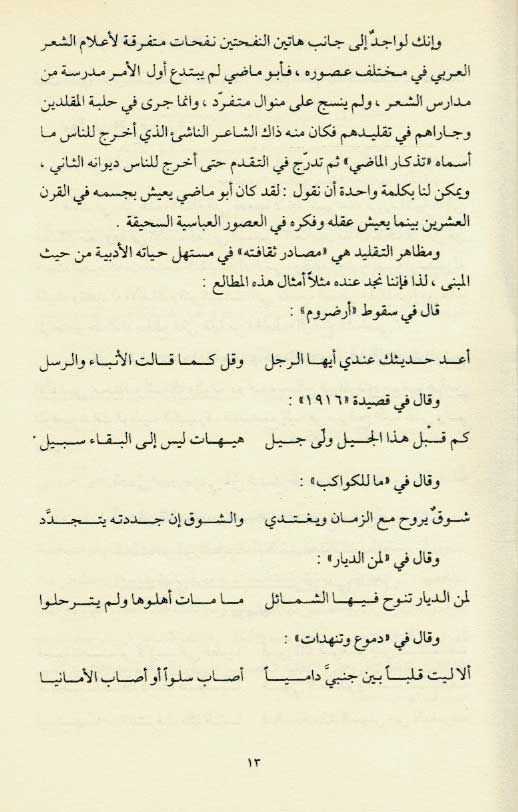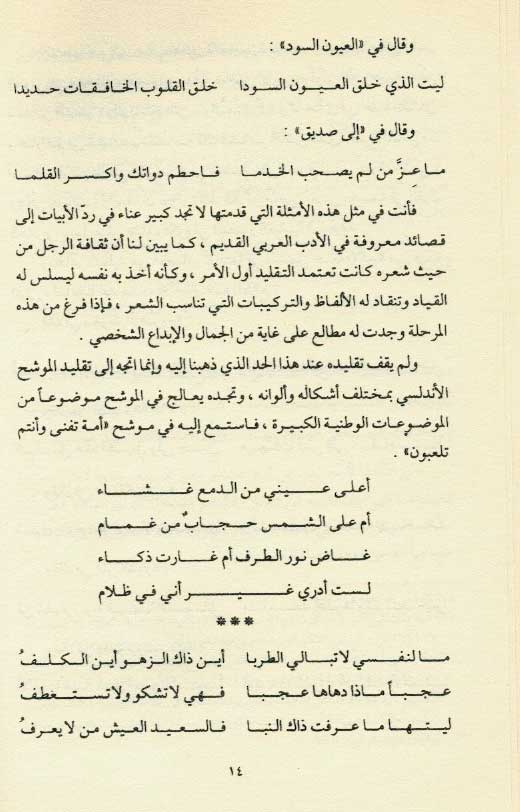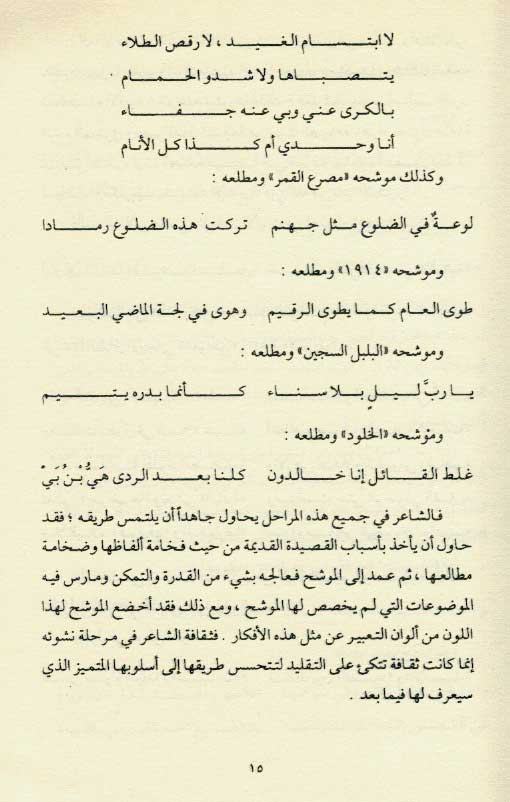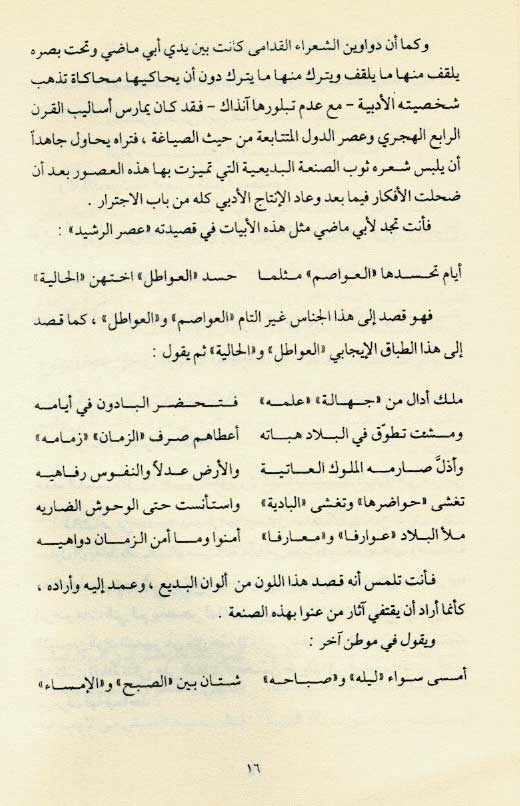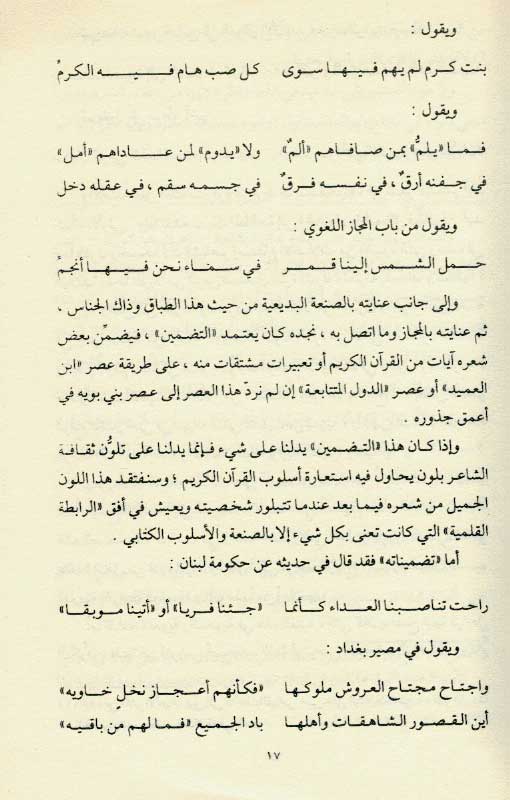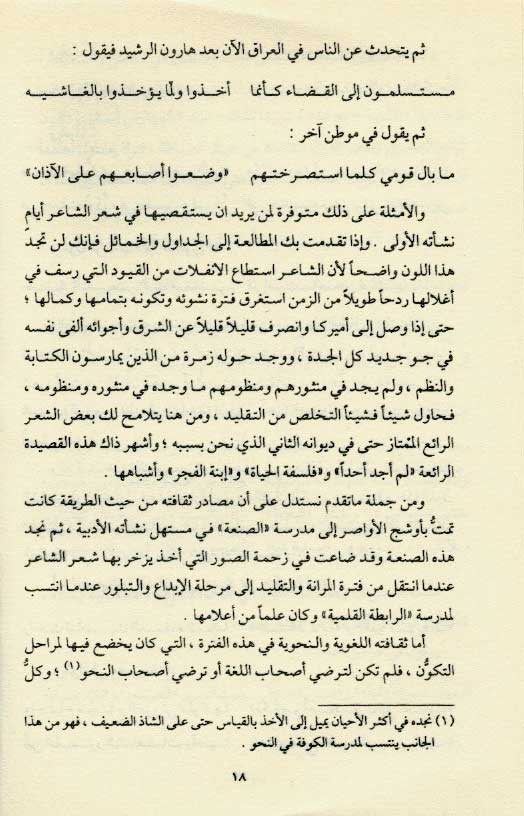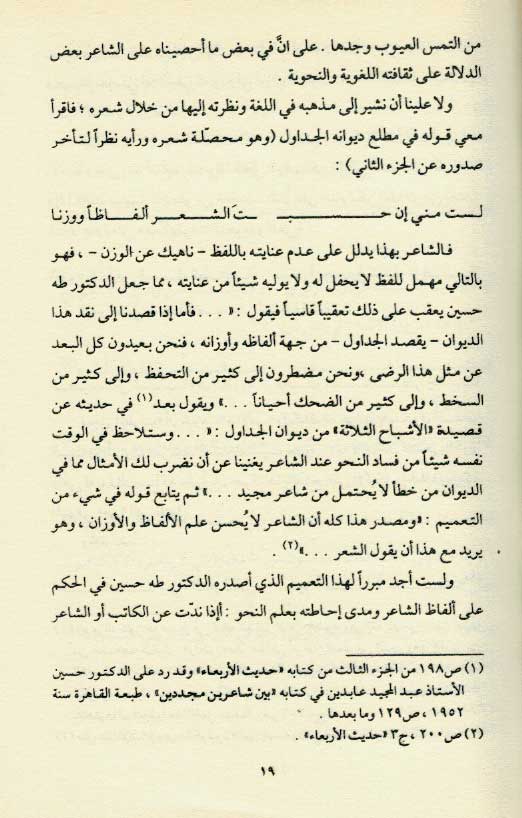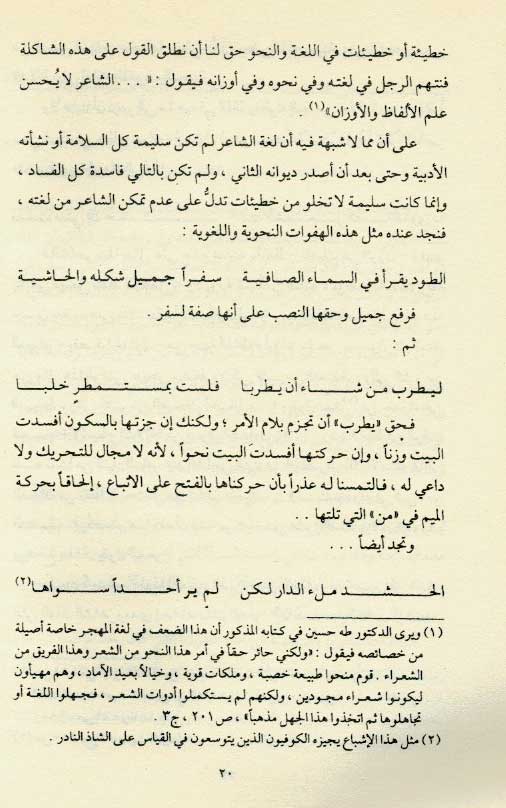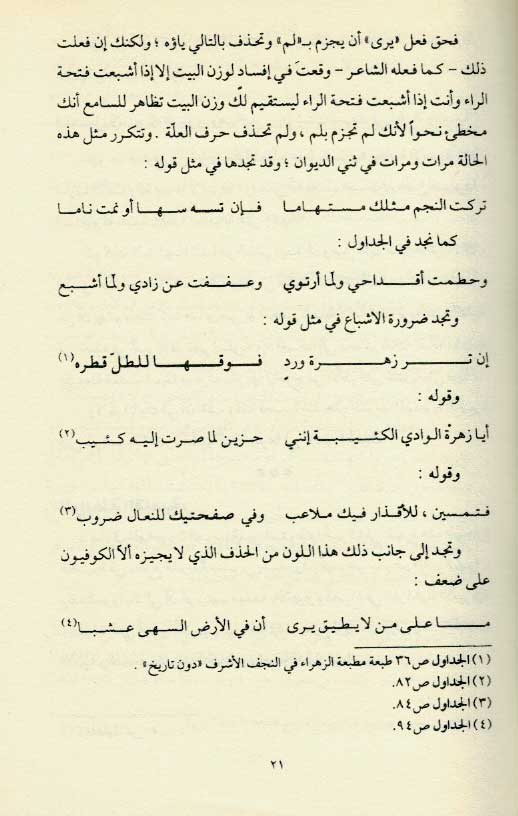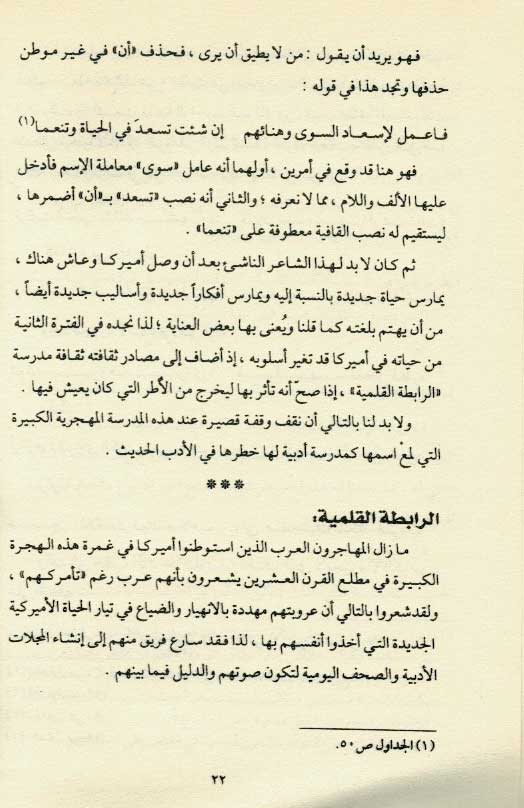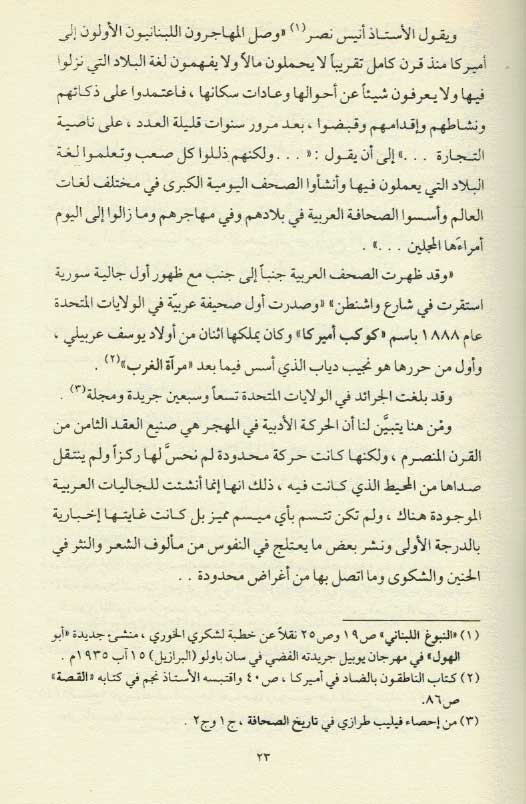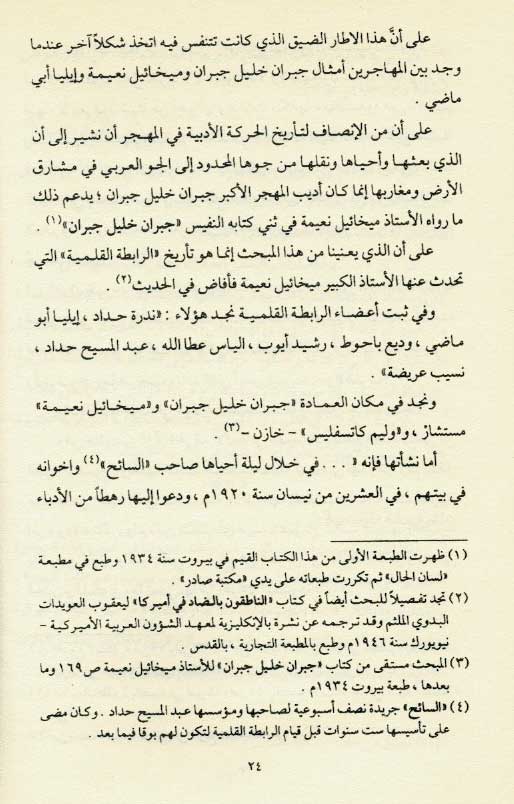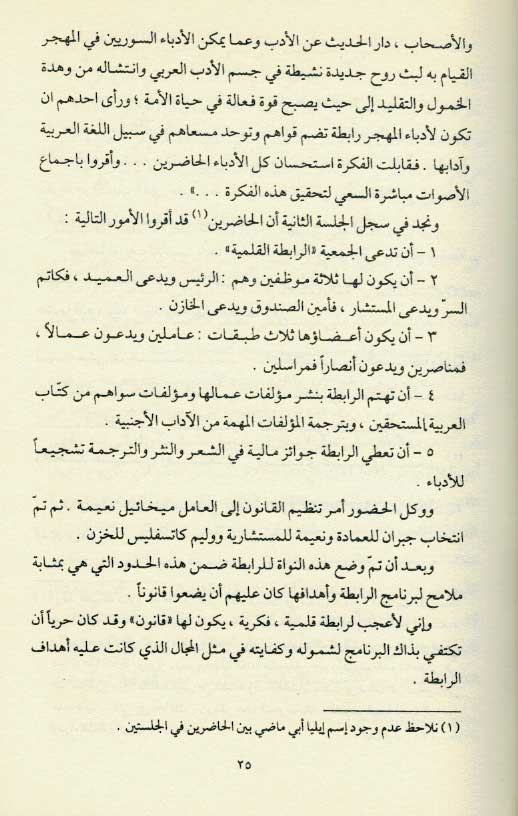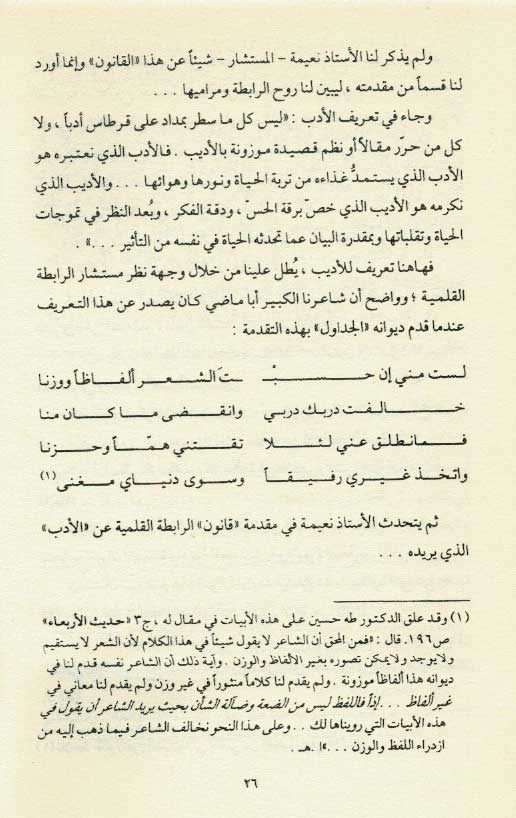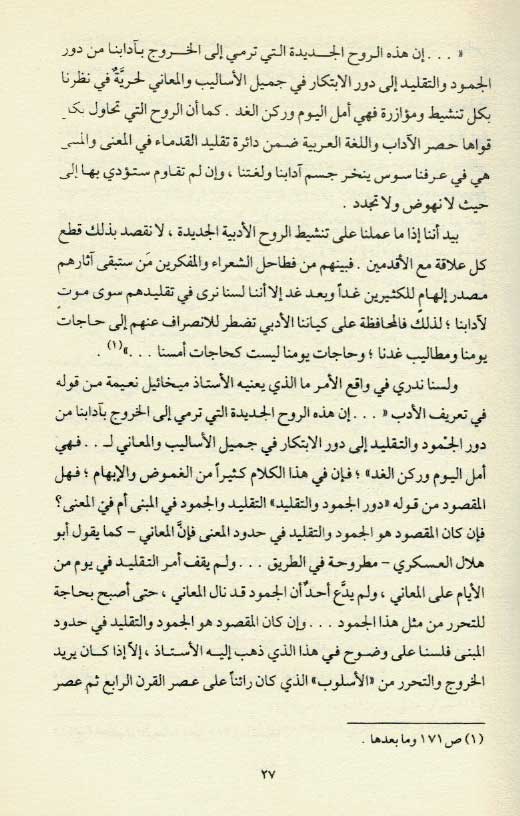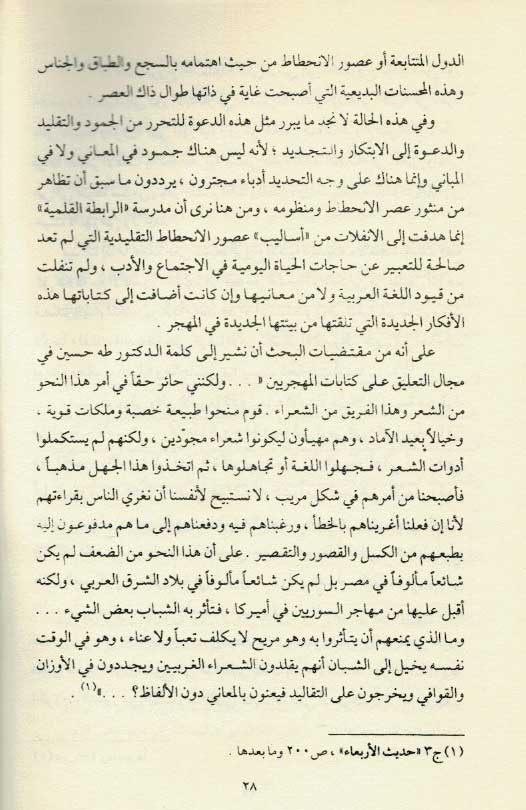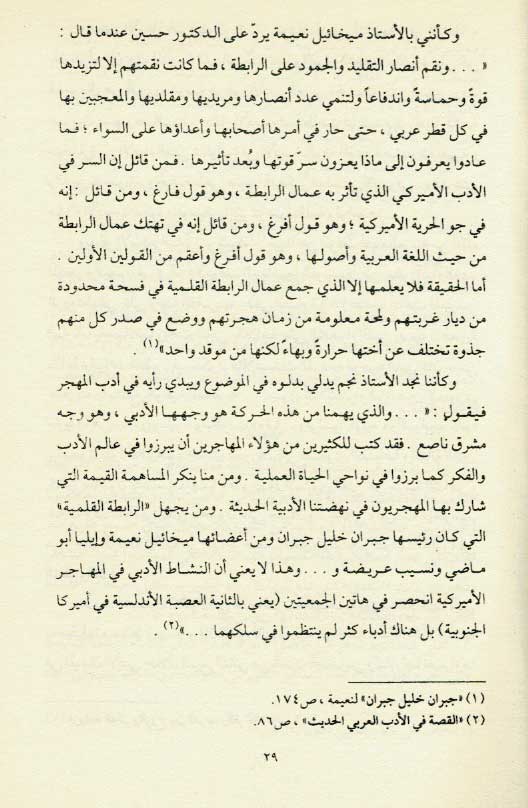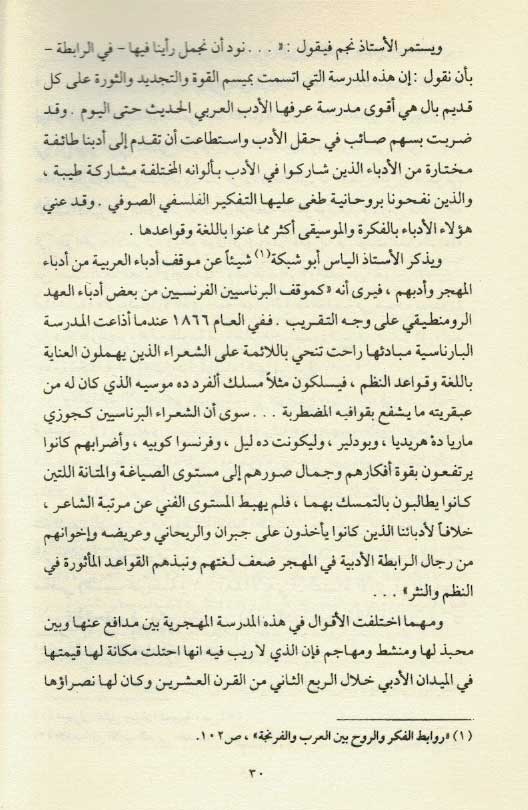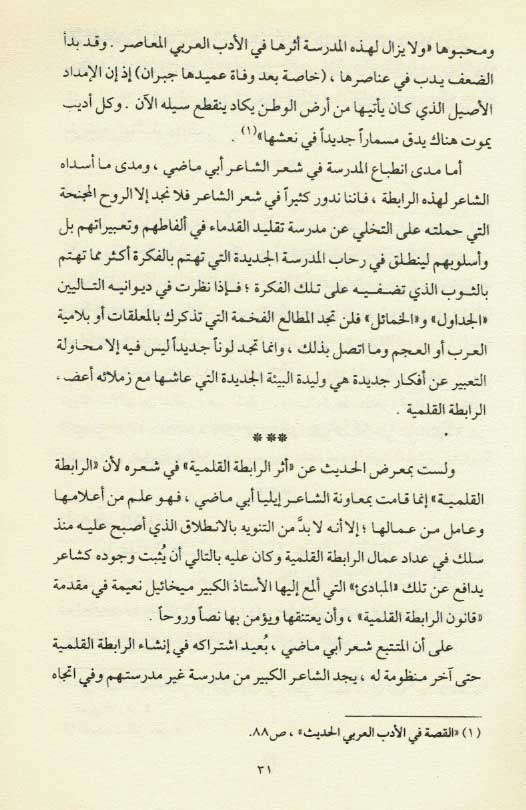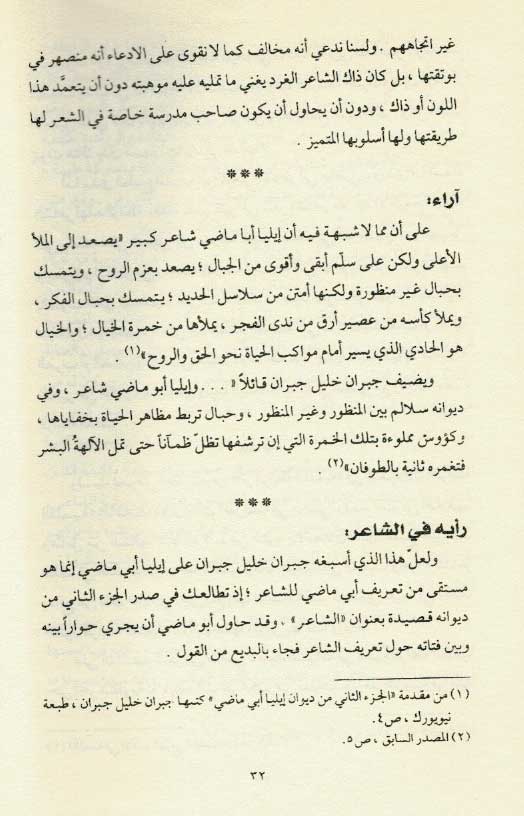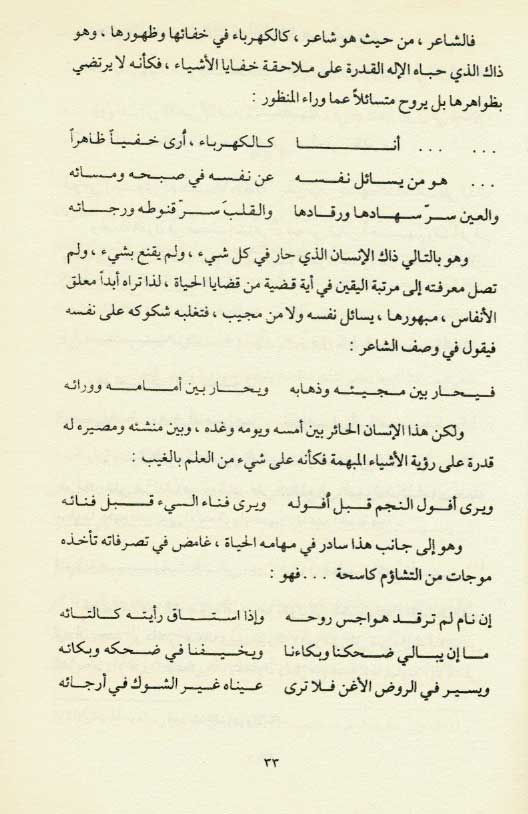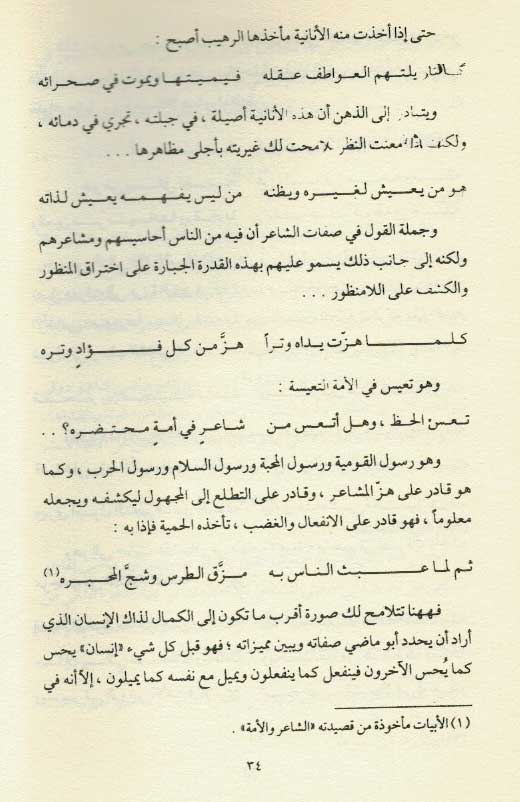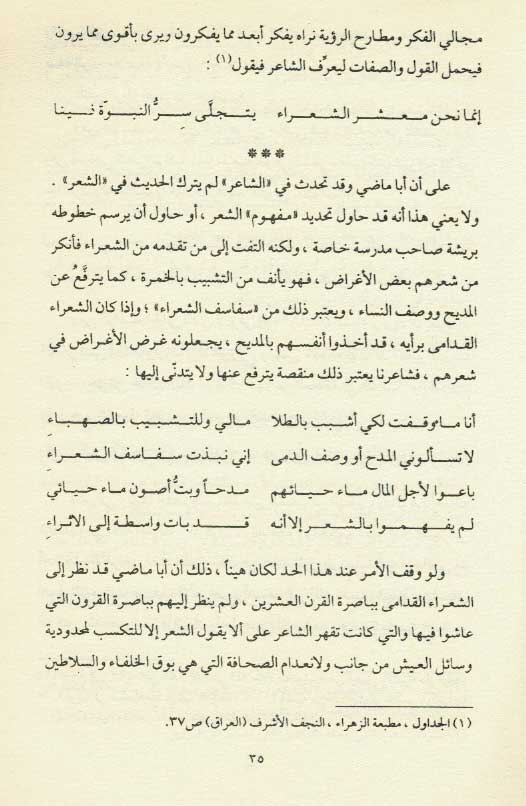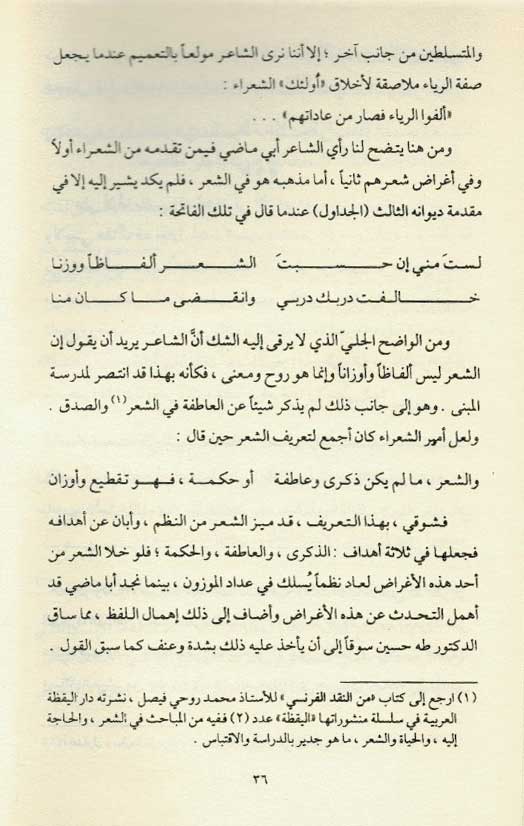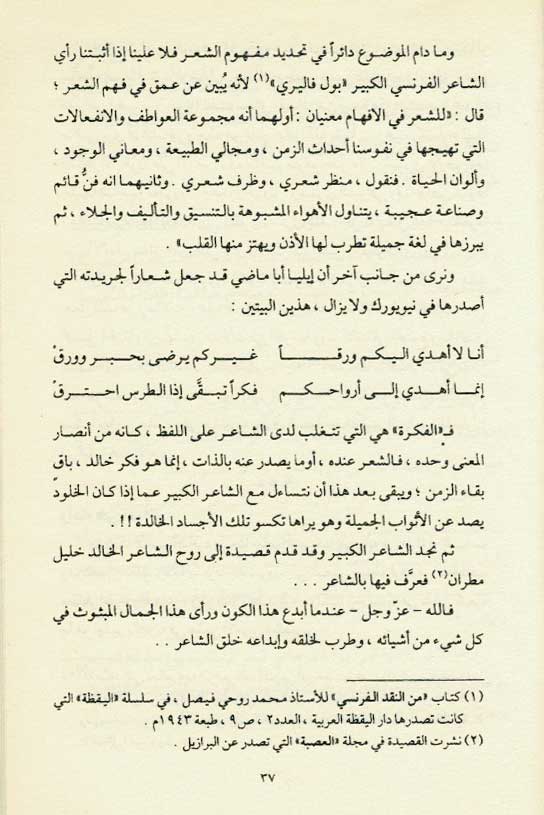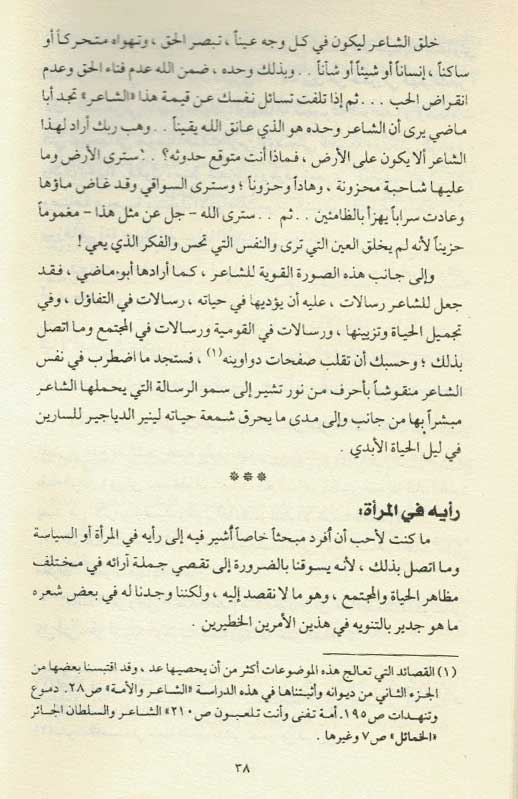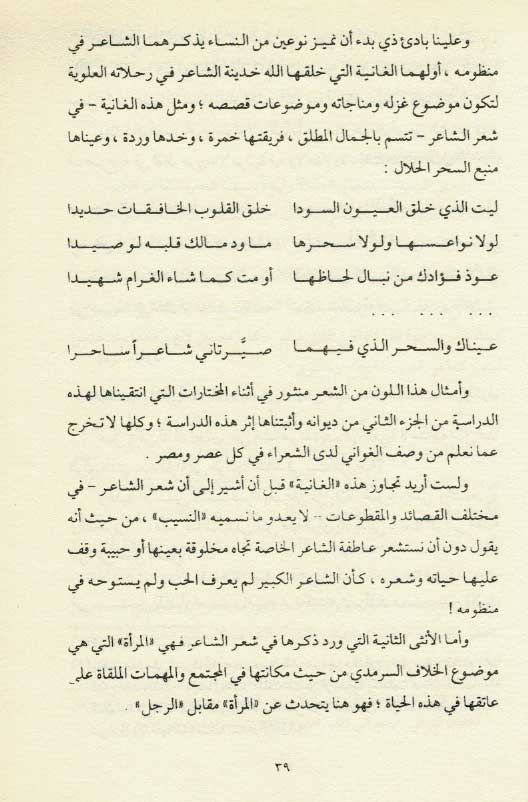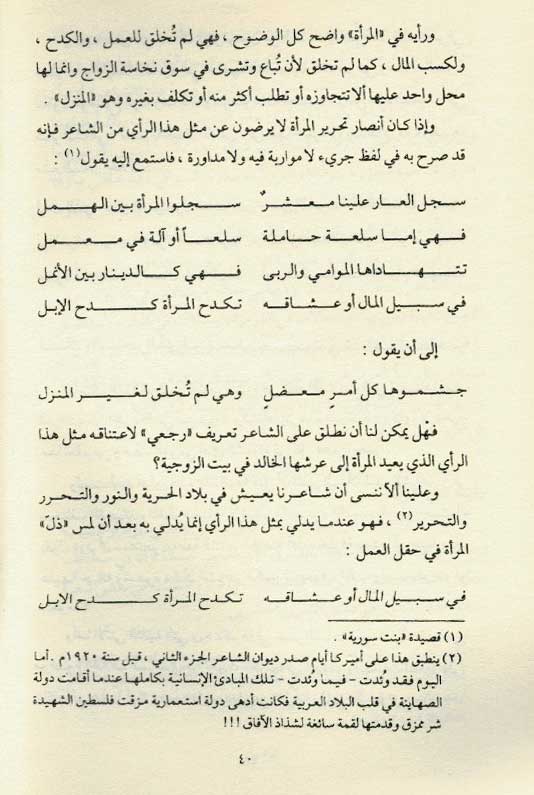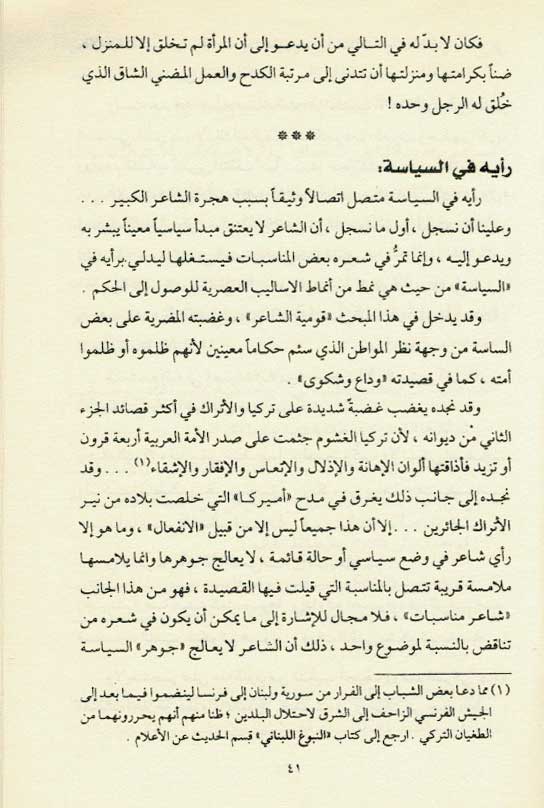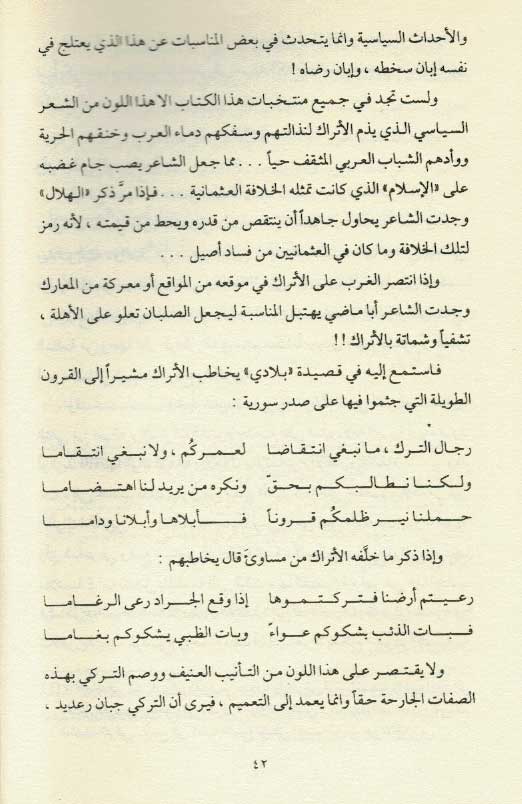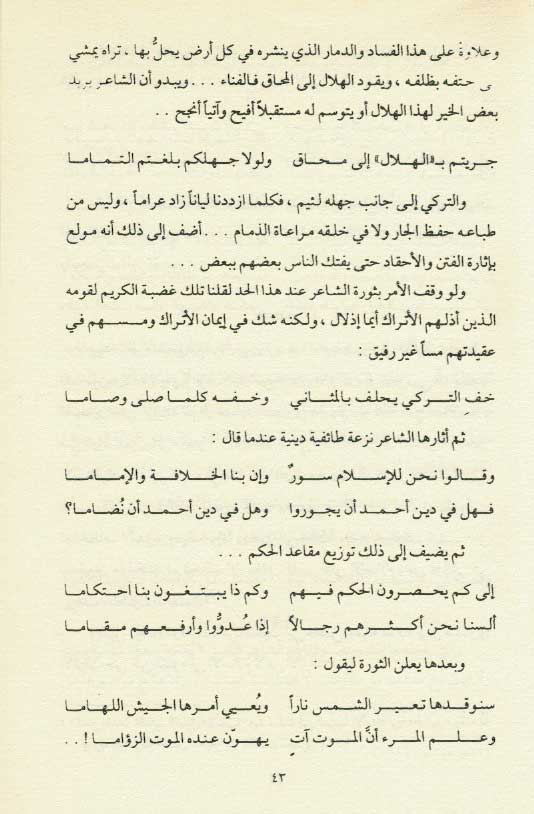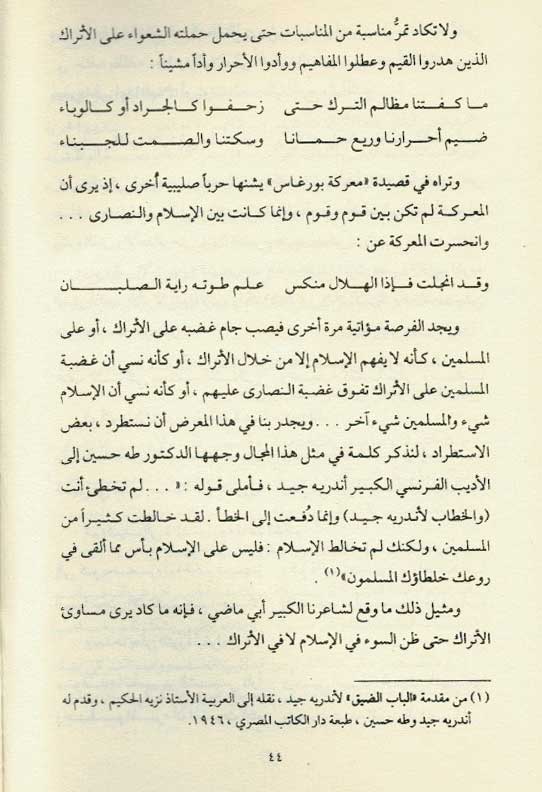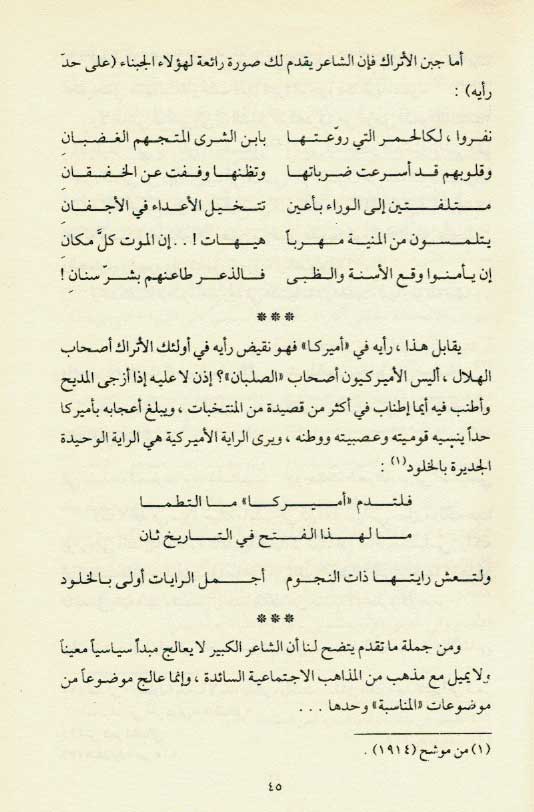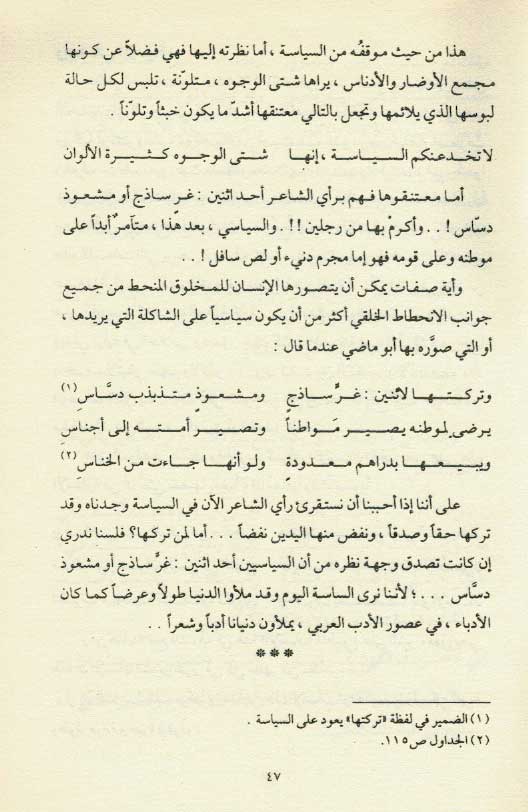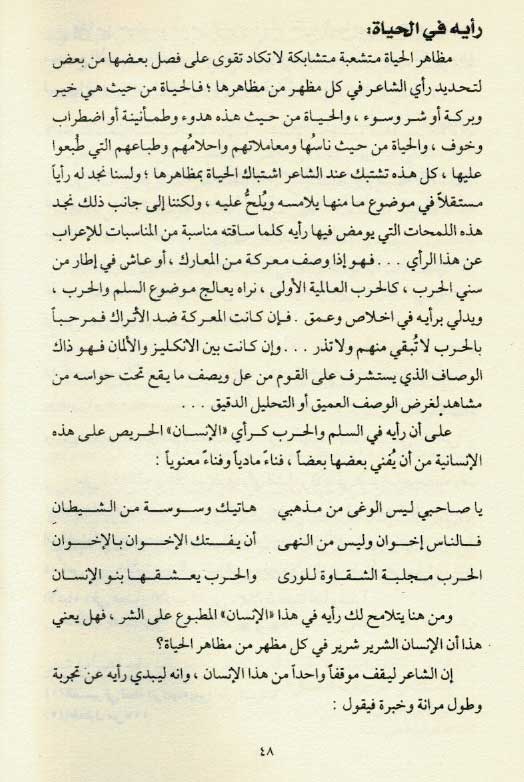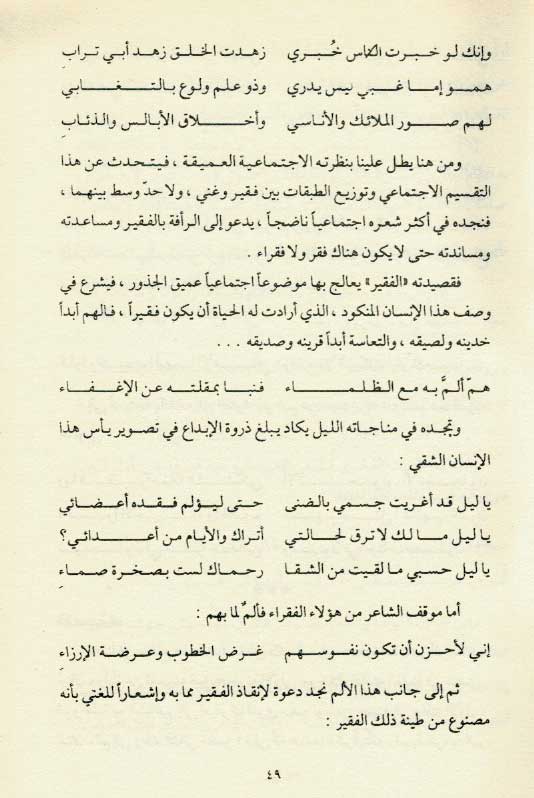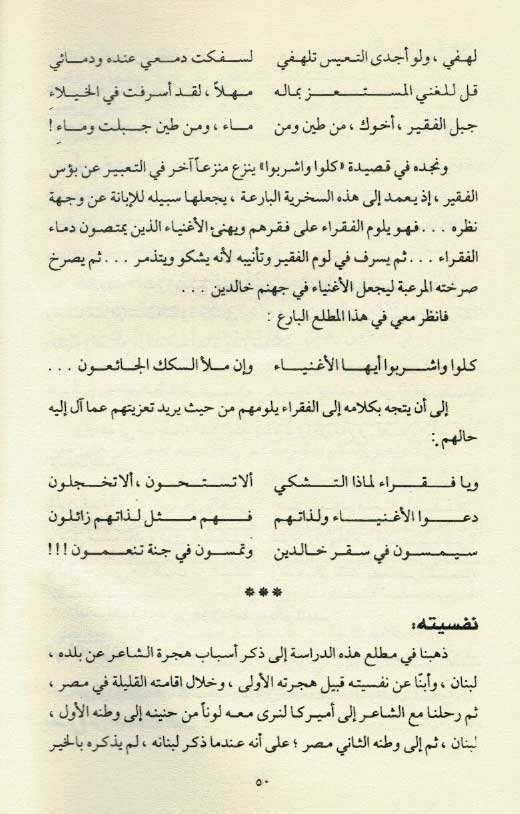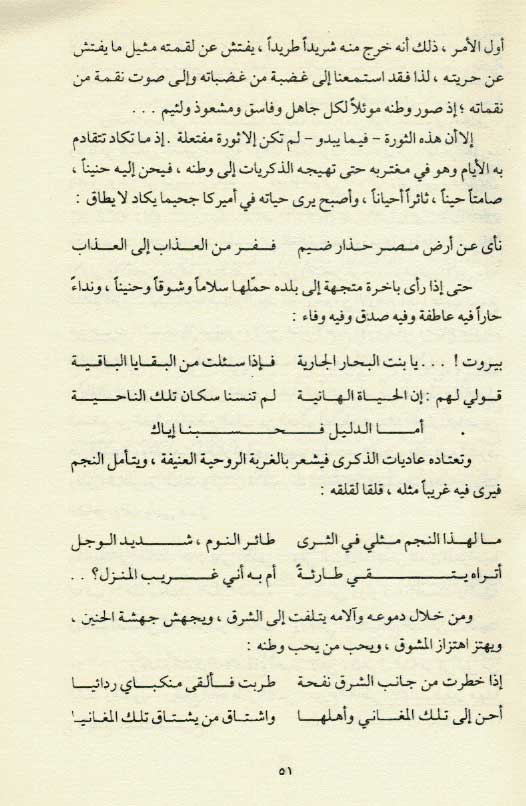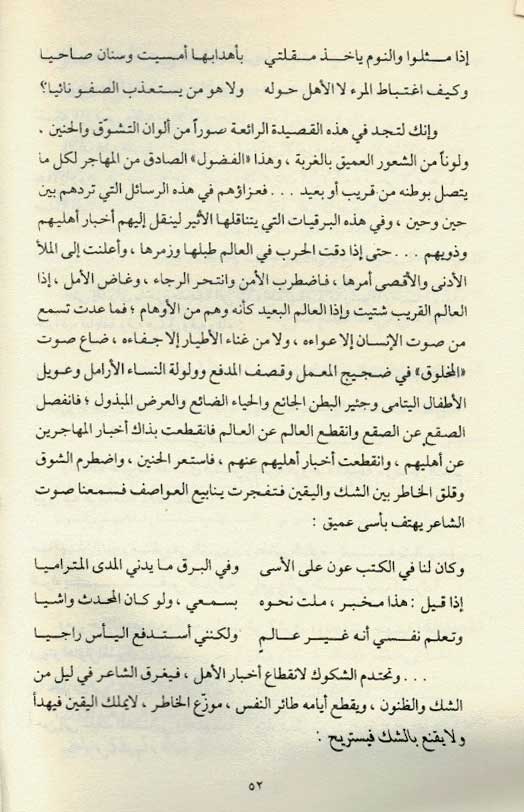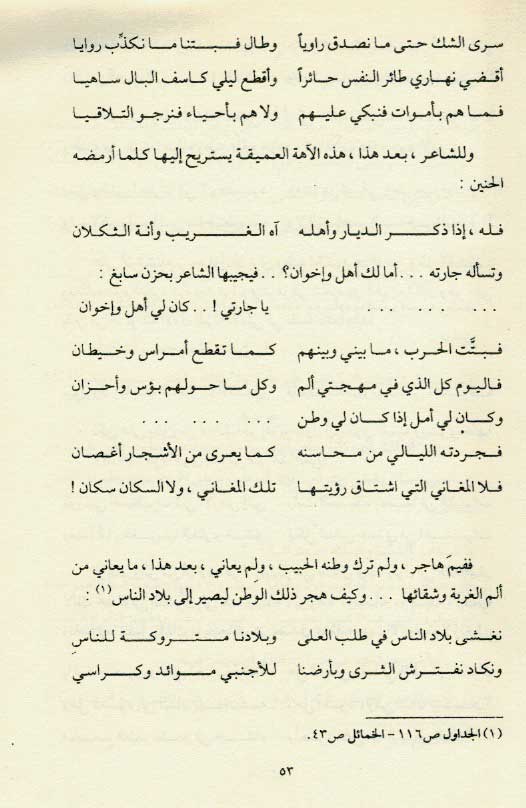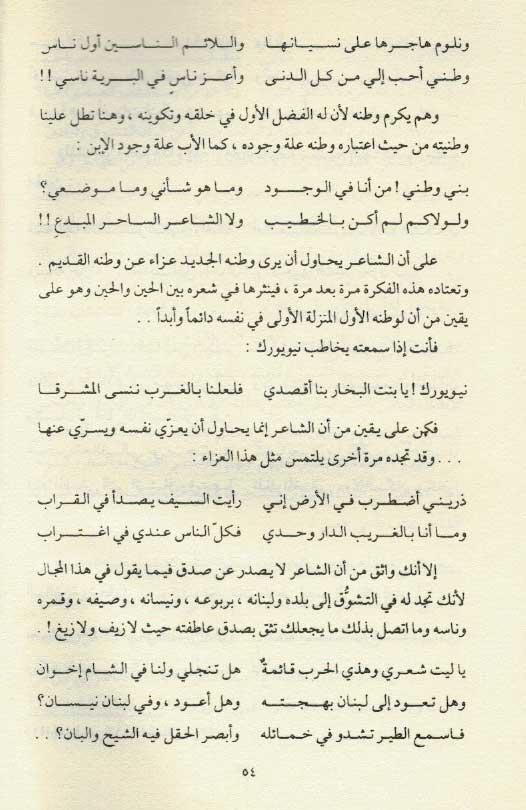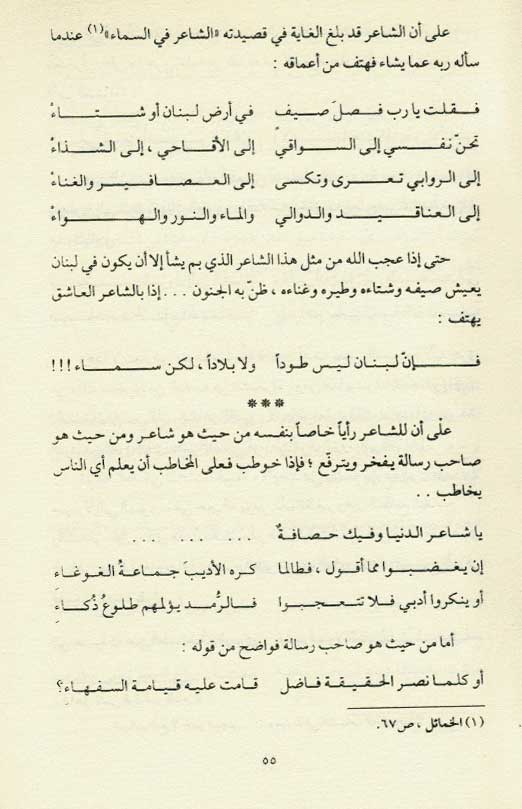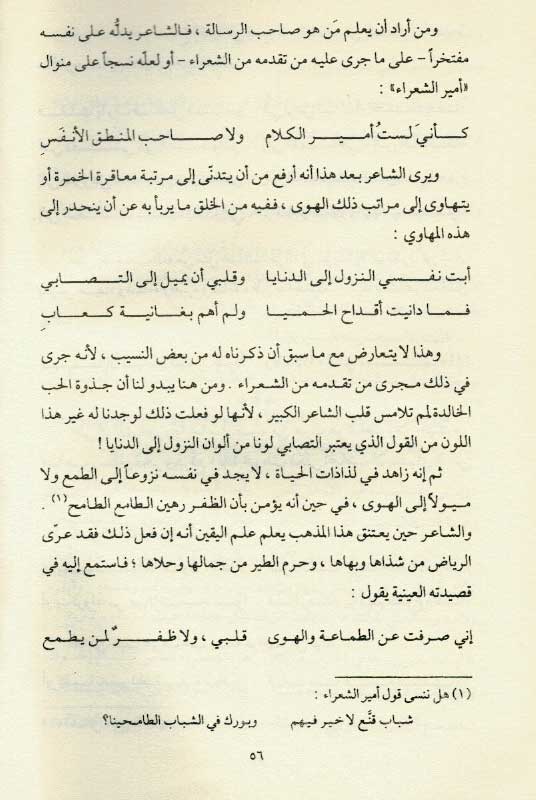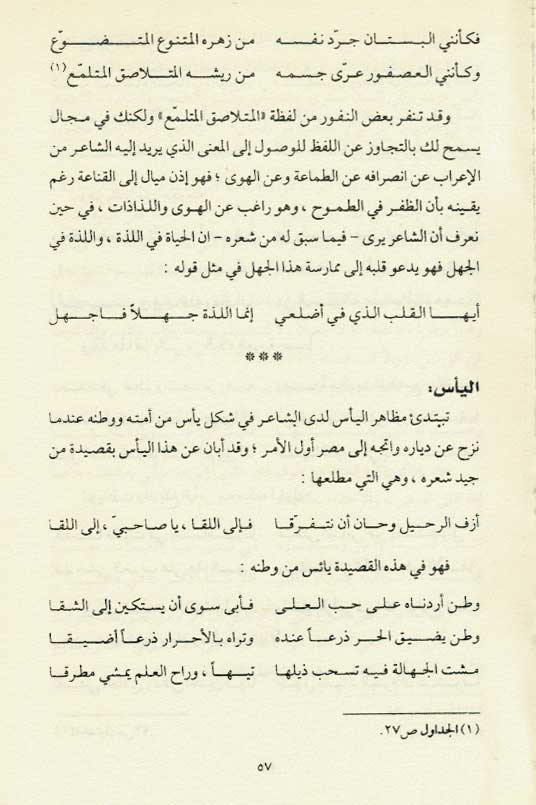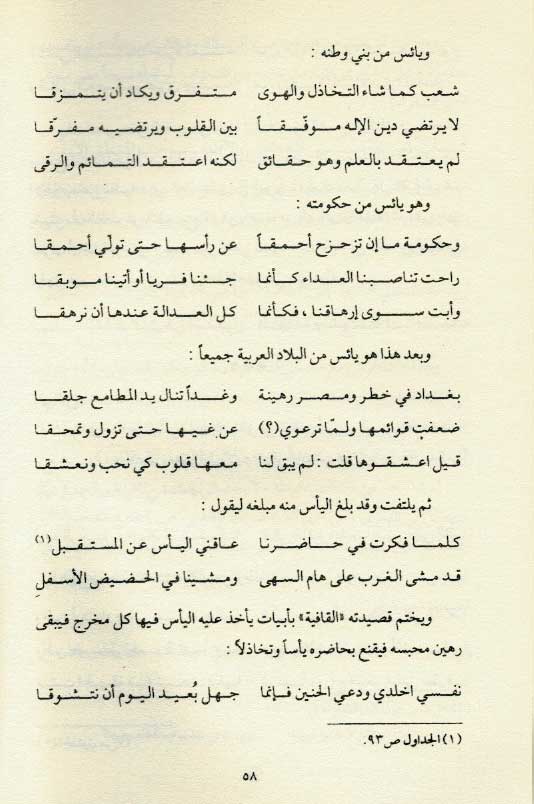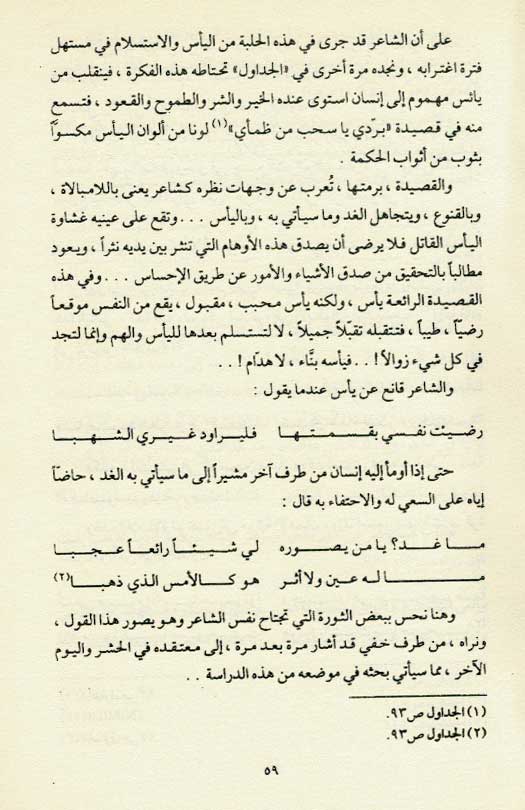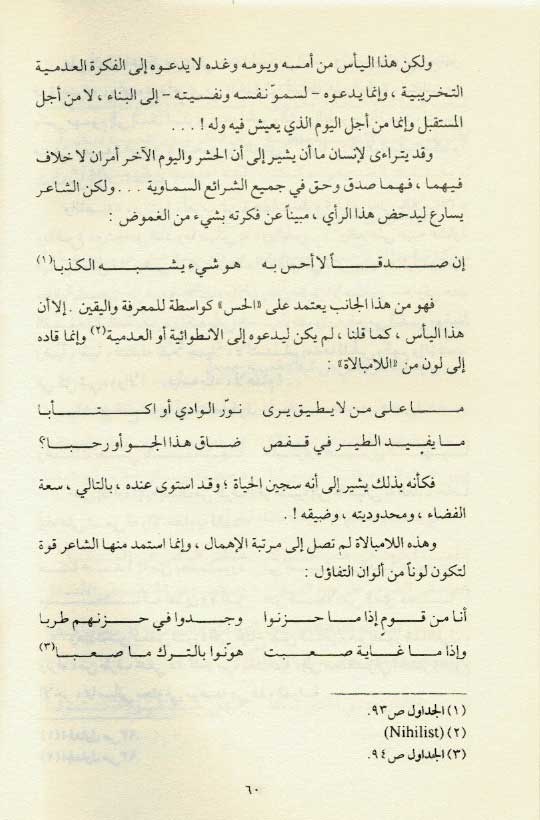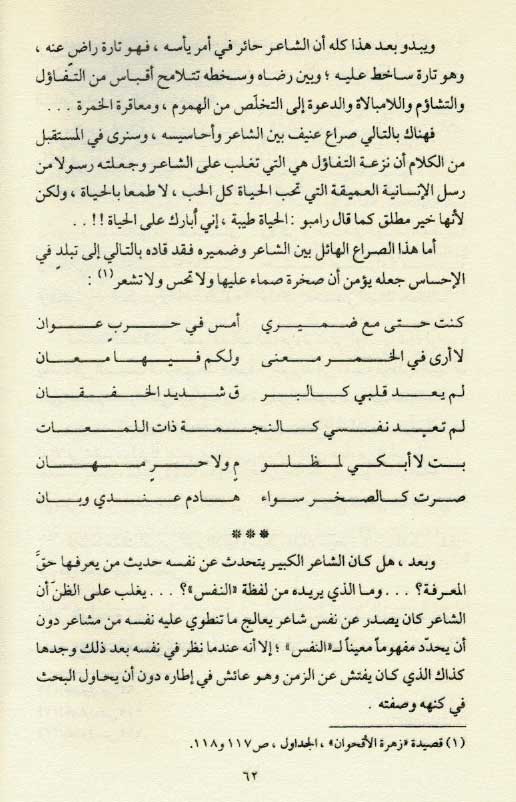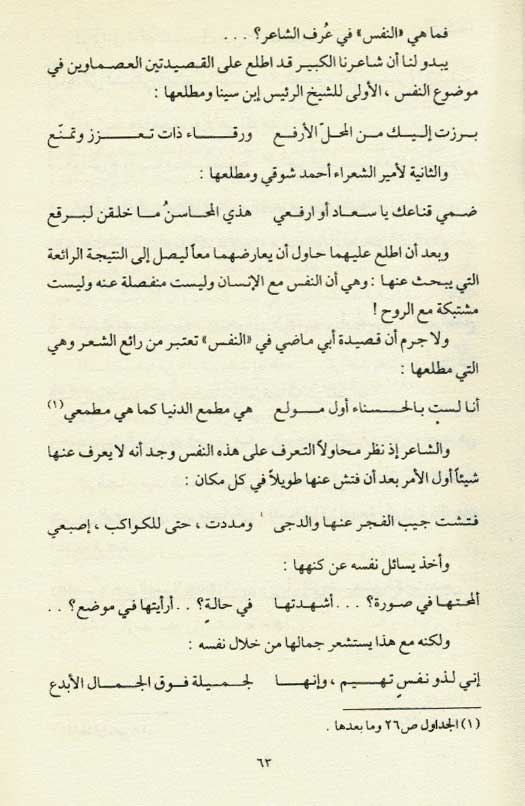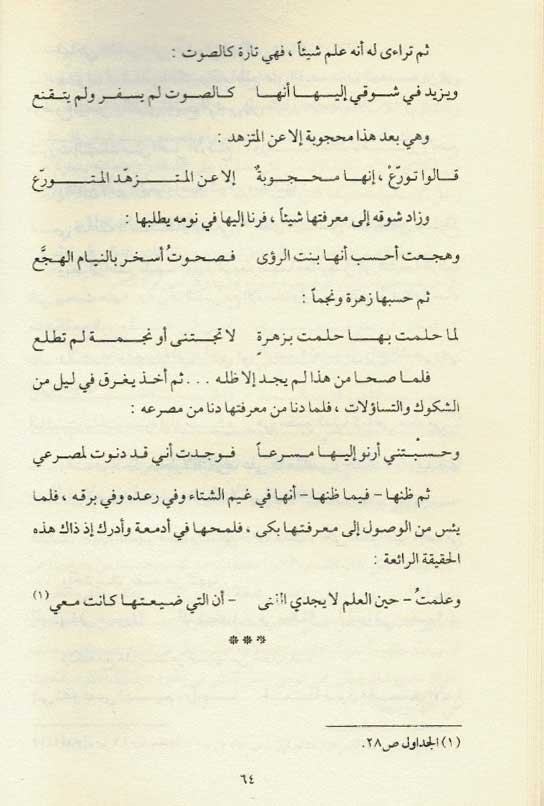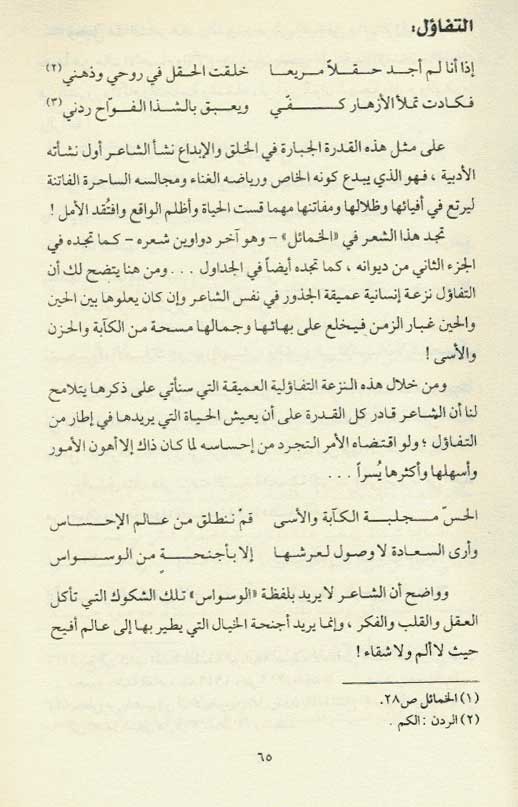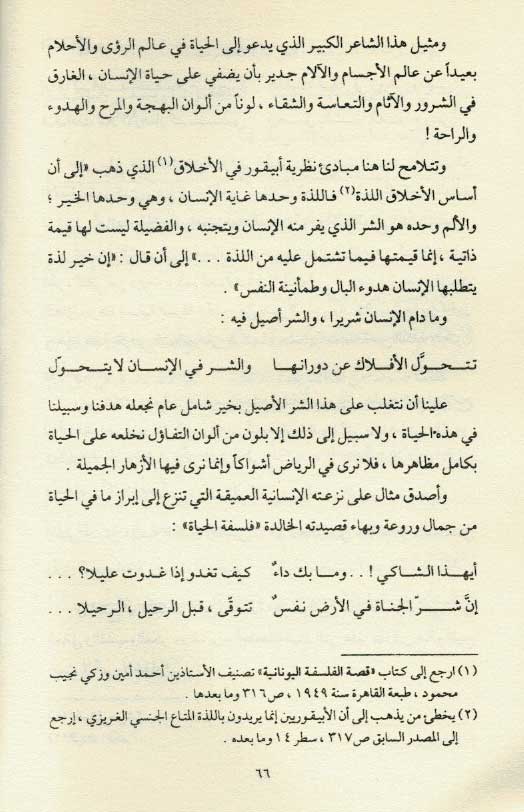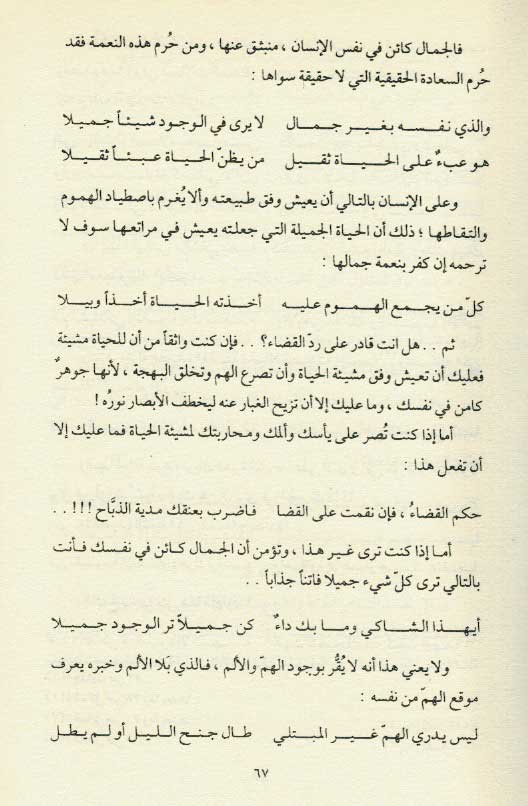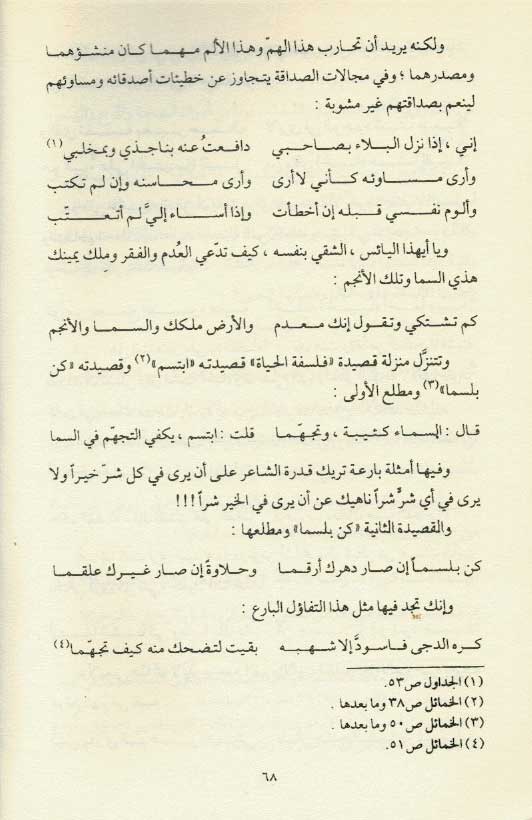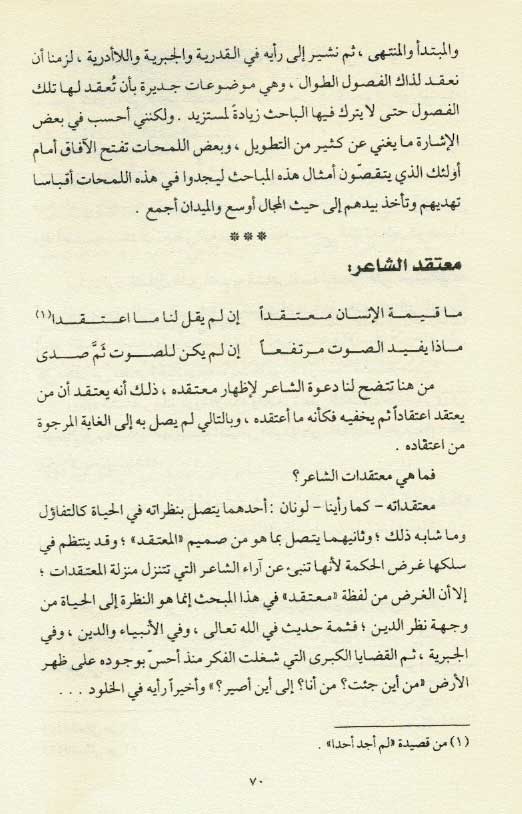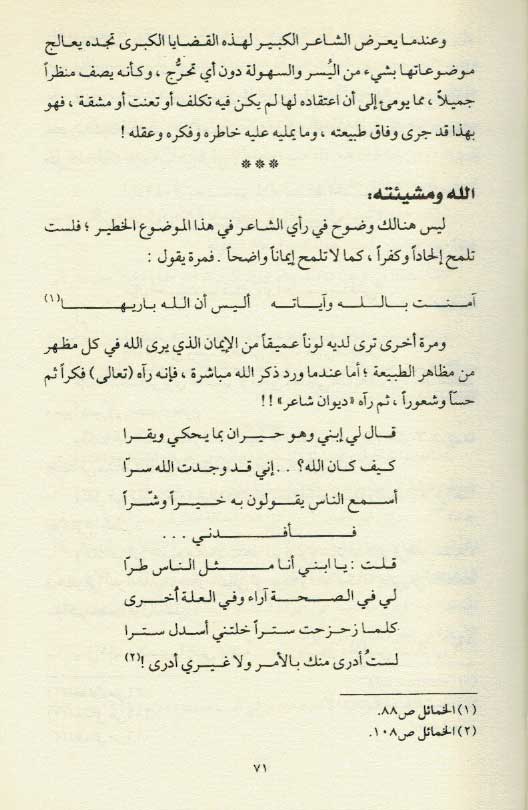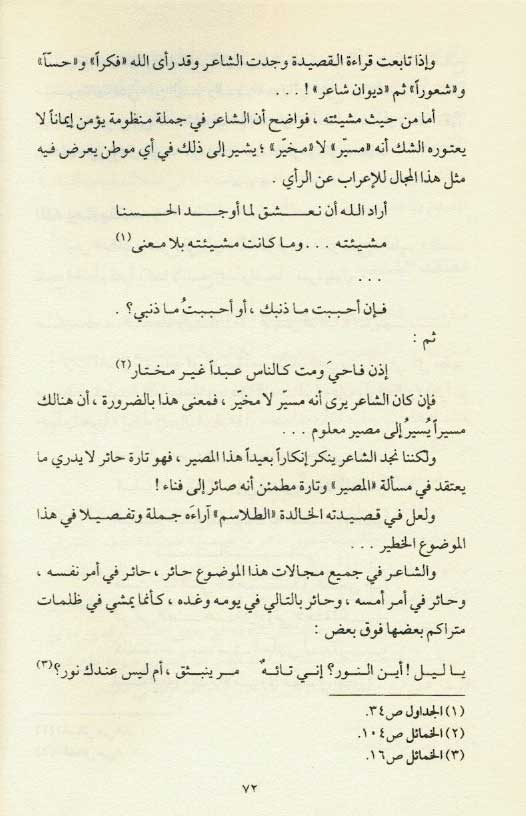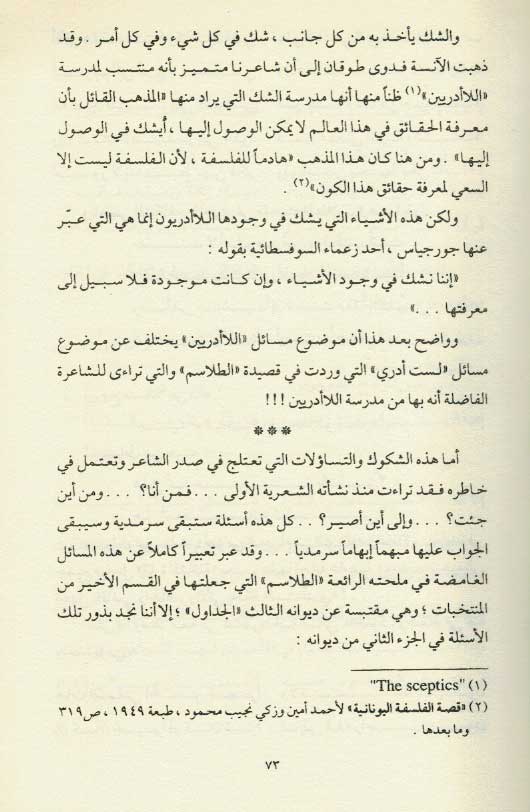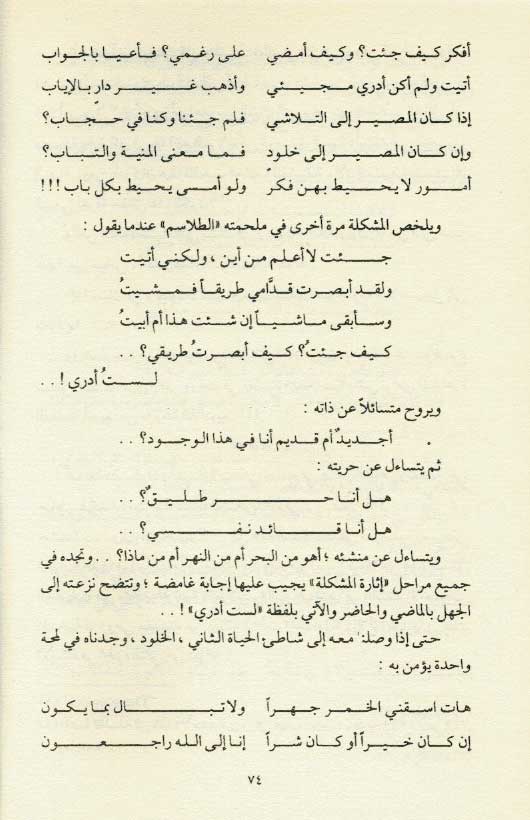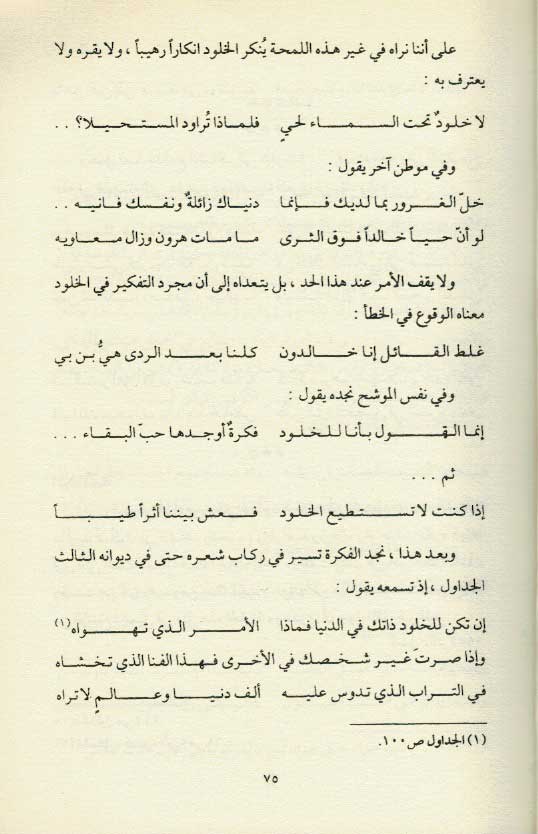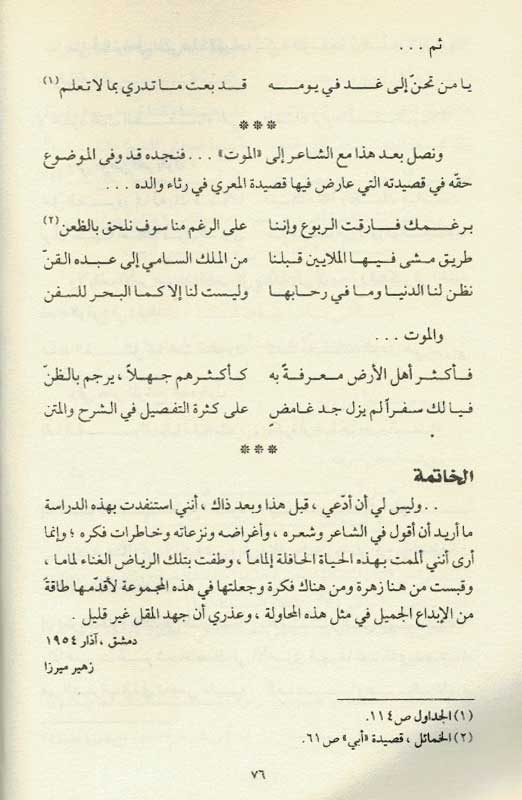كتاب “إيليا أبو ماضي – شاعر المهجر الأكبر”
لمؤلفِّه زهير ميرزا
مقدمة :
يجمع هذا الكتاب بين دفَّتيه تقديماً قيِّماً للدكتور “سامي الدهان”، ودراسةً مستفيضةً للأديب الشّاعر “زهير ميرزا” عن “إيليا أبو ماضي” وأشعاره، كما يحوي أغلبَ دواوينَ شاعرالمهجرالتي كان قد نشرها متفرّقةً على مدى سنوات. هذه الدّراسة التي تكاد تُغني عن ما قيلَ في شعر أبو ماضي والمهجر؛ أنزلتِ الكتابً المنزلةَ التي يستحقُّها بين الكتبِ والمراجعِ المتميّزة في المكتبة العربية.
ومما قيل عن الكتاب على لسان “سُميّ بن مُعين”:
“لقد كَلِفَ الشّاعر زهير ميرزا بإيليا أبي ماضي وأحبَّه، وسار في طريق صورِه ومعانيه، وساقه هذا الحُبُّ إلى أن يُعنى بديوانه، وأنْ يُقدِّم له دراسةً واسعةً تُقارب التّسعين من الصفحات، نُشرَتْ سنة 1954، وهي أوسعُ ما صدرَ عن أبي ماضي حتى ذلك الحين”.
تصدير الكتاب
الدكتور سامي الدهّان
بعد ثلاثة عشر عاماً أعود إلى هذا الشِّعر وأنا حزينٌ أسف، لأقلِّب هذه النّسخة الأنيقة، في ورقٍ كزرقة السَّماء، وحروفٍ ترتجف أمام عيني كما ترتجف النيازك وهي هابطةٌ محترقةٌ بلَهبِ الوداع، تغادر النّجوم في الأعالي، لتختلط برماد الأرض.
أجل، بعد ثلاثة عشر عاماً، أعود إلى هذه النّسخة لأنظر في أسىً ووفاء إلى هذا الإهداء الذي صاغته أنامل الشّاعر لحروفٍ مائلةٍ متّسقةٍ كاتّساق الخطوط في لوحة الفنان، فأرى فيها عبَق الوفاء وجمال التواضع. وتطير بي الذكرى إلى سنين خلتْ كنتُ أَلْقَى فيها هذا الطّالب الشابَّ فأرى فيه شاعراً يطاول طموحُه كبارَ الشّعراء، يتمتم بالنّظيم كما يتنفّس بالهواء، زفرةً بعد زفرة، ضاحكَ السنِّ، يخفي في صدره حكمةً حزينة، كأنَّها بقايا النّدوب خلّفتْها جراح الأيّام في ضلوعه الفتيّة أو زرعتْها قرارة الشّعر الباكي في صدره الغضّ، فقد كان يميل إلى المعرّيّ كلّ الميل، وينزع إلى إيليا أبي ماضي كلّ النزوع، ويقرأ لأبي نوّاس كلّما هزَّه الشّوق إلى الفنّ.
وما أزال بعد هذه السّنين، وأنا أقلِّب هذه النّسخة الجميلة – وهي شِعرُه الوحيد الذي نشرَه – ألمحُ صور النّدوب ماثلةً في كلّ مُنعطَف، وأراها في كلّ زاويةٍ من زواياه، يلفُّها الشكُّ والرّيب، وتدور فيها مأساة الحياة، فهي في نظره خادعةٌ كاذبة، والنّاس فيها يعيشون على وهمٍ برّاق، وسرابٍ لامع، فنظم فيها الشّعر على مشاهد تمثيليّة، يطول المشهد حيناً، ويقصُر أحياناً، فهو في مشهدٍ يصوّر شهرزاد وحبيبها، وقد ألحّتْ شهرزاد أن ترى طيفَه فحسْبُ بعدَ أنْ ملّتْ “وجوده”. وفي مشهدٍ آخر يرسم جنديين في المعركة آثر أحدهما الفرار، وأقنعه زميله بالعزّة والموت، وفي مشهدٍ ثالثٍ لقاءٌ بين فتى وفتاة، وفي مشهدٍ رابعٍ يرسم المارد والإنسان، ويحمل عنوان المشهد “كافر، وحيُ شيطانٍ مَريد” وهذا العنوان نفسه جعله عنوان هذه المجموعة الشّعريّة كلّها، وأصدرها مطلع 1948. ولن أطمع في الكلام على ما بعده من مشاهد فهي كثيرةٌ، بسطَها صاحبُها صورةً لشاعريّته، ورمزاً لديوانه الذي دُفن معه، فأنقذ منه هذا النّذْر اليسير ليدلَّ على شِعرٍ كثير، وقريحةٍ متدفّقة، وكهولةٍ في النّظم، وعُمقٍ في التفكير، وبُعدٍ في التّلوين.
وهذه النّسخة الجميلة وحدُها دليلي إلى صاحبها الشّاعر المرحوم زهير ميرزا، فهي تغصُّ بالألم والعبرة والحزن، وتنبضُ بالحيرة والشكِّ والرّيب، تقتتل على أبياتها الأسئلة المحيّرة: لماذا جئنا إلى الدنيا؟ وكيف جئنا؟ وما هو غدُنا؟ وكيف نفهم أسرار الحياة؟ وما هي المرأة والرّجل؟ ولماذا كان الزّواج؟…
والعجيبُ أنَّ هذه الأسئلة راودتْ أفكار بعض القُدماء في الشّعر العربيّ، ولكنها تعلَّقت في المعاصرين بشعر إيليا أبي ماضي وتعلَّق بها، فسالتْ في قوافيه، وعُرِفَ بها ،وكان من أثرها شعرٌ كثير في لبنان وغير لبنان. وكان لها في سوريا طلّابٌ ومريدون، من أقربهم إلينا الشّاعر زهير ميرزا، فهو يكرّرها في معانيه ومبانيه، ويردّد علينا كلمات الوهم والملل، ويرى الزّواج قيداً، بل يقول: “إنَّ الزّواج المجلوبَ مقبرة الحسِّ”، ويختمُ هذه المجموعة بقوله على لسان أحد الأبطال في مسرحيّة “بجمليون”:
عبثاً نطلبُ الخلودَ بَنيْ المــــوت… فمَنْ كانَ للرَّدى ليسَ ينفَعْ
كلّما حاولَ الصّعودَ تعالى وتعالى وســـوفَ يـنـكــــبُّ أجْـــــــدَعْ
طينةٌ نحنُ .. ليسَ يعلــو عـليـــــها وإذا كانَ فالنُّهى قـد يُـخـدَعْ
عُـــدْ كما كنتَ للتـُّــرابِ ولا تــرجـعْ وكلٌّ لأصـلِـه سـوفَ يَـرجـعْ
ولن نقفَ عند هول المأساة، وحديث الغيب المجهول في صدر الشّاعر، ولن نتحدَّث عن نهاية الشاعر الشابّ حين صعد في طائرةٍ كما صعد فوزي المعلوف، ولكنه سقط من الأعالي مع الحُطام، وهو يحاول بلوغ السَّماء، فأصبح بعد قليلٍ من بني الموت، ورجعَ إلى التّراب الذي نشأ منه … فذلك حديثٌ عن حياته ليس مكانُه هنا، وإنَّما سُقنا الكلام عن شاعريته لنفتّش عن خيوط الشّوق بين الشّاعر الفقيد وديوان أبي ماضي.
لقد رأينا أنَّه كَلِفَ به وأحبَّه، وسار في طريق صُوَرِه ومعانيه، وساقه هذا الحبُّ إلى أن يُعنى بديوانه، وأنْ يُقدِّم بين يدي ذلك بدراسةٍ واسعةٍ تُقارب التّسعين من الصفحات، نُشرَتْ عام 1954، وهي أوسعُ ما صدر عن أبي ماضي حتى ذلك الحين، فخدم بذلك حبيبه الشّاعر خدمةً كبيرة. وأضاف إلى هذه الخدمة يداً خيّرة حين وفّر لبلده ديوانه المطبوع في نيويورك سنة 1916، وقد كان هذا الديوان محجوباً عن مطابع الشرق العربيّ، لا يكاد القرّاء يصلون إليه لنَدْرته، وغفلة النّاشرين عن مَقامه.
وبهذه الدّراسة وهذا الديوان طاف أبو ماضي على قرّائه وعشّاقه بكأسٍ قديمةٍ جديدة، أُضيفتْ إلى كأسه في الجداول والخمائل، وهذان الدّيوانان وحدهما كانا السّائرَين بين النّاس في الشرق.
ولستُ في حاجةٍ إلى الإشادة بهذه الدّراسة وهذا الشّعر، فهما بين دفّتَي هذه الطبعة الثانية، يستطيع القارئ أن يستمتع بهما، وأن يجد عندهما ما يروي غليله، ويشفي ما بصدره من شوقٍ إلى هذا الشّعر المجنَّح والكلام العميق والصُوَر البعيدة التي كان يُرسلها الشّاعر أبو ماضي.
ويكفي أن أُسجِّل هنا للتاريخ والذكرى إعجابَ الصّديق الشّاعر إيليا أبي ماضي بهذه النشرة، وقد حملتُها حين نزلتُ ضيفاً عليه، بمنزله الرَّحب في “بروكلين” قُرْب نيويورك سنةَ صدورها، فقد فرح بها أشدَّ الفرح، لأنها كانت أوّلُ الدّراسات التي صدرتْ عن القاهرة ودمشق بهذه الأناقة، وأذكرُ أنه قدَّم لي دراسة عيسى الناعوري عن “إيليا أبو ماضي، رسول الشعر الحديث” لأوازن بين الدراستين.
وقضينا ساعاتٍ أستمتع بشرح الشّاعر لما كان في ديوانه قبل أربعين سنة، وعيناه تضحكان للذّكرى، وأساريره تنفرج للتقدير، حتى لقد أحسست كأنَّ الفرح يُطلق لسانه بالتّغريد الجميل، والثّناء العاطر، لهذه اليد تضيفُها دمشق فوق يدها عليه بتكريمه في مدرَّج الجامعة السّوريّة. فقد كان – يرحمه الله – يعتزُّ بذلك التكريم وقد هبّتْ دمشق كلُّها تُرحّبُ بمقدمه، وتزحف للقائه، وتنشد بين يديه الشّعر والنّثر، وقد وقف بقامته القصيرة يُرسل درَّةً من دُرره، يعدُّها جوهرة ديوانه.
إنَّ هذا التوفيق البارع في دراسة الشّاعر المرحوم زهير ميرزا للشّاعر أبي ماضي، وهذا الجمع الجميل لشعره المفقود هو السبب إذن في نفاد الطبعة الأولى التي أصدرتها دار اليقظة العربيّة مشكورة.
وقد أرادتْ دار اليقظة العربيّة أن تزيد في إحسانها، وأن تُبالغ في خدمة الشّاعر أبي ماضي، فأضافتْ بعد ستِّ سنواتٍ ما فاتها من شعره، وضمَّتْ ديواناً أصبح اليوم من النّوادر، لا يكاد يعرفه الدّارسون والباحثون، ذلك هو ديوانه الأول وعنوانه: “تذكار الماضي” نشرَه في الإسكندرية عام 1911، في خمسٍ وثمانين صفحة، يمثِّل شباب الشّاعر وخطاه الأولى، ويصوِّر نشأته، ومدرسته، وتأثّره بشعر مَنْ قبله. فقد حاول المختصّون أن يفهموا هذا، ولكنهم عادوا خائبين، فلم يقعوا على “تذكار الماضي”.
والشّاعر المرحوم زهير ميرزا نفسه كتب في مقدِّمة الطبعة الأولى (ص ز) عن هذا الدّيوان قال: “جمعَه في شبه ديوان، أسماه تذكار الماضي. وإنّي آسفٌ أشدّ الأسف لأنّني لم أستطع الحصول عليه. وبالتّالي لم أطّلع عليه لأتتبَّع الشّاعر منذ نشأته الشّعرية الأولى إلى الآن”. وهذا القول ساق الدّارسين بعده إلى عباراتٍ شبيهةٍ بما قال. فردَّدتْ الأديبة نادرة سراج الدّين قوله في كتابها عن الرّابطة الأدبيّة، وقال غيرُها مثل قولها في دراساتهم عن الشّاعر.
وقد كانت سعادتي عظيمة حين وقعتُ على نسخة هذا الدّيوان، فاستعنتُ بها فيما أذعتُ من حديثٍ وما أرسلتُ من كتاب، ودفعتُ بها إلى هذه الدّار، لتتمَّ خدمتها، وتكمل يدها، فسارعتْ الدّار مشكورةً لتجعل ذلك بين أيدي قرّائها، ولتقدّمها باقةً على ضريح النّاشر الأوّل الشّاعر الفقيد زهير ميرزا، لتقرَّ روحُه بها في الممات، بعد أن حُرمتْ منها في الحياة.
فإلى روح الشّاعر الشابِّ هذا الورد العبق الذكرى لعمرٍ قصيرٍ عاش كما يعيش الورد، وإلى الشّاعر أبي ماضي وفاء الصّداقة والذكرى.
الدكتور سامي الدهّان
هجرة
شهد النّصف الثاني من القَرن التاسع عشر الميلاديّ المُنصرم أحداثاً في الحياة الاجتماعية والسياسية كان لها الأثر القويّ في جعل هذه الفترة نقطة الانطلاق نحو عصر النّهضة الذي نعيشه الآن.
وما من ريبٍ في أنَّ العصر المظلم (من عام 1516م الى عام 1918 م) الذي جثم فيه الحكم التركيّ على صدر البلاد العربيّة طوال أربعة قرون كان له أبعدُ الأثر في قتل كلِّ موهبة أدبيّة وقتلِ كلِّ فكرة علميّة، حتى عادت الأمّة العربيّة وهي صفْر اليدين من كلِّ أدبٍ وعلم، لولا هذه البارقات التي كانتْ تلوح بين حينٍ وحين مشيرةً إلى امتداد عصر الانحطاط إلى تلك الفترة؛ حتى إذا أطلَّ خديوي مصر “محمد علي” (من عام “1813-1840” وهي الفترة التي حكمت فيها مصر سورية على يد إبراهيم باشا) ومدَّ يده إلى الأمير بشير الشّهابيّ مُتلاقيين في تحالفٍ واتّفاق، وجد السُّوريُّ واللبنانيُّ من ذلك نافذةً يحاول أن يُطلَّ منها على عالمٍ غير عالمه السّابح في دياجير الظّلم والظّلمة، ظانّاً أنَّ في انطلاقه عن بلده انطلاقاً من سجنه الرَّهيب وانفلاتاً من يومه البغيض الكئيب؛ ومن هنا كان الانطلاق الأوّل من سورية ولبنان إلى مصر، وكانت الهجرة الأولى.
ويرى المؤرِّخون المتتبِّعون أنَّ أسباب الهجرة اللبنانية إلى أميركا أكثر من أنْ يُحصيها عدٌّ، وهم مع هذا يُشيرون إلى أهمِّ تلك الأسباب فيرون أنَّ وجود الإرساليات التبشيرية الأميركية من أقوى تلك الأسباب؛ ويرى مؤلفو “الوجيز في الأدب العربي” (1) أنَّ الغرب قد (……” استند في القرون الوسطى إلى الفكرة الصَّليبيّة لاستعمار الشرق، لكنَّ الإسلام كان يردُّه، وبعد فتح أميركا تحوَّلت أساليب الاستعمار من وسائله العسكريّة إلى أساليب دعايةٍ ودسٍّ على الحُكّام المشارقة، مُسلمين وغير مُسلمين، ومُنحتْ كبريات الدول الأوربيّة في الشرق المدارسَ والمستشفيات وبُثَّتْ الجمعيات، حتى غدا لكلِّ مذهبٍ دولة).
ولقد كان نصيب لبنان من هذه البعثات كبيراً، إذ تعهَّد لويس الرابع عشر بتعليم أولاد “الموارِنة” في المدرسة اليسوعيّة بباريس مجّاناً، وأسَّس البابا غريغوريوس الثالث مدرسةً خاصَّةً بالموارنة في روما أخرجت كثيراً من الكهنة والقسّيسين، بعضُهم عاد إلى بلاده ينشر علوم الغرب ويبثُّ محبَّتَه في النّفوس، وبعضُهم الآخر بقي في أوروبا…..”). (عن مجلة الأبحاث اللبنانية – عدد أيلول 1951م).
ومن أهمِّ تلك الإرساليات الجامعة الأميركيّة في بيروت (2) إذ أسَّستْها إرساليةٌ “بروتستانتية” عام 1866م، ثم تَبعتْها جامعة القدّيس يوسف اليسوعيّة في بيروت أيضاً عام 1874م.
ولا علينا إذا أشرنا إلى أنَّ أوَّل مطبعةٍ تأسَّست في لبنان إنَّما كانت مطبعة الجامعة الأميركيّة (نفس المصدر (2))، لأنَّ في ذلك دلالة على الرّسالة التي كان على تلك الإرساليات أنْ تؤدّيها.
ويضيف الأستاذ نصر (في كتابه “النبوغ اللبناني” صدر في حلب عام 1938م) إلى أسباب هجرة اللبنانيين إلى أميركا زيارة إمبراطور البرازيل “الدّون بيدور الثاني” لفلسطين ولبنان عامي 1877م و1887م، إذ يعتبرها فاتحة اتّصالٍ بين لبنان وأميركا؛ وكذلك الثورة العرابيّة التي سبَّبتْ هرب أكثر اللبنانيين من مصر إلى ما وراء البحار (بعد أن نزحوا إليها أيام الاتفاق بين الخديوي محمد علي والأمير بشير الشهابي)، ويأتي السّبب الأخير وهو فقر لبنان، فيقول: “زدْ على ذلك أنَّ كلَّ تحويلٍ ماليٍّ يرسله أحد المهاجرين إلى ذويه، أو كلَّ قصرٍ يشيِّدهُ على سفوح لبنان مهاجرٌ عائدٌ إليه، كان يدفع بعشَرات الشبّان إلى النزوح عن لبنان”.
ولا يفوتنا أن نشير إلى كلمة أوغست أديب باشا في موضوع أسباب الهجرة إذ نراه يقول (في كتابه “لبنان بعد الحرب”) : “السّبب الأوّل في مُهاجَرة الألوف من اللبنانيين الذين في عنفوان العُمر كلّ عام، تلك المُهاجَرة التي خفَّضتْ عدد سكان لبنان إلى ثلاثة أخماسِ ما كان يجب أن يكون في أحوالٍ عاديّة، هو القانون الأساسيُّ الذي وُضِع سنة 1863 وسنة 1864، فإنَّ أشدَّ ضررٍ جلبَه على لبنان، الذي إنَّما وُضِع لأجل نفعه، هو حصرُه ذلك الجبل في حدوده الحاليّة؛ لأنَّه لو كان وضع هذا التّحديد على قاعدة الحقِّ والعدل والسياسة البصيرة، فضُمَّتْ إلى لبنان الأراضي والثغور البحريّة التي هي ملكُه من أوجهٍ كثيرة، لكان القسم الأكبر من تيار هذه المُهاجَرة قد تحوَّل إلى أراضٍ خصبة، هي الآن مُهملة، وإلى مدنٍ عامرةٍ في وسع اللبنانيين أن يُطلقوا العنان لنشاطهم فيها، بل ما كنا رأينا ذلك المشهد المؤلم، مشهد أناسٍ في ضنكٍ شديد من العَيش، يرمون من أعالي صخورهم نظراتِ اليأس إلى مَنْ عند سفح جبلهم من السهول الواسعة الخصبة، التي يُقصيهم عنها اختلالُ الأمن واستبداد الحكّام العثمانيين ومرض الارتشاء (الرشوة) المنتشر فيها.
وسببٌ اقتصاديٌّ آخر لهذه الهجرة، هو امتلاك أصحاب الإقطاعات الأراضي الزراعيّة في الجبل، فقد كان الفلاّح اللبنانيّ أحياناً، خصوصاً في القَرن الماضي وفي مُستَهلِّ هذا القَرن، عرضةً لظلم صاحب الأرض من أصحاب الإقطاعات، يستبيح هذا أتعابه، ويصدُّه عن التقدُّم في المجتمع، فكان هنالك التفاوت من الوجهة الاقتصاديّة وعدم المساواة من الوجهة الاجتماعيّة.
ويذكر الأستاذ محمد يوسف نجم (في كتابه “القصة في الأدب العربي الحديث”)، دافعاً آخر للهجرة هو “الدّافع السياسي، وهو ضغط حكومة الأستانة على رعاياها ولاسيَّما غير المسلمين منهم. والسبب في ذلك أنَّها بضعفها وتهالكها آونة ذاك كانت تخشى كلَّ حركة تحريريّة تبدو بوادرها بين الشعب وتحاول خنقها في المهْد؛ لذلك كانت تأخذ بالشُّبهة وتُجرِّم البريء لأضعف الشكوك، ممّا جعلهم يحاولون زحزحة عبء هذا الضغط عن كواهلهم بالمُهاجَرة إمّا إلى مصر، حيث مجال العمل أوسع وأكثر إظهاراً للكفاءات، وحيث يتمتَّع الناس بحريّة أكثر، أو إلى أوربا أو أميركا حيث يتنشَّقون عبير الحريّة المُنعش”.
هذا بعض رأي الذين يُعنَون بشؤون التاريخ في أسباب الهجرة. ولعلَّه من الواجب أن نسأل الشّاعر عن أسباب هجرته، لأنَّه واحدٌ من هذه الآلاف التي نزحتْ عن ديارها لتستقرَّ في أرض الثّراء الموعود، وإنّا لنجد الجواب عند الشّاعر الكبير، إذ نراه يتحدَّث عن وطنه – لبنان- في قصيدة مطوَّلة فينعي عليه أنَّه رازحٌ تحت أعباء الاستكانة إلى الشقاء وعدم التطلُّع إلى العلاء، وأنَّه كالعبد الذي ألِفَ العبوديّة والذلّ فما هو بتاركهما أبداً، وأنَّه يئد المُصلحين ويكتم أنفاس الأحرار، ويخنق صوت الأديب ويُعلي شأن الجاهل، وأدهى الدّواهي ـ بالنسبة للشاعرـ هذه الطائفيّة البغيضة التي فرَّقتْ الأمّة ومزَّقتها شرَّ مُمزَّق …..
استمع إليه وهو يبيِّن لنا ما كان عليه وطنه أيَّام نزح عنه:
وطنٌ أردناه على حُبِّ العُلا فأبى سوى أنْ يستكينَ إلى الشّقا
كالعبد يخشى, بعد ما أفنى الصِّبا يلهو به ساداته ، أن يُعتقا
أو كلَّما جاء الزَّمانُ بمُصلحٍ في أهله , قالوا: طغى وتزندقا ؟
فكأنَّما لم يكفِه ما قد جنَوا وكأنَّما لم يكفِهم أنْ أخفقا
هذا جزاءُ ذوي النُّهى في أُمَّةٍ أخذ الجمودُ على بنيها مَوْثِقا
وطنٌ يضيق الحُرُّ ذَرْعاً عنده وتراه بالأحرار ذَرْعاً أضيقا
ما إنْ رأيت به أديباً موسِراً فيما رأيت , ولا جهولاً مُمْلِقا
مشت الجهالةُ فيه تسحبُ ذيلَها تِيهاً , وراح العلْمُ يمشي مُطرِقا
أمسى وأمسى أهلُه في حالةٍ لو أنَّها تعرو الجماد لأشفقا
شعبٌ كما شاء التّخاذل والهوى مُتفرِّقٌ ويكاد أنْ يتمزَّقا
لا يرتضي دينَ الإلَهِ مُوفِّقاً بين القلوب ويرتضيه مُفرَّقا
كلِفٌ بأصحاب التعبُّد والتُّقى والشرِّ ما بين التعبُّد والتُّقى
ونراه في قصيدةٍ أخرى يُشير إلى هذه “البأساء” التي عليها وطنه، فيقول:
أرضَ آبائنا عليكِ سلامٌ وسقى الله أنفسَ الآباء
ما هجرناكِ، إذ هجرناكِ، طوعاً لا تظنّي العقوقَ في الأبناء
يسأم الخلد والحياة نعيم أفترضى الخلود في البأساء؟
ويلحُّ على موضوع “البأساء” التي كانت سبب الهجرة فيقول:
شرَّدتْ أهلَك النوائبُ في الأر ضِ وكانوا كأنجمِ الجوزاء
وإذا المرءُ ضاق بالعيش ذَرْعاً ركبَ الموتَ في سبيل البقاء
———————————————
-
هم الدكتور جميل سلطان والدكتور إبراهيم الكيلاني والأستاذ حنا نمر والدكتور ممدوح حقي، وقد خرج الكتاب في طبعتين، كانت الثانية على يد دار اليقظة العربية في أواخر سنة 1946 م.
-
يحسن الرجوع في هذا الموضوع إلى البحث القيم الذي وضعه الأستاذ محمد يوسف نجم ونشره في كتابه “القصة في الأدب العربي الحديث” طبعة القاهرة 1952م ص 16-20.
الشاعر
هبط الشاعر مصر وله من العمر أحدَ عشر عاماً أو تزيد قليلاً (1) وتعاورتْ عليه حاجات الحياة اليوميّة من طعامٍ وشراب، وحاجات الحياة العقليّة من علمٍ ودرسٍ إذا به ينصرف لهما معاً فيعمل ويدرس، ويستغرق ذلك منه قُرابةَ ثماني سنوات كان يقرضُ خلالها بعض الشعر، جمعه في شبه ديوان أسماه “تذكار الماضي” وطبعه في الإسكندرية، وكيفما دار الأمر – كما يقول الاستاذ الجاحظ – فإنَّنا نجد الشاعر وقد أنفق من عمره تسعة عشر عاماً قبل أن يشدَّ رحاله إلى أميركا: ويبدو أنَّه لقي بعض التعب أيّام إقامته في مصر، بل بعض الضَّيم الذي كاد أن يلامسه، وفي ذلك يقول:
نأى عن أرض مصر حذارَ ضيمٍ
ففرَّ من العذابِ إلى العذاب …..
على أنَّه عندما يذكر مصر إنَّما يذكر فيها صَحْباً طيّباً وفيّاً محضَه الودَّ خالصاً.
ويذكر الاستاذ نجدة صفوة أنَّ إيليا أبا ماضي رحل إلى مصر “ليتعاطى التجارة”، وقد اتخذ لنفسه محلاًّ يبيع فيه السّجائر والدّخان وأخذ يستغلُّ أوقات فراغه في المُطالعة والدراسة ونظم الشِّعر الذي أظهر فيه منذ صغره قابليةً تُنبئ بمستقبله. ووقع عليه الأستاذ أنطون الجميّل فرآه يكتب شعراً في الدُّكان، فقرأه وأُعجِبَ به ونشرَه في مجلّة “الزّهور” التي كان يصدرها …..
ويذكر لنا الشاعر بإسهابٍ، في قصيدته “الميميّة” شيئاً هاماً عن إقامته في مصر، فيتوضَّح لنا منها ذاك الحنين الصّامت لأيّامٍ جميلةٍ قضاها هناك، ويتوضَّح ـ إلى جانب ذلك ـ ذاك اليأس من الناس، مما يدلُّنا على حالة التناقض التي كان عليها إبّان إقامته في مصر؛ فلنستمع إليه متحدِّثاً عن ذكرياته في مصر وعن أخلاق النّاس في مصر أيضاً …يقول:
ليسَ الوقوفُ على الأطلالِ من خُلُقي
ولا البكاءُ على ما فاتَ من شيَمي
لكنَّ (مِصْراً) وما نفسي بناسيةٍ
مليكة الشرق، ذات النّيلِ والهرَمِ
صرفتُ شطرَ الصِّبا فيها فما خشيتْ
نفسي العِثارَ، ولا نفسي من الوصمِ
في فتيةٍ كالنّجوم الزّهرِ أوجهُهم
ما فيهم غير مطبوعٍ على الكرَمِ
لا يقبضون مع اللأواء أيديهم
وقلَّما جادَ ذو وفرٍ مع الأزَمِ
فمن هنا يتبيَّن لنا بعضُ حال الشّاعر أيام إقامته في مصر، فهو إذ يذكرها يجدها “مليكة الشرق”، وهو بالتالي قضى فيها شطر الصِّبا، وكان مستريحاً إلى الفترة الثانية التي قضاها هناك، فهو يقول: “ما خشيتْ نفسي العِثار”، حتى إذا ذكر صحبه وأخدانه لمع فيها المديح، “فما فيهم غير مطبوعٍ على الكرَمِ”…..
ولعلَّ هذه القصيدة خير “وثيقة” عن حياة الشاعر في مصر، لأنَّه لا يكتفي بهذا الذي قاله، وإنَّما يستمرُّ في مدح مصر طوال خمسة عشر بيتاً يصوِّر مصر خلالها بأنها دُرَّة تاج الشّرق، وحاملة علم الشّرق، أما أهلوها:
هيهاتَ تطرِفُ فيها عينُ زائرِها
بغير ذي أدبٍ أو غير ذي شمَمِ
وهم إلى جانب أدبهم وشممهم:
أحنى على الحُرِّ من أمٍّ على ولد
فالحُرُّ في مصر كالورقاءِ في الحرَمِ
على أنَّه رغم هذا الذي لقيَه في مصر فقد نزح عنها إلى أميركا، ولم يعرف ما كان عليه من نعيمٍ مقيمٍ حتى وصل مهجره، وهناك أدرك الخطيئة التي ارتكبها بالرّحيل عن مصر، ويصف هذه الخطيئة بأنها “ضِلَّةٌ” فيقول:
ما زلتُ والدَّهر تنبو عن يدي يده
حتى نبَتْ ضِلَّة عن أرضها قدمي!!
مما يدلُّنا من أنَّه كان “مُرتاحاً” خلال إقامته في مصر، ويؤكِّد ذلك ما أوردناه من احتفاء الأستاذ أنطون الجميِّل به واهتمامه بشعره ونشره قصيدة له في مجلة “الزهو”.
وفجأةً وعلى غير انتظار، نجده وقد أخذ سَمْتَه شطر “أميركا”، ولعلَّها كانت مطمح أنظاره يوم اتّجه من لبنان، وإذا أحببنا أنْ نتقصَّى سبب هجرته إلى مصر ومنها إلى أميركا أمكننا أن نجد سببين، فأمّا الأوّل فهو أنَّ الهجرة من لبنان إلى مصر كانت سهلةً ميسورة، في حين أن المهاجرة عن لبنان إلى أميركا لم تكن ميسورة. ويرى الأستاذ فيليب حتِّي في كتابه “السوريّون في الولايات المتّحدة” أنَّ الحكومة العثمانية آنذاك منعت الهجرة إلى أميركا ورفضت إعطاء جوازات السفر للمهاجرين السوريّين إليها، فكان لا بُدَّ لهم من الحصول على الجوازات للمرور بها إلى مصر، ومصر هي التي كانت مركز انطلاق المهاجرين إلى أميركا. إذن يمكن أنْ نرُدَّ سبب هجرته إلى أميركا إلى أنَّها هي التي كانت هدفه وسلك إليها سبيل مصر كمرحلةٍ أولى. وأمّا السبب الثاني فهو ما ورد في قصيدته الآنفة الذِّكر من يأسٍ من خُلُق الناس، فلعلَّه كان يقصد مصر، فلما توهَّم أنَّها ضاقتْ به وضاق بها، وفشلتْ تجارته، وجد أنَّ الرّحيل أولى به، فاتّجه إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة ليستقرَّ في مدينة “سنسناتي” بضعة أعوامٍ، عمل فيها بالتجارة، حتى إذا أطلَّتْ سنة 1916 انتقل إلى “نيويورك” حيث اجتمع إلى جبران خليل جبران وميخائيل نعيمه ونسيب عريضة ورشيد أيّوب ووليم كاتسفليس وعبد المسيح حدّاد وندرة حدّاد وأضرابِهم ليؤلِّفوا جميعاً فيما بعد هذه الرّابطة التي أطلقوا عليها اسم “الرّابطة القلميّة” والتي كان لها فضل نشر مذهب المهاجرين في الأدب والإعلام عن مدرسةٍ أدبيّةٍ لها خطرُها، والتي يقول فيها الدكتور محمد حسين هيكل: “يجب أن يتعاون المُجدِّد والمقلِّد منا، وإلا بقي الفوز في جانب السوريّين المتأمركين وامَّحت الثقافة الاسلامية”. (عن مجلة السياسة الاسبوعية – العدد 402 عام 1930القاهرة).
——————————————
-
يمكن لنا أن نقدر أنه ولد في لبنان حوالي1891 في قرية “المحيدثة” ورحل إلى مصر عام 1902 ومنها إلى أميركا عام 1911م. ارجع إلى “بين شاعرين مجدّدين” لعبد المجيد عابدين – مصر 1952م، وكذلك إلى “حديث الأربعاء” لطه حسين ج 3 ص193. وكذلك إلى كتاب “إيليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر” لنجدة فتحي صفوة – بغداد 1945م.
*******
مصادر ثقافة الشاعر
إذا أحببنا أن نعلم شيئاً عن ثقافة الشاعر لم نجد من المصادر بين يدينا إلّا شعره فهو وحده الذي يدلُّنا على منابع ثقافته، ولابدَّ لنا بالتالي أن نستقرئ شعره من جانبين: جانب المعنى، وجانب المبنى. فمن معانيه نتلمَّس ثقافته الفكريّة، ومن مبانيه نتلمَّس ثقافته اللغوية.
وممّا لا ريبَ فيه أنَّ ثقافة الشاعر تختلف من سنٍّ إلى سنّ، فكلَّما ضرب بسهمٍ في العمر وممارسة النَّظْمِ والتمرُّس بالحياة وجدنا ألواناً من الثقافة تتباين بتباين سني النَّظم، فإذا حاولنا أن ننظر في دواوين شعره ـ على اعتبار أنَّها المراحل التي تُنبئ عن تطوّر ثقافته ـ لزِمَنا أن نكون على علمٍ بما أسماه ديوانه الأوّل “تذكار الماضي” الذي نشره في الإسكندرية أيام إقامته في مصر -، فإذا جُزْنا هذه المرحلة ووقفنا على ديوانه الثاني المُسمَّى “ديوان ايليا أبي ماضي – الجزء الثاني -” (طبع في نيويورك سنة 1918)، حقَّ لنا أن نُطيل الوقوف وأنْ نُقدِّم أكثر قصائد هذا الديوان كنماذج لما نذهب إليه في هذه الدّراسة، ثم نُطلُّ على المجموعة الشعرية الثالثة للشاعر وهي “الجداول” (صدرت في نيويورك عام 1927) فنقتبس منها قصيدتها الكبرى “الطّلاسم” ونستقرئها ثقافة الشاعر ونثبتها كنموذج في هذه الدراسة، ثم نعرج على المجموعة الرابعة وهي “الخمائل”(1) فنقتطف منها القصيدة الأمّ وهي “الحكاية الأزليّة”، ثم نفتّش عما تبعثر من شعر الشاعر في المجلّات السائرة، وخاصّةً “العُصبة” فننقل عنها بعض شعر الشاعر الأخير، فإذا اكتمل ذلك بين يدينا – وقد اكتمل – حقَّ لنا أن ندرس ثقافة الشاعر في جميع مراحل حياته المتمثلة في هذه المجموعات الأربع.
————————————-
1- صدر في نيويورك في حدود عام 1940 . ثم طبع عدة طبعات في الشرق أشهرها طبعة بيروت 1940 . ويقول الاستاذ الناعوري في كتابه ” إيليا أبو ماضي” ص 12 ( …. ولا غرابة أن يتردد اسم صاحب “الجداول ” في الوطن والمهجر بملء الإعجاب ، وفي أن يتبارى الناشرون في طبع ديوانه وتوزيعه عدة مرات بغير استئذان المؤلف – وهو ما لا نعرف وقوعه بهذاالشكل عند العرب قبل ديوان “الجداول ” – فتنفذ جميع نسخه حال ظهورها في الأسواق ) ا ه
*******
ملامح
اقرأ معي قول الشاعر:
أنا ما وقفتُ لكي أشبِّب بالطِّلا ما لي وللتشبيب بالصَّهباءِ
لا تسألوني المدح أو وصف الدُّمى إنّي نبذتُ سفاسف الشُّعراءِ
باعوا لأجل المال ماءَ حيائِهم مدحاً وبتُّ أصون ماءَ حيائي
لم يفهموا بالشِّعر إلّا أنَّه قد باتَ واسطةً إلى الإثراءِ
فلذاك ما لقيتُ غير مشبِّبٍ بالغانيات، وطالبٍ لعَطاءِ
ضاقتْ به الدُّنيا الرَّحيبة فانثنى بالشِّعر يستجدي بني حوّاءِ
شقيَ القريضُ بهم وما سعدوا به لولاهمُ أضحى من السُّعَداءِ
تجد أنَّ الشاعر قد نبذ من أغراض شعره “المديح” و “وصف الدُّمى” و “التّشبيب بالغانيات”، أو هكذا يوضِّح جملة رأيه فيما يريد أن يأخذ به نفسه في منظومه، فهو بهذا قد وضع الإطار العامّ لشعره على وجه التقريب.
ونحن إذا حاولنا أن ننظر في شعره لنرى “المدرسة” التي تخرَّج منها نجد الشاعر وقد عاش في إطار من الشِّعر القديم، والجوِّ القديم، والطّابَع القديم (1)، لا يكاد يخرج منه، أو لا يكاد يقوى على الخروج منه. وآية ذلك هذا الشعر الذي بين أيدينا.
وإذا أحببنا أن نخرج مع الشاعر من لبنان ونعيش معه حياته الأولى في مصر، توضَّح لنا – من الذين قُدِّر لهم أن يطَّلعوا على مجهوده الأول المُسمَّى “تذكار الماضي”، تلك المجموعة، التي كانت باكورة إنتاجه – أنَّ الشاعر كان ضعيف الثقافة، ضعيف التّحصيل، ضعيف الاطّلاع على مفردات اللّغة، ضعيف الإلمام بقواعدها وأدواتها أيضاً.
ومن هنا يبدو لنا أنَّ الشاعر نزح عن لبنان وهو على شيء من العلم بالقراءة والكتابة، ثم أخذ يُطالِع لنفسه مُطالعاتٍ خاصّةً يلصُّها من بعض فراغ يومه كوَّنتْ عنده لوناً من ألوان الثقافة التي تتيح له أن يكتب بلغة سليمة بعض الشيء (2).
حتى إذا كان ارتحاله عن مصر إلى أميركا وجدناه وقد أخذ نفسه بشيءٍ قليلٍ من القسوة، وبشيءٍ كثيرٍ من المَرانة حتى استقامت له أداة الكتابة. فلما أخرج ديوانه الثاني – الذي اقتبسنا أكثره في هذه الدراسة – وجدنا لديه من آثار ثقافته اللغوية والنحوية ما هو جديرٌ بالتدوين.
*****
ليس من اليسير البحث في الشعراء الذين طالع أبو ماضي شِعرهم وأُغرم به واستقى منه نفَسَه الشِّعري أيام نشأته الأولى، وإنْ كُنّا لا نعدم وجهاً من وجوه الرأي نشير فيه إلى أنَّه تتوضَّح لنا خلال شعره نفحتان دخيلتان، كما تتوضَّح نفحةٌ ثالثة أصيلة، فإذا كنّا نرى نفحة نُوَاسيَّة في بعض شعره (كما في قصيدته “يا صاح”)، حاول فيها أنْ يتتلمذ على يديّ أبي نُوَاس من حيث طابَعه الشِّعري ومن حيث صوره و”تلويناته” فإننا نرى له أيضاً انصرافاً إلى أبي العلاء، يريد أن يجعل من شعره النّموذج الذي يحتذيه (3).
فاستمع إليه في قصيدة “يا صاح” تجد أبا نُوَاس يطلُّ عليك من “بعض” أبياتها:
يا صاحِ كم تفاحةٍ غضَّةٍ يحملُها في الرَّوضِ غصنٌ رطيبُ
….. ….. .….
ورُبَّ صفراء كلَونِ الضُّحى ينفي بها أهل الكروبِ الكروبُ
دارتْ على الشربِ بها غادةٌ كأنَّها ظبيُ الكناسِ الرّبيبُ
في طَرْفك السّاجي هيامٌ بها وبينَ احشائِك شوقٌ مذيبُ ….
على أنَّ هذا لا يخرجها من شعر الشاعر ومن غريرته، مثلها كمثل جميع القصائد، فهي وإنْ كانت من “عمل” الشاعر نفسه إلّا أنَّ لها أصولاً يمكن أن تُرَدَّ إليها، وكلُّ شاعرٍ في نشأته الشِّعرية الأولى يحاول أن يجد أستاذاً يتتلمذ عليه ويأخذ عن فمه ألف باء الأدب والبيان (4).
وإنك لواجدٌ إلى جانب هاتين النفحتين نفحات متفرِّقة لأعلام الشِّعر العربيّ في مختلف عصوره، فأبو ماضي لم يبتدع أول الأمر مدرسة من مدارس الشِّعر، ولم ينسج على منوالٍ مُتفرِّدٍ، وإنَّما جرى في حَلْبَةِ المُقلِّدين وجاراهم في تقليدهم فكان منه ذاك الشاعر الناشىء الذي أخرج للناس ما أسماه “تذكار الماضي” ثمَّ تدرَّج في التقدُّم حتى أخرج للناس ديوانه الثاني، ويمكن لنا بكلمةٍ واحدةٍ أن نقول: لقد كان أبو ماضي يعيش بجسمه في القرن العشرين بينما يعيش بعقله وفكره في العصور العبّاسيّة السّحيقة.
ومظاهر التقليد هي “مصادر ثقافته” في مُستهلِّ حياته الأدبيّة من حيث المبنى، لذا فإنَّنا نجد عنده مثلاً أمثال هذه المطالع:
قال في سقوط “أرضروم”:
أعِدْ حديثَك عندي أيُّها الرَّجل وقُلْ كما قالت الأنباء والرُّسلُ
وقال في قصيدة “1916”:
كمْ قبلَ هذا الجيل ولَّى جيلٌ هيهات ليس إلى البقاءِ سبيلُ
وقال في “ما للكواكب”:
شوقٌ يروح مع الزمان ويغتدي والشّوقُ إنْ جدَّدته يتجدَّد
وقال في “لمَن الدّيار”:
لمَن الدّيارُ تنوحُ فيها الشّمائلُ ما ماتَ أهلوها ولم يترحَّلوا
وقال في “دموعٍ وتنهُّدات”:
ألا ليتَ قلباً بين جنبيَّ دامياً أصابَ سلوّاً أو أصابَ الأمانيا
وقال في “العيون السُّود”:
ليتَ الذي خلقَ العيونَ السُّودا خلقَ القلوبَ الخافقاتِ حديدا
وقال في “إلى صديق”:
ما عَزَّ مَنْ لمْ يصحب الخَذَما فاحطمْ دواتَك واكسر القلَما
فأنت في مثل هذه الأمثلة التي قدَّمتُها لا تجد كبير عناءٍ في ردِّ الأبيات إلى قصائد معروفةٍ في الأدب العربيّ القديم، ممّا يبيّن لنا أنَّ ثقافة الرّجل ـ من حيث شعره ـ كانت تعتمد التقليد أول الأمر، وكأنَّه أخذ به نفْسَه ليسلس له القياد وتنقاد له الألفاظ والتركيبات التي تناسب الشِّعر، فإذا فرغ من هذه المرحلة وجدتَ له مطالع على غايةٍ من الجمال والإبداع الشخصيّ.
ولم يقف تقليده عند هذا الحدِّ الذي ذهبنا إليه وإنَّما اتَّجه إلى تقليد الموشَّح الأندلسيّ بمختلف أشكاله وألوانه، وتجده يعالج في الموشَّح موضوعاً من الموضوعات الوطنيّة الكبيرة، فاستمع إليه في موشَّح “أمَّةٌ تفنى وأنتم تلعبون”:
أعَلى عَيني مِنَ الدَمعِ غِشاء
أَم عَلى الشَّمسِ حِجابٌ مِن غَمام
غاضَ نورُ الطَّرفِ أَم غارَت ذُكاء
لَستُ أَدري غَيرَ أَنّي في ظَلام
*****
ما لِنَفسي لا تُبالي الطَّرَبا أَينَ ذاكَ الزَّهوُ أَينَ الكَلَفُ
عَجَباً ماذا دَهاها عَجَباً فَهيَ لا تَشكو وَلا تَستَعطِفُ
لَيتَها ما عَرَفَت ذاكَ النَبا فَالسَّعيدُ العَيشِ مَن لا يَعرِفُ
لا اِبتِسامُ الغيدِ لا رَقصُ الطِّلاء
يَتَصَبّاها وَلا شَدوُ الحَمام
بِالكَرى عَنّي وَبي عَنهُ جَفاء
أَنا وَحدي أَم كَذا كُلُّ الأَنام
*****
وكذلك موشَّحه “مصرع القمر” ومطلعه:
تركتْ هذه الضّلوع رمادا
لوعةٌ في الضّلوعِ مثلَ جهنَّم
وموشَّحه “1914” ومطلعه:
طُوِيَ العامُ كما يُطوى الرَّقيم
وهوى في لُجَّةِ الماضي البعيد
وموشَّحه “البلبل السّجين” ومطلعه:
يا رُبَّ ليلٍ بلا سناءٍ كأنَّما بدرُه يتيم
وموشَّحه “الخلود” ومطلعه:
غلطَ القائلُ إنّا خالدون كلُّنا بعدَ الرَّدى هَيّ بنُ بَيّ
فالشاعر في جميع هذه المراحل يحاول جاهداً أن يتلمَّس طريقه؛ فقد حاول أن يأخذ بأسباب القصيدة القديمة من حيث فخامة ألفاظها وضخامة مطالعها، ثم عمد إلى الموشَّح فعالجه بشيءٍ من القدرة والتمكُّن ومارس فيه الموضوعات التي لم يُخصَّص لها الموشَّح، ومع ذلك فقد أخضع الموشَّح لهذا اللَّون من ألوان التعبير عن مثل هذه الأفكار. فثقافة الشاعر في مرحلة نشوئه إنَّما كانت ثقافةً تتكئ على التقليد لتتحسَّس طريقها إلى أسلوبها المُتميّز الذي سيُعرَفُ لها فيما بعد.
وكما أنَّ دوواين الشعراء القُدامى كانت بين يدي أبي ماضي وتحت بصره يلقف منها ما يلقف ويترك منها ما يترك دون أن يُحاكيها محاكاةً تُذهِبُ شخصيَّتَه الأدبيّة – مع عدم تبلورها آنذاك – فقد كان يمارس أساليب القرن الرّابع الهجريّ وعصر الدول المتتابعة من حيث الصياغة، فتراه يحاول جاهداً أن يُلبِس شعره ثوب الصّنعة البديعيّة التي تميَّزت بها هذه العصور بعد أن ضَحَلت الأفكار فيما بعد وعاد الإنتاج الأدبيّ كلّه من باب الاجترار.
فأنت تجد لأبي ماضي مثل هذه الأبيات في قصيدته “عصر الرّشيد”:
أيّامٌ تحسدُها “العواصمُ” مثلما
حسَدَ “العواطلُ” أختَهُنَّ “الحاليهْ”
فهو قصد إلى هذا الجناس غير التامِّ “العواصم” و”العواطل” كما قصد إلى هذا الطباق الإيجابيّ “العواطل” و”الحالية”، ثم يقول:
مَلِكٌ أَدالَ مِنَ “الجَهالَةِ” “عِلمُهُ”
وَأَذَلَّ صارِمُهُ المُلوكَ العاتِيَه
وَمَشَت تُطَوِّفُ في البِلادِ هِباتُهُ
تَغشى “حَواضِرَها” وَتَغشى”البادِيَه”
مَلَأَ البِلادَ “عَوارِفاً” وَ”مَعارِفاً”
وَالأَرضَ عَدلاً وَالنُفوسَ رَفاهِيَه
فَتَحَضَّرَ البادونَ في أَيّامِهِ
وَاِستَأنَسَت حَتّى الوُحوشُ الضَّارِيَه
أَعطاهُمُ صَرفُ “الزَّمانِ” “زِمامَهُ”
أَمِنوا وَما أَمِنَ الزَّمانُ دَواهِيَه
فأنت تلمسُ أنه قصد هذا اللّون من ألوان البديع، وعمد إليه وأراده، كأنَّما أراد أن يقتفي آثار مَنْ عنوا بهذه الصَّنعة.
ويقول في موطنٍ آخر:
أمسى سواءً “ليلُه” و”صباحُه”
شتّانَ بينَ “الصُّبحِ ” و”الإمساءِ”
ويقول:
بنتُ كَرْمٍ لم يَهِمْ فيها سوى
كلِّ صَبٍّ هامَ فيه الكرمُ
ويقول:
فما “يلمُّ” بمَنْ صافاهمُ “ألمٌ”
ولا ” يدوم “لمَنْ عاداهمُ” أملُ”
في جَفنِه أرَقٌ، في نفسِه فرَقٌ
في جسمِه سقَمٌ، في عقله دخَلُ
ويقول من باب المجاز اللّغوي:
حمل الشّمس إلينا قمرٌ
في سماءٍ نحنُ فيها أنجُمُ
وإلى جانب عنايته بالصَّنعة البديعيّة من حيث هذا الطباق وذاك الجناس، ثم عنايته بالمجاز وما اتصل به، نجده كان يعتمد “التضمين” فيُضَمِّنُ شعره آياتٍ من القرآن الكريم أو تعبيراتٍ مشتقّاتٍ منه، على طريقة عصر “ابن العميد” أو عصر “الدول المتتابعة” إن لم نردّ هذا العصر إلى عصر بني بويه في أعمق جذوره.
وإذا كان هذا “التضمين” يدلُّنا على شيء فإنَّما يدلُّنا على تلوُّن ثقافة الشاعر بلونٍ يحاول فيه استعارة أسلوب القرآن الكريم، وسنفتقد هذا اللّون الجميل من شعره فيما بعد عندما تتبلوَر شخصيته ويعيش في أفق “الرّابطة القلميّة” التي كانت تُعنى بكلِّ شيءٍ إلا بالصَّنعة والأسلوب الكتابيّ.
أمّا “تضميناته” فقد قال في حديثه عن حكومة لبنان:
راحتْ تناصِبُنا العدَاءَ كأنَّما
“جئنا فريّاً ” أو “أتينا مَوبقا”
ويقول في مصير بغداد:
واجتاحَ مُجتاح العُروش ملوكَها
“فكأنَّهم أعجازُ نَخْلٍ خاويهْ”
أينَ القصورُ الشّاهقاتُ وأهلُها
بادَ الجميعُ” فما لهم من باقيهْ”
ثمَّ يتحدَّث عن الناس في العراق الآن بعدَ هارون الرّشيد فيقول:
مُستسلِمونَ إلى القضاءِ كأنَّما
أُخذوا ولمّا يُؤخذوا بالغاشيهْ
ثم يقول في موطنٍ آخر:
ما بالُ قومي كلَّما استصرختُهم
“وضعوا أصابعَهم على الآذان”
والأمثلة على ذلك متوفِّرة لمَنْ يريد أن يستقصيها في شعر الشاعر أيّام نشأته الأولى. وإذا تقدَّمتْ بك المطالعة إلى الجداول والخمائل فإنك لن تجدَ هذا اللَّون واضحاً، لأنَّ الشاعر استطاع الانفلات من القيود التي رسف في أغلالها ردحاً طويلاً من الزمن استغرق فترة نشوئه وتكوُّنه بتمامها وكمالها؛ حتى إذا وصل إلى أميركا وانصرف قليلاً قليلاً عن الشّرق وأجوائه ألفى نفسه في جوٍّ جديد كلَّ الجِدَّة، ووجد حوله زمرةً من الذين يمارسون الكتابة والنَّظْم، ولم يجدْ في منثورهم ومنظومهم ما وجده في منثوره ومنظومه، فحاول شيئاً فشيئاً التخلُّص من التقليد، ومن هنا يتلامح لك بعض الشِّعر الرّائع الممتاز حتى في ديوانه الثاني الذي نحن بسببه؛ وأشهر ذاك هذه القصيدة الرّائعة “لم أجدْ أحداً” و”فلسفة الحياة” و”ابنة الفجر” وأشباهها.
ومن جملة ما تقدَّم نستدلُّ على أنَّ مصادر ثقافته من حيث الطريقة كانت تمتُّ بأوشج الأواصر إلى مدرسة “الصَّنعة” في مُستهلِّ نشأته الأدبية، ثم نجد هذه الصَّنعة وقد ضاعت في زحمة الصّوَر التي أخذ يزخر بها شعر الشاعر عندما انتقل من فترة المَرانة والتّقليد إلى مرحلة الابداع والتبلور عندما انتسب لمدرسة “الرابطة القلميّة” وكان علَمَاً من أعلامها.
أمّا ثقافته اللغويّة والنّحْويّة في هذه الفترة، التي كان يخضع فيها لمراحل التكوُّن، فلم تكن لتُرضي أصحاب اللغة أو ترضي أصحاب النَّحو(5)، وكلُّ مَن التمس العيوب وجدَها. على أنَّ في بعض ما أحصيناه على الشاعر بعض الدلالة على ثقافته اللغويّة والنحويّة.
ولا علينا أن نشير إلى مذهبه في اللغة ونظرته إليها من خلال شعره؛ فاقرأ معي قوله في مطلع ديوانه الجداول (وهو مُحصِّلة شعره ورأيه نظراً لتأخُّر صدوره عن الجزء الثاني):
لستَ منّي إنْ حَسِبـْـــــــــتَ الشِّعر ألفاظاً ووَزْنا
فالشّاعر بهذا يُدَلِّلُ على عدم عنايته باللفظ – ناهيك عن الوزن -، فهو بالتالي مُهمِلٌ للَّفظ لا يحفل له ولا يوليه شيئاً من عنايته، ممّا جعل الدكتور طه حسين يُعقِّبُ على ذلك تعقيباً قاسياً فيقول: ” … فأمّا إذا قصدنا إلى نقد هذا الديوان – يقصد الجداول – من جهة ألفاظه وأوزانه، فنحن بعيدون كلَّ البُعد عن مثل هذا الرضى، ونحن مضطرون إلى كثيرٍ من التحفُّظ، وإلى كثيرٍ من السُّخط، وإلى كثيرٍ من الضَّحك أحياناً ….” ويقول بعد في حديثه عن قصيدة “الأشباح الثلاثة” من ديوان الجداول (في الجزء الثالث من كتابه ” حديث الأربعاء”): “…. وستلاحظ في الوقت نفسه شيئاً من فساد النَّحو عند الشاعر يُغنينا عن أن نضرب لك الأمثال ممّا في الديوان من خطأ لا يُحتَمل من شاعرٍ مُجيد …” ثمَّ يتابع قوله في شيءٍ من التّعميم: “ومصدر هذا كلِّهِ أنَّ الشاعر لا يُحسِن علم الألفاظ والأوزان، وهو يريد مع هذا أن يقول الشعر..”..
ولستُ أجد مُبرِّراً لهذا التّعميم الذي أصدره الدكتور طه حسين في الحكم على ألفاظ الشاعر ومدى إحاطته بعلم النَّحو: أإذا ندَّتْ عن الكاتب أو الشاعر خطيئةٌ أو خطيئاتٌ في اللغة والنَّحو حقَّ لنا أن نُطلق القول على هذه الشاكلة فنتَّهمَ الرجل في لغته وفي نحوه وفي أوزانه فنقول: “…. الشاعر لا يُحسِن علم الألفاظ والأوزان” (6).
على أنَّ ممّا لا شُبهةَ فيه أنَّ لغة الشاعر لم تكن سليمةً كلَّ السلامة أول نشأته الأدبيّة وحتى بعد أن أصدر ديوانه الثاني، ولم تكن بالتالي فاسدةً كلَّ الفساد، وإنَّما كانت سليمةً لا تخلو من خطيئاتٍ تدَلُّ على عدم تمكُّن الشاعر من لغته؛ فنجد عنده مثل هذه الهفَوات النحويّة واللغويّة:
الطّود يقرأ في السّماء الصافيه
سِفْراً جميلٌ شكلُه والحاشيه
فرفع جميلٌ وحقُّها النَّصْبُ على أنَّها صفة لسِفْر.
ثمَّ:
ليطربَ مَنْ شاء أن يطربا فلستُ بمُستمطرٍ خُلَّبا
فحقُّ “يطرب” أن تجزم بلام الأمر، ولكنَّك إنْ جزمتَها بالسّكون أفسدتَ البيت وزناً، وإنْ حرَّكتَها أفسدتَ البيت نحواً، لأنه لا مجال للتحريك ولا داعي له، فالتمسنا له عذراً بأنْ حرَّكناها بالفتح على الإتباع، إلحاقاً بحركة الميم في “مَنْ ” التي تلَتْها …
وتجد أيضا:
الحشْدُ ملءُ الدارِ لكنْ لم يرَ أحداً سواها
فحقُّ فعل “يرى” أن يُجزم بـ “لم” وتحذف بالتالي ياؤه؛ ولكنك إنْ فعلت ذلك ـ كما فعله الشاعر- وقعتَ في إفسادٍ لوزن البيت إلا إذا أشبعت فتحة الرّاء، وأنت إذا أشبعتَ فتحة الرّاء ليستقيم لك وزن البيت تظاهر للسامع أنك مخطيءٌ نحواً لأنك لم تجزم بلم، ولم تحذف حرف العلّة. وتتكرّر مثل هذه الحالة مرّات ومرّات في ثني الديوان، وقد تجدها في مثل قوله:
تركتَ النَّجمَ مثلك مُستهاما
فإنْ تسْهُ سها أو نمتَ ناما
كما تجد في “الجداول”:
وحطَّمتُ أقداحي ولمَّا أرتوي
وعففتُ عن زادي ولمّا أشبع
وتجد ضرورة الإشباع في مثل قوله:
إنْ ترَ زهرةَ وردٍ
فوقها للطلِّ قطره
وقوله:
أيا زهرةَ الوادي الكئيبة إنَّني
حزينٌ لِما صرتِ إليه كئيبُ
وقوله:
فتُمسينَ، للأقذارِ فيك ملاعبٌ
وفي صفحتيك للنّعال ضروبُ
وتجد إلى جانب ذلك هذا اللَّون من الحذف الذي لا يُجيزه إلّا الكوفيون على ضعفٍ:
لا يُنجي الشّاة من سَغبٍ
أنَّ في الأرض السُّهى عُشبا
فهو يريد أن يقول: من لا يطيق أن يرى، فحذف “أن” في غير موطن حذفها وتجد هذا في قوله:
فاعملْ لإسعاد السّوى وهنائهم
إنْ شئتَ تسعدَ في الحياة وتنعما
فهو هنا قد وقع في أمرين، أوّلهما أنَّه عاملَ “سوى” معاملة الاسم فأدخل عليها الألف واللام، ممّا لا نعرفه؛ والثاني أنَّه نصب “تسعد” بـ “أن” أضمرها، ليستقيم له نصب القافية معطوفةً على “تنعما”.
ثم كان لا بدَّ لهذا الشاعر الناشئ بعد أن وصل أميركا وعاش هناك، يمارس حياة جديدة بالنسبة إليه، ويمارس أفكاراً جديدة وأساليب جديدة أيضاً، من أن يهتمَّ بلغته ـ كما قلنا ـ ويُعنى بها بعض العناية؛ لذا نجده في الفترة الثانية من حياته في أميركا قد تغيَّر أسلوبه، إذ أضاف إلى مصادر ثقافته ثقافة مدرسة “الرابطة القلميّة”، إذا صحَّ أنه تأثَّر بها ليخرج من الأطُر التي كان يعيش فيها.
ولا بدَّ لنا بالتالي أن نقف وقفةً قصيرةً عند هذه المدرسة المهجريّة الكبيرة التي لمع اسمُها كمدرسةٍ أدبيّةٍ لها خطرُها في الأدب الحديث.
————————
-
“ذلك أن أبا ماضي كان في نشأته مولعاً بنظم الشعر على النهج القديم وله ديوان قديم تأثر فيه بأبي العلاء المعرّي وغيره. ثم انصرف إلى الطريقة الجديدة في نظم الشعر ولكنه لم يستطع أن يتخلص من آثار الماضي فعلقت بذهنه أفكار وعبارات من أساتذته القدماء ومن بينهم “أبوالعلاء” و “بين شاعرين مجددين” لعبد المجيد عابدين.
-
وهذا لا يعيب الشاعر في مثل هذا العصر الذي درج فيه وفي غير ذاك العصر، لأننا نعلم – فيما نعلم – أن الكاتب القدير عبّاس محمود العقاد قد تثقف أول نشأته مثل هذه الثقافة الطائرة يلتقطها مما يقع تحت يده من كتب.
-
نجد ذلك في أكثر شعر التشاؤم المقتبسة منه نماذج لهذه الدراسة. انظر مثلاً قصيدته “1913”. وارجع إلى كتاب “بين شاعرين مجددين” لعبد المجيد عابدين.
-
ولا يخفى أن معظم شعراء النهضة في مصر أيام نزح اليها الشاعر إيليا أبو ماضي كانوا يدينون لمدرسة التقليد، ويحاولون جاهدين أن يجدوا لهم أساتذة من الأدب العربي القديم، ولست تجد شاعراً واحداً استقل برأيه وشعره في مطلع النهضة، كأنما التقليد امتحان للشخصية الأدبية وتمهيد تكوينها. يصدق هذا على اسماعيل صبري والبارودي وشوقي وحافظ.
-
نجده في أكثر الأحيان يميل إلى الأخذ بالقياس حتى على الشاذ الضعيف ، فهو من هذا الجانب ينتسب لمدرسة الكوفة في النحو .
-
ويرى الدكتور طه حسين في كتابه المذكور أن هذا الضعف في لغة المهجر خاصة أصيلة من خصائصه فيقول: “ولكني حائر حقاً في أمر هذا النحو من الشعر وهذا الفريق من الشعراء. قوم منحوا طبيعة خصبة، وملكات قوية، وخيالاً بعيد الآماد، وهم مهيؤون ليكونوا شعراء؟، ولكنهم لم يستكملوا أدوات الشعر، فجهلوا اللغة أو تجاهلوها ثم اتخذوا من هذا الجهل مذهباً”.
*******
الرابطة القلميّة
ازال المهاجرون العرب الذين استوطنوا أميركا في غمرة هذه الهجرة الكبيرة في مطلع القرن العشرين يشعرون بأنَّهم عربٌ رغم “تأمركهم”، ولقد شعروا بالتالي أن عروبتهم مهدَّدةٌ بالانهيار والضياع في تيار الحياة الأمريكية الجديدة التي أخذوا أنفسهم بها، لذا فقد سارع فريقٌ منهم إلى إنشاء المجلّات الأدبيّة والصُّحف اليوميّة لتكون صوتهم والدليل فيما بينهم.
ويقول الأستاذ أنيس نصر (1) “وصل المهاجرون اللبنانيون الأوّلون إلى أميركا منذ قرنٍ كاملٍ تقريباً لا يحملون مالاً ولا يفهمون لغة البلاد التي نزلوا فيها ولا يعرفون شيئاً عن أحوالها وعادات سكّانها، فاعتمدوا على ذكائهم ونشاطهم وإقدامهم وقبضوا بعد، مرور سنواتٍ قليلةِ العدد، على ناصية التجارة…” إلى أن يقول: “… ولكنَّهم ذلّلوا كلَّ صعبٍ وتعلّموا لغة البلاد التي يعملون فيها وأنشأوا الصُّحف اليوميّة الكبرى في مختلف لغات العالم وأسّسوا الصَّحافة العربيّة في بلادهم وفي مهاجرهم، وما زالوا إلى اليوم أُمراءَها المُجلّين…”.
“وقد ظهرت الصُّحف العربية جنباً إلى جنب مع ظهور أوّل جاليةٍ سوريّةٍ استقرَّتْ في شارع واشنطن”..
“وصدرتْ أوّل صحيفةٍ عربيّةٍ في الولايات المتّحدة عام 1888م باسم “كوكب أميركا” وكان يملكها اثنان من أولاد يوسف عربيلي، وأوّل مَنْ حرَّرها هو نجيب دياب الذي أسَّس فيما بعد “مرآة الغرب”. (عن كتاب الناطقون بالضاد في أميركا). وقد بلغت الجرائد في الولايات المتحدة تسعاً وسبعين جريدةً ومجلّة. (حسب إحصاء فليب طرازي في تاريخ الصحافة ج 1 وج 2).
ومن هنا يتبيَّن لنا أنَّ الحركة الأدبيّة في المهجر هي صنيع العقد الثامن من القرن المنصرم، ولكنَّها كانت حركةً محدودةً لم تحسَّ لها ركزاً ولم ينتقل صداها من المحيط الذي كانت فيه، ذلك أنَّها إنَّما أُنشِئتْ للجاليات العربيّة الموجودة هناك، ولم تكن تتَّسم بأيّ ميسمٍ مميَّزٍ بل كانت غايتُها إخباريةً بالدرجة الأولى ونشر بعض ما يعتلج في النفوس من مألوف الشعر والنثر في الحنين والشكوى وما اتصل بها من أغراضٍ محدودة …
على أنَّ هذا الإطار الضيّق الذي كانت تتنفَّس فيه اتخذ شكلاً آخر عندما وُجِد بين المهاجرين أمثال جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبي ماضي.
على أنَّ من الإنصاف لتأريخ الحركة الأدبيّة في المهجر أن نشير إلى أنَّ الذي بعثها وأحياها ونقلها من جوِّها المحدود إلى الجوِّ العربي في مشارق الأرض ومغاربها إنَّما كان أديب المهجر الأكبر جبران خليل جبران، يدعم ذلك ما رواه الأستاذ ميخائيل نعيمة في ثني كتابه النفيس “جبران خليل جبران” (2).
على أنَّ الذي يعنينا من هذا المبحث إنَّما هو تأريخ “الرابطة القلميّة” التي تحدَّث عنها الأستاذ الكبير ميخائيل نعيمة فأفاض في الحديث. (التفصيل في كتاب ” الناطقون بالضّاد في أميركا).
وفي ثبْتِ أعضاء الرّابطة القلميّة نجد هؤلاء: “ندرة حداد، إيليا أبو ماضي، وديع ياحوط، رشيد أيّوب إلياس، عطا الله، عبد المسيح حدّاد، نسيب عريضة”.
ونجد في مكان العمادة “جبران خليل جبران” و”ميخائيل نُعيمه” مستشار، و”وليم كاتسفليس” ـ خازن ـ. (من كتاب” جبران خليل جبران” للأستاذ ميخائيل نُعيمه).
أمّا نشأتها فإنَّه “.. في خلال ليلةٍ أحياها صاحب “السّائح” (3) وإخوانه في بيتهم في العشرين من نيسان سنة 1920 م ودعوا إليها رهطاً من الأدباء والأصحاب دار الحديث عن الأدب وعمّا يمكن الأدباء السوريين في المهجر القيام به لبثِّ روحٍ جديدةٍ نشيطةٍ في جسم الأدب العربي وانتشاله من وهدة الخمول والتقليد إلى حيث يصبح قوةً فعّالةً في حياة الأمّة؛ ورأى أحدهم أن تكون لأدباء المهجر رابطةٌ تضمُّ قواهم وتوحِّد مسعاهم في سبيل اللغة العربيّة وآدابها. فقابلت الفكرة استحسان كلِّ الأدباء الحاضرين … وأقرّوا بإجماع الأصوات مباشرة السعي لتحقيق هذه الفكرة ….”.
ونجد في سجلِّ الجلسة الثانية أنَّ الحاضرين (نلاحظ عدم وجود اسم إيليا أبي ماضي بين الحاضرين في الجلستين) قد أقرّوا الأمور التالية:
1- أنْ تُدعى الجمعية “الرابطة القلميّة”.
2- أنْ يكون لها ثلاثة موظفين وهم: الرّئيس ويُدعى العميد، فكاتم السرِّ ويُدعى المُستشار، فأمين الصندوق ويُدعى الخازن.
3- أن يكون أعضاؤها ثلاثَ طبقاتٍ: عاملين ويُدعَون عمّالاً، فمُناصرين ويُدعَون أنصاراً، فمُراسلين.
4- أن تهتمَّ الرابطة بنشر مؤلّفات عمّالها ومؤلّفات سواهم من كتّاب العربيّة المستحقّين، وبترجمة المؤلَّفات المُهمّة من الآداب الأجنبية.
5- أن تعطي الرابطة جوائز مالية في الشعر والنثر والترجمة تشجيعاً للأدباء.
ووكَّل الحضور أمر تنظيم القانون إلى العامل ميخائيل نُعيمه. ثم تمَّ انتخاب جبران للعمادة ونُعيمه للمستشارية ووليم كاتسفليس للخزن.
وبعد أن تمَّ وضع هذه النُّواة للرابطة ضمن هذه الحدود التي هي بمثابة ملامح لبرنامج الرابطة وأهدافها كان عليهم أن يضعوا قانوناً. وإني لأعجب لرابطةٍ قلميّةٍ، فكريّة، يكون لها “قانون” وقد كان حريّاً أن تكتفي بذاك البرنامج لشموله وكفايته في مثل المجال الذي كانت عليه أهداف الرابطة.
ولم يذكر لنا الأستاذ نُعيمه – المستشار- شيئاً عن هذا “القانون” وإنَّما أورد لنا قسماً من مقدِّمته، ليبِّين لنا روح الرابطة ومراميها…
وجاء في تعريف الأدب: “ليس كلُّ ما سُطِّرَ بمدادٍ على قرطاسٍ أدباً، ولا كلُّ مَنْ حرَّر مقالاً أو نظم قصيدةً موزونةً بالأديب، فالأدب الذي نعتبره هو الأدب الذي يستمدُّ غذاءه من تربة الحياة ونورها وهوائها … والأديب الذي نُكرمه هو الأديب الذي خُصَّ برقّةِ الحسِّ، ودقّة الفِكْر، وبُعد النّظر في تموُّجات الحياة وتقلُّباتها وبمقدرة البيان عمّا تُحدِثه الحياة في نفسه من التأثير ….”.
فها هنا تعريفٌ للأديب، يُطلُّ علينا من خلال وجهة نظر مستشار الرابطة القلميّة؛ وواضحٌ أنَّ شاعرنا الكبير أبا ماضي كان يصدر عن هذا التعريف عندما قدَّم ديوانه “الجداول” بهذه التقدمة: (4)
لستَ منّي إنْ حسبْـــــــــتَ الشعر ألفاظاً ووزْنا
خالفتْ دربُك دربي وانقضى ما كان منّا
فانطلـــقْ عنّي لئلّا تقتني همّـاً وحــزْنا
واتّخذْ غيري رفيقاً وسوى دنيايَ مغنى
ثم يتحدَّث الأستاذ نُعيمه في مُقدِّمة “قانون “الرّابطة القلميّة عن “الأدب” الذي يريده …
“…. إنَّ هذه الرُّوح الجديدة التي ترمي إلى الخروج بآدابنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار في جميل الأساليب والمعاني لَحَريَّةٌ في نظرنا بكلِّ تنشيطٍ ومؤازرة فهي أمل اليوم وركن الغد. كما أنَّ الرُّوح التي تحاول بكلِّ قواها حصر الآداب واللغة العربية ضمن دائرة تقليد القدماء في المعنى والمبنى هي في عُرْفِنا سوسٌ ينخر جسم آدابنا ولغتنا، وإن لم تقاوم ستؤدّي بها إلى حيث لا نهوضَ ولا تجدُّد.
“بيدَ أنَّنا إذا ما عملنا على تنشيط الرُّوح الأدبيّة الجديدة، لا نقصد بذلك قطع كلِّ علاقةٍ مع الأقدمين. فبينهم من فطاحل الشّعراء والمفكّرين مَنْ ستبقى آثارهم مصدر إلهامٍ للكثيرين غداً وبعد غد، إلّا أنَّنا لسنا نرى في تقليدهم سوى موتٍ لآدابنا؛ لذلك فالمحافظة على كياننا الأدبي تضطرُّنا للانصراف عنهم إلى حاجات يومنا ومطاليب غدنا؛ وحاجات يومنا ليست كحاجات أمسنا….” (من كتاب ” جبران خليل جبران” للأستاذ ميخائيل نُعيمه).
ولسنا ندري في واقع الأمر ما الذي يعنيه الأستاذ ميخائيل نُعيمه من قوله في تعريف الأدب “… إنَّ هذه الرُّوح الجديدة التي ترمي إلى الخروج بآدابنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار في جميل الأساليب والمعاني لـ… فهي أمل اليوم وركن الغد”؛ فإنَّ في هذا الكلام كثيراً من الغموض والإبهام؛ فهل المقصود من قوله “دور الجمود والتقليد” التقليد والجمود في المبنى أم في المعنى؟ فإن كان المقصود هو الجمود والتقليد في حدود المعنى فإنَّ المعاني – كما يقول أبو الهلال العسكري – مطروحةٌ في الطريق….
ولم يقف أمر التقليد في يوم من الأيام على المعاني، ولم يدَّعِ أحدٌ أنَّ الجمود قد نال المعاني، حتى أصبح بحاجة للتحرُّر من مثل هذا الجمود … وإن كان المقصود هو الجمود والتقليد في حدود المبنى فلسنا على وضوحٍ في هذا الذي ذهب إليه الأستاذ، إلّا إذا كان يريد الخروج والتحرُّر من “الأسلوب” الذي كان رائناً على عصر القرن الرابع ثم عصر الدول المتتابعة أو عصور الانحطاط من حيث اهتمامه بالسَّجع والطِّباق والجِناس وهذه المُحسِّنات البديعيّة التي أصبحتْ غايةً في ذاتها طوال ذاك العصر.
وفي هذه الحالة لا نجد ما يُبرِّر مثل هذه الدّعوة للتحرُّر من الجمود والتقليد والدّعوة إلى الابتكار والتجديد؛ لأنَّه ليس هناك جمودٌ في المعاني ولا في المباني وإنَّما هناك على وجه التحديد أدباءُ مُجترّون، يُردِّدون ما سبق أن تظاهر من منثور عصر الانحطاط ومنظومه ، ومن هنا نرى أنَّ مدرسة “الرابطة القلميّة ” إنَّما هدفتْ إلى الانفلات من “أساليب” عصور الانحطاط التقليدية التي لم تعد صالحة للتعبير عن حاجات الحياة اليوميّة في الاجتماع والأدب ، ولم تنفلت من قيود اللغة العربيّة ولا من معانيها وإن كانت أضافتْ إلى كتاباتها هذه الأفكار الجديدة التي تلقَّتها من بيئتها الجديدة في المهجر .
على أنَّه من مقتضيات البحث أن نشير إلى كلمة الدكتور طه حسين في مجال التعليق على كتابات المهجريين: “… ولكنني حائرٌ حقاً في أمر هذا النّحو من الشِّعر وهذا الفريق من الشّعراء. قومٌ مُنِحوا طبيعةً خصبةً وملكاتٍ قويةً، وخيالاً بعيد الآماد، وهم مُهيَّئون ليكونوا شعراء مُجوِّدين، ولكنهم لم يستكملوا أدوات الشِّعر، فجهلوا اللغة أو تجاهلوها، ثمَّ اتّخذوا هذا الجَهل مَذهباً، فأصبحنا من أمرهم في شكٍّ مُريب، لا نستبيح لأنفسنا أن نُغري الناس بقراءتهم لأنّا إنْ فعلنا أغريناهم بالخطأ، ورغَّبناهم فيه ودفعناهم إلى ما هم مدفوعون إليه بطبعهم من الكسل والقصور والتّقصير. على أنَّ هذا النّحو من الضَّعف لم يكن شائعاً مألوفاً في مصر بل لم يكن شائعاً مألوفاً في بلاد الشرق العربي، ولكنه أقبل عليها من مهاجر السوريين في أميركا، فتأثَّر به الشباب بعض الشيء … وما الذي يمنعهم أن يتأثَّروا به وهو مُريحٌ لا يُكلِّف تعباً ولا عناءً، وهو في الوقت نفسه يُخيَّل إلى الشبّان أنَّهم يقلِّدون الشّعراء الغربيين ويجدِّدون في الأوزان والقوافي ويخرجون على التقليد فيعنون بالمعاني دون الألفاظ؟…”. (من حديث الأربعاء ج 3).
وكأنَّني بالأستاذ ميخائيل نعيمه يردُّ على الدكتور حسين عندما قال: “…. ونقم أنصار التقليد والجمود على الرابطة، فما كانت نقمتهم إلّا لتزيدها قوَّةً وحماسةً واندفاعاً ولتنمّي عدد أنصارها ومُريديها ومُقلديها والمعجبين بها في كلِّ قطْرٍ عربي، حتى حار في أمرها أصحابها وأعداؤها على السّواء؛ فما عادوا يعرفون إلى ماذا يعزون سرَّ قوَّتها وبُعد تأثيرها. فمن قائل إنَّ السرَّ في الأدب الأميركي الذي تأثَّر به عمّال الرابطة، وهو قولٌ فارغٌ، ومن قائل: إنَّه في جوّ الحريّة الأميركية، وهو قولٌ أفرغ، ومن قائل إنَّه في تهتّك عمّال الرابطة من حيث اللغة العربية وأصولها، وهو قولٌ أفرغ وأعقم من القولين الأوَّلين. أمّا الحقيقة فلا يعلمها إلّا الذي جمع عمّال الرابطة القلميّة في فسحةٍ محدودةٍ من ديار غربتهم ولمحةٍ معلومةٍ من زمان هجرتهم ووضع في صدر كلٍّ منهم جذوةً تختلف عن أختها حرارةً وبهاءً لكنَّها من موقدٍ واحد “.(“جبران خليل جبران” لنعيمه).
وكأننا نجد الأستاذ نجم يُدلي بدلوه في الموضوع ويُبدي رأيه في أدب المهجر فيقول: “… والذي يهمُّنا من هذه الحركة هو وجهها الأدبي، وهو وجهٌ مشرقٌ ناصعٌ؛ فقد كُتِب للكثيرين من هؤلاء المهاجرين أن يبرزوا في عالم الأدب والفكر كما برزوا في نواحي الحياة العمليّة. ومَنْ منّا ينكر المساهمة القيِّمة التي شارك بها المهجريون في نهضتنا الأدبيّة الحديثة. ومن يجهل “الرابطة القلميّة” التي كان رئيسها جبران خليل جبران ومن أعضائها ميخائيل نعيمه وإيليا أبو ماضي ونسيب عريضة و…. وهذا لا يعني أنَّ النشاط الأدبي في المهاجر الأميركية انحصر في هاتين الجمعيتين (يعني بالثانية العصبة الأندلسية في أميركا الجنوبية) بل هنالك أدباء كثُر لم ينتظموا في سلكهما ….”
ويستمر الأستاذ نجم فيقول: ” … نودُّ أن نُجمِل رأينا فيها – في الرابطة – بأن نقول: إنَّ هذه المدرسة التي اتّسمتْ بميسم القوّة والتّجديد والثورة على كلِّ قديمٍ بالٍ هي أقوى مدرسة عرفها الأدب العربي الحديث حتى اليوم. وقد ضربتْ بسهمٍ صائبٍ في حقل الأدب واستطاعت أن تُقدِّم إلى أدبنا طائفةً مختارةً من الأدباء الذين شاركوا في الأدب بألوانه المختلفة مشاركةً طيّبةً، والتي نفحونا بروحانيّة طغى عليها التفكير الفلسفيّ الصوفيّ. وقد عني هؤلاء الأدباء بالفكرة والموسيقى أكثر مما عنوا باللغة وقواعدها” (“القصة في الادب العربي الحديث”).
ويذكر الأستاذ إلياس أبو شبكة (في “روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة”) شيئاً عن موقف أدباء العربيّة من أدباء المهجر وأدبهم، فيرى أنَّه كموقف “البرناسيين الفرنسيين من بعض أدباء العهد الرومانطيقي على وجه التقريب. ففي العام 1866 عندما أذاعتْ المدرسة البارناسيّة مبادئها راحتْ تُنحي باللائمة على الشُّعراء الذين يهملون العناية باللغة وقواعد النَّظم، فيسلكون مثلاً مسلك “ألفرد ده موسّيه” الذي كان له من عبقريّته ما يشفع بقوافيه المضطربة … سوى أنَّ الشعراء البرناسيين كـ”جوزي ماريا ده هريديا، وبودلير، وليوكنت ده ليل، وفرانسوى كوبيه”، وأضرابهم كانوا يرتفعون بقوة أفكارهم وجمال صورهم إلى مستوى الصّياغة والمتانة اللتين كانوا يطالبون بالتمسُّك بهما، فلم يهبط المستوى الفني عن مرتبة الشاعر، خلافاً لأدبائنا الذين كانوا يأخذون على جبران والريحاني وعريضة وإخوانهم من رجال الرابطة الأدبيّة في المهجر ضعف لغتهم ونبذهم القواعد المأثورة في النّظم والنثر”….
ومهما اختلفت الأقوال في هذه المدرسة المهجرية بين مُدافعٍ عنها وبين مُحبِّذٍ لها ومُنشِّطٍ ومهاجمٍ فإنَّ الذي لا ريبَ فيه أنَّها احتلَّتْ مكانةً لها قيمتُها في الميدان الأدبيّ خلال الربع الثاني من القرن العشرين، وكان لها نصراؤها ومحبُّوها “ولا يزال لهذه المدرسة أثرها في الأدب العربي المُعاصر. وقد بدأ الضَّعف يدبُّ في عناصرها، (خاصَّةً بعد وفاة عميدها جبران) إذ إنَّ الإمداد الأصيل الذي كان يأتيها من أرض الوطن يكاد ينقطع سيله الآن. وكلُّ أديبٍ يموت هناك يدقُّ مسماراً جديداً في نعشها” (عن كتاب “القصة في الأدب العربي الحديث”).
أمّا مدى انطباع المدرسة في شعر الشاعر أبي ماضي، ومدى ما أسداه الشاعر لهذه الرّابطة، فإنَّنا ندور كثيراً في شعر الشاعر فلا نجد إلّا الرُّوح المُجنَّحة التي حملتْه على التخلّي عن مدرسة تقليد القدماء في ألفاظهم وتعبيراتهم بل وأسلوبهم لينطلق في رحاب المدرسة الجديدة التي تهتمُّ بالفكرة أكثر ممّا تهتمُّ بالثَّوب الذي تُضفيه على تلك الفكرة؛ فإذا نظرتَ في ديوانيه التاليين “الجداول” و “الخمائل” فلن تجد المَطالع الفخمة التي تُذكِّرك بالمُعلَّقات أو بلاميّة العرب أو العجم وما اتّصل بذلك، وإنَّما تجد لوناً جديداً ليس فيه إلّا محاولة التعبير عن أفكارٍ جديدةٍ هي وليدة البيئة الجديدة التي عاشها مع زملائه أعضاء الرابطة القلميّة.
*****
ولستُ بمعرض الحديث عن أثر “الرابطة القلميّة” في شعره، لأنَّ “الرابطة القلميّة” إنَّما قامتْ بمعاونة الشاعر إيليا أبي ماضي، فهو علَمٌ من أعلامها وعاملٌ من عمّالها؛ إلّا أنَّه لا بُدَّ من التنويه بالانطلاق الذي أصبح عليه منذ سلك في عداد عمّال الرابطة القلميّة وكان عليه بالتالي أن يُثبت وجوده كشاعرٍ يُدافع عن تلك “المبادئ”، التي ألمح إليها الأستاذ الكبير ميخائيل نُعيمه في مقدِّمة “قانون الرابطة القلميّة”، وأن يعتنقها ويؤمن بها نصّاً وروحاً.
على أنَّ المتتبِّع شعر أبي ماضي، بُعيد اشتراكه في إنشاء الرابطة القلميّة حتى آخر منظومةٍ له، يجد الشاعر الكبير من مدرسةٍ غير مدرستهم وفي اتّجاهٍ غير اتجاههم. ولسنا ندَّعي أنَّه مُخالفٌ، كما لا نقوى على الادّعاء أنَّه منصهرٌ في بوتقتها، بل كان ذلك الشاعر الغَرِد يُغنّي ما تُمليه عليه موهبته دون أن يتعمَّد هذا اللون أو ذاك، ودون أن يحاول أن يكون صاحب مدرسةٍ خاصَّةٍ في الشِّعر لها طريقتها ولها أسلوبها المتميِّز.
———————–
-
“النبوغ اللبناني” ص 19 وص 25 نقلاً عن خطبة لشكري الخوري منشئ جريدة “أبي الهول” في مهرجان يوبيل جريدته الفضي في سان باولو (البرازيل) 15 آب 1935م.
-
ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب القيّم في بيروت سنة 1934 وطبع في مطبعة “لسان الحال” ثم تكررت طبعاته على يد “مكتبة صادر”.
-
“السائح” جريدة نصف أسبوعية لصاحبها ومؤسسها عبد المسيح حداد، وكان مضى على تأسيسها ست سنوات قبل قيام الرابطة القلمية لتكون لهم بوقاً فيما بعد.
-
وقد علق الدكتور طه حسين على هذه الأبيات في مقال له، ج 3 “حديث الأربعاء” ص 196، قال: ” فمن الحمق أن الشاعر لا يقول شيئاً في هذا الكلام لأن الشعر لا يستقيم ولا يوجد ولا يمكن تصوره بغير الألفاظ والوزن. وآية ذلك أن الشاعر نفسه قدم لنا في ديوانه هذا ألفاظاً موزونة. ولم يقدم لنا كلاماً منثوراً في غير وزن ولم يقدم لنا معاني في غير ألفاظ ….
إذن فاللفظ ليس من الضعة وضآلة الشأن بحيث يريد الشاعر أن يقول في هذه الأبيات التي رويناها لك …. وعلى هذا النحو نخالف الشاعر فيما ذهب إليه من ازدراء اللفظ والوزن….” أ ه.
*******
آراء
على أنَّ ممّا لا شُبهةَ فيه أنَّ إيليا أبا ماضي شاعرٌ كبيرٌ “يصعد إلى الملأ الأعلى ولكنْ على سُلَّمٍ أبقى وأقوى من الجبال؛ يصعد بعزم الرُّوح، ويتمسَّك بحبالٍ غير منظورةٍ ولكنَّها أمتن من سلاسل الحديد؛ يتمسَّك بحبال الفِكْر، ويملأ كأسَه من عصيرٍ أرقّ من ندى الفجر، يملؤها من خمرة الخيال؛ والخيال هو الحادي الذي يسير أمام موكب الحياة نحو الحقِّ والرُّوح” (من مقدمة الجزء الثاني من ديوان إيليا أبي ماضي كتبها جبران خليل جبران).
ويضيف جبران خليل جبران قائلاً ” … وإيليا أبو ماضي شاعرٌ، وفي ديوانه سلالمُ بين المنظور وغير المنظور، وحبالٌ تربط مظاهر الحياة بخفاياها، وكؤوسٌ مملوءةٌ بتلك الخمرة التي إنْ ترشفها تظلُّ ظمآنَ حتى تملَّ الآلهة البشر فتغمره ثانيةً بالطوفان”.
*******
رأيه في الشاعر
ولعلَّ هذا الذي أسبغه جبران خليل جبران على إيليا أبي ماضي إنَّما هو مستقى من تعريف أبي ماضي للشاعر؛ إذ تطالعُك في صدر الجزء الثاني من ديوانه قصيدةٌ بعنوان “الشاعر” وقد حاول أبو ماضي أن يُجري حواراً بينه وبين فَتاته حول تعريف الشاعر فجاء بالبديع من القول.
فالشاعر، من حيث هو شاعرٌ، كالكهرباء في خفائها وظهورها، وهو ذاك الذي حباه الإلَه القدرة على ملاحقة خفايا الأشياء، فكأنَّه لا يرتضي بظواهرها بل يروح متسائلاً عمّا وراء المنظور:
….. ….. ….. ….. أنا كالكهرباء، أُرى خفيّاً ظاهرا
…. هو مَنْ يُسائل نفسَه عن نفسِه في صُبحه ومسائه
والعينَ سرَّ سُهادها ورقادها والقلبَ سرَّ قنوطه ورجائه
وهو بالتالي ذاك الإنسان الذي حارَ في كلِّ شيءٍ، ولم يقنع بشيء، ولم تصل معرفته إلى مرتبة اليقين في أيَّة قضيَّةٍ من قضايا الحياة، لذا تراه أبداً مُعلَّقَ الأنفاس، مبهورَها، يُسائل نفسه ولا من مُجيب، فتغلبه شكوكه على نفسه فيقول في وصف الشاعر:
فيحارُ بين مجيئه وذهابه ويحارُ بين أمامه وورائه
ولكنَّ هذا الحائر بين أمسه ويومه وغده، وبين منشئه ومصيره، له قدرةٌ على رؤية الأشياء المُبهمة فكأنَّه على شيءٍ من العلم بالغيب:
ويرى أفولَ النّجم قبلَ أفولِه ويرى فناءَ الشّيء قبلَ فنائِه
وهو إلى جانب هذا سادرٌ في مَهامِهِ الحياة، غامضٌ في تصرُّفاته، تأخذه موجاتٌ من التّشاؤم كاسحةٌ…. فهو:
إنْ نامَ لم ترقدْ هواجسُ روحِه وإذا استفاقَ رأيته كالتّائـهِ
ما إنْ يُبالي ضحكَنا وبكاءنا ويُخيفنا في ضحكه وبكائهِ
وَيَسيرُ في الرَّوضِ الأَغَنِّ فَلا تَرى عَيناهُ غَيرَ الشَّوكِ في أَرجائِهِ
حتى إذا أخذتْ منه الأنانيّة مأخذها الرَّهيب أصبح:
كالنّار يلتهمُ العواطفَ عقلُه فيُميتها ويموتُ في صحرائهِ
ويتبادر إلى الذِّهن أنَّ هذه الأنانيَّة أصيلةٌ، في جبلَّته، تجري في دمائه، ولكن إذا أمعنتَ النظر تلامحتْ لك غَيريّته بأجلى مظاهرها…
هُوَ مَن يَعيشُ لِغَيرِه وَيَظُنُّهُ مَن لَيسَ يَفهَمُهُ يَعيشُ لِذاتِهِ
وجملة القول في صفات الشاعر أنَّ فيه من الناس أحاسيسهم ومشاعرهم ولكنَّه إلى جانب ذلك يسمو عليهم بهذه القدرة الجبّارة على اختراق المنظور والكشف عن اللامنظور ….
كُلَّما هَزَّتْ يَداهُ وَتَراً هَزَّ مِن كُلِّ فُؤادٍ وَتَرَه
وهو تعيسٌ في الأمّة التّعيسة:
تَعِسُ الحَظِّ، وَهَل أَتعَسُ مِن شاعِرٍ في أُمَّةٍ مُحتَضَرَه؟..
وهو رسول القوميّة ورسول المحبَّة ورسول السَّلام ورسول الحرب، وكما هو قادرٌ على هزِّ المشاعر، وقادرٌ على التطلُّع إلى المجهول ليكشفه ويجعله معلوماً، فهو قادرٌ على الانفعال والغضب، تأخذه الحميَّة (في قصيدة “الشاعر والأمة”) فإذا به:
ثمَّ لمّا عبثَ النّاسُ به مزَّق الطِّرس وشجَّ المحْبَره
فههنا تتلامح لك صورةٌ أقرب ما تكون إلى الكمال لذاك الإنسان الذي أراد أن يُحدِّد أبو ماضي صفاته ويبيّن مميّزاته؛ فهو قبل كلِّ شيءٍ “إنسانٌ” يُحسُّ كما يُحسُّ الآخرون فينفعل كما ينفعلون ويميل مع نفسه كما يميلون، إلّا أنَّه في مجالَيْ الفِكْر ومطارح الرؤية نراه يُفكِّر أبعدَ ممّا يفكِّرون ويرى بأقوى ممّا يرون، فيُجمل القول والصّفات ليُعرِّف الشاعر (في ديوان الجداول) فيقول:
إنَّما نحنُ معشرَ الشُّعراء يتجلَّى سِرُّ النبوَّة فينا
*****
على أنَّ أبا ماضي وقد تحدَّثَ في “الشاعر” لم يترك الحديث في “الشِّعر”. ولا يعني هذا أنَّه قد حاول تحديد “مفهوم” الشِّعر، أو حاول أن يرسم خطوطه بريشة صاحب مدرسةٍ خاصَّةٍ، ولكنَّه التفتَ إلى مَنْ تقدَّمه من الشُّعراء فأنكر من شعرهم بعض الأغراض، فهو يأنفُ من التّشبيب بالخمرة، كما يترفَّعُ عن المديح ووصف النّساء، ويعتبر ذلك من “سفاسف الشُّعراء”؛ وإذا كان الشُّعراء القُدامى، برأيه، قد أخذوا أنفسهم بالمديح، يجعلونه غرض الأغراض في شعرهم، فشاعرنا يعتبر ذلك منقصةً يترفَّع عنها ولا يتدنَّى إليها:
أَنا ما وَقَفتُ لِكَي أُشَبِّبَ بِالطِّلا ما لي وَلِلتَّشبيبِ بِالصَّهباءِ
لا تَسأَلوني المَدحَ أَو وَصفَ الدُّمى إِنّي نَبَذتُ سَفاسِفَ الشُّعَراءِ
باعوا لِأَجلِ المالِ ماءَ حَيائِهِم مَدْحاً وَبِتُّ أَصونُ ماءَ حَيائي
لَم يَفهَموا ما الشِّـعرُ إِلّا أَنَّـهُ قَد باتَ واسِطَةً إِلى الإِثـراءِ
ولو وقف الأمر عند هذا الحدِّ لكان هيّناً، ذلك أنَّ أبا ماضي قد نظر إلى الشُّعراء القُدامى بباصرة القرن العشرين، ولم ينظر إليهم بباصرة القرون التي عاشوا فيها والتي كانت تُقهر الشّاعر على ألّا يقول الشعر إلّا للتكسُّب، لمحدوديّة وسائل العيش من جانبٍ ولانعدام الصَّحافة التي هي بوقُ الخلفاء والسَّلاطين والمُتسلِّطين من جانبٍ آخر؛ إلّا أنَّنا نرى الشّاعر مُولَعاً بالتَّعميم عندما يجعل صفة الرّياء ملاصقةً لأخلاق “أولئك” الشُّعراء:
“ألفوا الرّياء فصار من عاداتهم “….
ومن هنا يتضِّح لنا رأي الشّاعر أبي ماضي فيمَنْ تقدَّمه من الشُّعراء أوّلاً وفي أغراض شعرهم ثانياً؛ أمّا مذهبُه هو في الشِّعر، فلم يكدْ يُشير إليه إلّا في مُقدِّمة ديوانه الثالث (الجداول) عندما قال في تلك الفاتحة:
لستَ منّي إنْ حَسِبْتَ الشِّعرَ ألفاظاً ووَزْنـا
خالفتْ دربُك دربـي وانقضى ما كان منّا
ومن الواضح الجليّ الذي لا يرقى إليه الشكُّ أنَّ الشّاعر يريد أن يقول: إنَّ الشِّعر ليس ألفاظاً وأوزاناً وإنَّما هو روحٌ ومعنىً ، فكأنَّه بهذا قد انتصر لمدرسة المعنى. وهو إلى جانب ذلك لم يذكر شيئاً عن العاطفة في الشِّعر(1) والصدق. ولعلَّ أمير الشُّعراء كان أجمع لتعريف الشِّعر حين قال:
والشِّعر، ما لم يكنْ ذكرى وعاطفة أو حكمة، فهو تقطيعٌ وأوزانُ
فشوقي، بهذا التعريف، قد ميَّز الشِّعر من النَّظم، وأبان عن أهدافه فجعلها في ثلاثة أهداف: الذّكرى، والعاطفة، والحكمة؛ فلو خلا الشِّعر من أحد هذه الأغراض عاد نَظْماً يُسلَك في عداد الموزون، بينما نجد أبا ماضي قد أهمل التحدُّث عن هذه الأغراض وأضاف إلى ذلك إهمال اللّفظ ، مما ساق الدكتور طه حسين سوقاً إلى أن يأخذ عليه ذلك بشدّةٍ وعنفٍ كما سبق القول.
ومادام الموضوع دائراً في تحديد مفهوم الشِّعر فلا علينا إذا أثبتنا رأي الشّاعر الفرنسيّ الكبير (بول فاليري) لأنَّه يُبيّن عن عمقٍ في فهْمِ الشِّعر؛ قال:”للشِّعر في الأفهام معنيان: أوَّلهما أنَّه مجموعة العواطف والانفعالات التي تُهيّجها في نفوسنا أحداث الزمن، ومجالي الطبيعة، ومعاني الوجود، وألوان الحياة. فنقول، منظرٌ شعريٌّ، وظرفٌ شعريٌّ. وثانيهما أنَّه فنٌّ قائمٌ وصناعةٌ عجيبة، يتناول الأهواء المشبوبة بالتّنسيق والتّأليف والجلاء، ثمَّ يُبرزها في لغةٍ جميلةٍ تطرَبُ لها الأذن ويهتزُّ منها القلب” (عن كتاب “من النقد الفرنسي” للأستاذ محمد روحي فيصل).
ونرى من جانبٍ آخر أنَّ إيليا أبا ماضي قد جعل شعاراً لجريدته التي أصدرها في نيويورك ولا يزال، هذين البيتين:
أنا لا أُهدي إليكم ورَقـاً غيرُكم يرضى بحبـرٍ وورقْ
إنَّما أُهدي إلى أرواحكم فِكَراً تبقى إذا الطِّرس احترقْ
فـ (الفكرة) هي التي تتغلَّب لدى الشّاعر على اللَّفظ، كأنَّه من أنصار المعنى وحده، فالشِّعر عنده، أو ما يصدر عنه بالذّات، إنَّما هو فكرٌ خالدٌ، باقٍ بقاء الزمن؛ ويبقى بعد هذا أن نتساءل مع الشّاعر الكبير عمّا إذا كان الخلود يصدُّ عن الأثواب الجميلة وهو يراها تكسو تلك الأجساد الخالدة!!.
ثم نجد الشاعر الكبير وقد قدَّم قصيدةً إلى روح الشّاعر الخالد خليل مطران (نُشرت في مجلة “العصبة” التي تصدر عن البرازيل). فعرّف فيها بالشاعر …
وإلى جانب هذه الصورة القويّة للشّاعر، كما أرادها أبو ماضي، فقد جعل للشاعر رسالاتٍ، عليه أنْ يؤدّيها في حياته، رسالاتٍ في التفاؤل، وفي تجميل الحياة وتزيينها، ورسالاتٍ في القوميّة، ورسالاتٍ في المجتمع وما اتصل بذلك؛ حَسْبُك أنْ تُقلِّبَ صفحاتِ دواوينه (2) فستجد ما اضطرب في نفس الشاعر منقوشاً بأحرفٍ من نورٍ تُشير إلى سموِّ الرّسالة التي يحملها الشاعر مُبشِّراً بها من جانب، وإلى مدى ما يحرق شمعة حياته لينير الدّياجير للسَّارين في ليل الحياة الأبدي.
—————————————————
-
ارجع إلى كتاب (من النقد الفرنسي) للأستاذ محمد روحي فيصل، نشرته دار اليقظة العربيّة في سلسلة منشوراتها (اليقظة) عدد 2 ففيه من المباحث في الشِّعر، والحاجة إليه، والحياة والشِّعر، ما هو جديرٌ بالدّراسة والاقتباس.
-
القصائد التي تعالج هذه الموضوعات أكثر من ان يحصيها عد. وقد اقتبسنا بعضها من الجزء الثاني من ديوانه وأثبتناها في هذه الدراسة “الشاعر والأمة” ص 28. “دموع وتنهدات” ص 19. “أمة تفنى وأنتم تلعبون” ص 210 “الشاعر والسلطان الجائر” “الخمائل”.
*******
رأيه في المرأة
ما كنت لأحبَّ أن أُفرد مبحثاً خاصاً أشير فيه إلى رأيه في المرأة أو السياسة وما اتصل بذلك، لأنه يسوقنا بالضرورة إلى تقصّي جملة آرائه في مختلف مظاهر الحياة والمجتمع، وهو ما لا نقصد إليه، ولكنَّنا وجدنا له في بعض شعره ما هو جديرٌ بالتّنويه به في هذين الأمرين الخطيرين.
وعلينا بادئ ذي بدء أن نميّز نوعين من النساء يذكرهما الشاعر في منظومه، أوَّلهما الغانية التي خلقها الله خدينة الشاعر في رحلاته العُلويّة لتكون موضوع غزله ومناجاته وموضوعات قصصه؛ ومثل هذه الغانية – في شعر الشاعر – تتّسم بالجمال المُطلَق، فريقتُها خمرةٌ، وخدُّها وردةٌ، وعيناها منبعُ السِّحر الحلال:
ليتَ الذي خلقَ العيونَ السُّودا خلقَ القلوبَ الخافقاتِ حديدا
لولا نواعسُها ولولا سحرُها ما ودَّ مالكُ قلبه لو صيدا
عوِّذْ فؤادَك من نبالِ لحاظِها أو مُتْ كما شاءَ الغرامُ شهيدا
… … …
عيناكِ والسِّحر الذي فيهما صيَّرتاني شاعراً ساحرا
وأمثال هذا اللون من الشِّعر منثورٌ في أثناء المُختارات التي انتقيناها لهذه الدراسة من الجزء الثاني من ديوانه وأثبتاناها إثر هذه الدراسة؛ وكلُّها لا تخرج عمَّا نعلم من وصف الغواني لدى الشُّعراء في كلِّ عصرٍ ومصر.
ولستُ أريد تجاوز هذه “الغانية” قبل أن أشير إلى أنَّ شعر الشاعرـ في مختلف القصائد والمقطوعات ـ لا يعدو ما نُسمّيه “النَّسيب”، من حيث إنَّه يقول دون أن نستشعر عاطفة الشاعر الخاصَّة تجاه مخلوقةٍ بعينها أو حبيبةٍ وقف عليها حياته وشعره، كأنَّ الشاعر الكبير لم يعرف الحبَّ ولم يستوحِه في منظومه !
وأمّا الأنثى الثانية التي ورد ذكرها في شعر الشاعر فهي ” المرأة” التي هي موضوع الخلاف السّرمدي من حيث مكانتها في المجتمع والمُهمّات المُلقاة على عاتقها في هذه الحياة؛ فهو هنا يتحدث عن “المرأة” مقابل “الرجل” .
ورأيه في “المرأة” واضحٌ كلَّ الوضوح، فهي لم تُخلق للعمل، والكدح، و لكسب المال، كما لم تُخلق لأن تُباع و تُشرى في سوق نخاسة الزّواج وإنَّما لها محلٌّ واحدٌ عليها ألّا تتجاوزه أو تطلب أكثر منه أو تُكلَّف بغيره وهو “المنزل” .
وإذا كان أنصار تحرير المرأة لا يرضون عن مثل هذا الرأي من الشاعر فإنَّه قد صرَّح به في لفظ ٍجريءٍ لا مواربةَ فيه ولا مداورة، فاستمع اليه يقول (في قصيدة بنت سورية):
سجَّلَ العارَ علينا معشرٌ سجَّلوا المرأة بين الهَمَلِ
فهي إمّا سلعةٌ حاملةٌ سِلَعاً أو آلةٌ في معملِ
تتهاداها الموامي والرُّبى فهي كالدّينار بينَ الأنمُلِ
في سبيل المال أو عشَّاقه تكدح المرأة كدْحَ الإبلِ
إلى أن يقول:
جشَّموها كلَّ أمرٍ مُعضِلٍ وهي لم تُخلَق لغير المنزل
فهل يمكن لنا أن نُطلق على الشاعر تعريف “رجعي” لاعتناقه مثل هذا الرأي الذي يُعيد المرأة إلى عرشها الخالد في بيت الزوجية؟ وعلينا ألّا ننسى أنَّ شاعرنا يعيش في بلاد الحريّة والنور والتحرُّر والتّحرير,عندما يُدلي بمثل هذا الرأي إنَّما يُدلي به بعد أن لمس “ذُلَّ” المرأة في حقل العمل:
في سبيل المال أو عشّاقه تكدح المرأة كدْحَ الإبل
فكان لا بُدَّ له في التالي من أن يدعو إلى أنَّ المرأة لم تُخلَق إلّا للمنزل، ضنّاً بكرامتها ومَنزلتها أن تتدنّى إلى مرتبة الكدح والعمل المُضني الشاقِّ الذي خُلِق له الرجل وحده!
*******
رأيه في السياسة
رأيه في السياسة متّصلٌ اتصالاً وثيقاً بسبب هجرة الشاعر الكبير … وعلينا أن نسجِّل ، أوّل ما نسجِّل، أنَّ الشاعر لا يعتنق مبدأً سياسيّاً مُعيَّناً يُبشِّر به ويدعو إليه، وإنَّما تمرُّ في شعره بعض المناسبات فيستغلُّها ليُدلي برأيه في “السياسة” من حيث هي نمطٌ من أنماط الأساليب العصريّة للوصول إلى الحكم.
وقد يدخل في هذا المبحث “قوميّة الشاعر” وغضبته المُضريّة على بعض السّاسة من وجهة نظر المواطن الذي سئم حكّاماً مُعيَّنين لأنهم ظلموه أو ظلموا أمَّته، كما في قصيدته “وداع وشكوى” .وقد نجده يغضب غضبةً شديدةً على تركيا والأتراك في أكثر قصائد الجزء الثاني من ديوانه، لأنَّ تركيا الغشوم جثمتْ على صدر الأمّة العربيّة أربعة قرونٍ أو تزيد، فأذاقتها ألوان الإهانة والإذلال والإتعاس والإفقار والإشقاء …. (من كتاب ” النبوغ اللبناني”).
وقد نجده إلى جانب ذلك يُغرِق في مدح “أميركا” التي خلَّصتْ بلاده من نير الأتراك الجائرين … إلّا أنَّ هذا جميعاً ليس إلّا من قبيل “الانفعال”، وما هو إلّا رأي شاعرٍ في وضعٍ سياسيٍّ أو حالةٍ قائمة، لا يعالج جوهرها وإنَّما يلامسُها ملامسةً قريبة تتّصل بالمناسبة التي قيلت فيها القصيدة، فهو من هذا الجانب “شاعر مناسبات” فلا مجال للإشارة إلى ما يمكن أن يكون في شعره من تناقضٍ بالنسبة لموضوعٍ واحد، ذلك أنَّ الشاعر لا يُعالِج “جوهر” السياسة والأحداث السياسيّة وإنَّما يتحدَّث في بعض المناسبات عن هذا الذي يعتلج في نفسه إبّان سخطه، وإبّان رضاه!
ولستَ تجد في جميع منتخبات هذا الكتاب إلّا هذا اللّون من الشِّعر السياسي الذي يذمُّ الأتراك لنذالتهم وسفكهم دماء العرب وخنقهم الحريّة ووأدهم الشباب العربيّ المثقَّف حيّاً … مما جعل الشاعر يصبُّ جام غضبه على “الإسلام” الذي كانت تُمثّله الخلافة العثمانية … فإذا مرَّ ذِكْر “الهلال” وجدتَ الشاعر يحاول جاهداً أن ينتقص من قدره ويحطَّ من قيمته، لأنه رمزٌ لتلك الخلافة وما كان في العثمانيين من فسادٍ أصيل …
وإذا انتصر الغرب على الأتراك في موقعةٍ من المواقع أو معركةٍ من المعارك، وجدتَ الشاعر أبا ماضي يهتبل المناسبة ليجعل الصُّلبان تعلو على الأهلَّة، تشفيّاً وشماتةً بالأتراك !!
فاستمع إليه في قصيدة “بلادي” يخاطب الأتراك مُشيراً إلى القرون الطويلة التي جثموا فيها على صدر سورية:
رجالَ التُّرك، ما نبغي انتقاضاً لعمركم، ولا نبغي انتقاما
ولكنّا نطالبُكم بحقٍّ ونكرهُ مَنْ يريدُ لنا اهتضاما
حملنا نيرَ ظلمِكمُ قروناً فأبلاها وأبلانا وداما
وإذا ذكر ما خلَّفه الأتراك من مساوئ قال يخاطبهم:
رعيتم أرضَنا فتركتموها إذا وقعَ الجرادُ رعى الرَّغاما
فباتَ الذئبُ يشكوكم عواءً وباتَ الظَّبيُ يشكوكم بغاما
ولا يقتصر الشاعر على هذا اللّون من التأنيب العنيف ووصم التركيّ بهذه الصِّفات الجارحة حقاً، وإنّما يعمد إلى التّعميم، فيرى أنَّ التركيَّ جبانٌ رعديد، وعلاوةً على هذا الفساد والدّمار الذي ينشره في كلِّ أرضٍ يحلُّ بها، تراه يمشي إلى حتفه بظلفه، ويقود “الهلال” إلى المحاق فالفناء … ويبدو أنَّ الشاعر يريد بعض الخير لهذا الهلال أو يتوسَّم له مستقبلاً أفيحَ وآتياً أنجحَ …
جريتم بـ “الهلال” إلى مَحاقٍ ولولا جهلُكم بلغتم التَّماما
والتركيُّ إلى جانب جهله لئيمٌ، فكلَّما ازددنا لياناً زاد عراماً، وليس من طباعه حفظ الجار ولا في خُلُقه مراعاة الذِّمام … أضف إلى ذلك أنَّه مولَعٌ بإثارة الفتن والأحقاد حتى يفتك الناس بعضهم ببعض …
ولو وقف الأمر بثورة الشاعر عند هذا الحدِّ لقلنا تلك غضبةُ الكريمِ لقومه الذين أذلَّهم الأتراك أيَّما إذلال، ولكنَّه شكَّ في إيمان الأتراك ومسَّهم في عقيدتهم مسّاً غير رفيق:
خَفِ التركيَّ يحلفُ بالمثاني وخَفْه كلَّما صلَّى وصاما
ثم أثارها الشاعر نزعةً طائفيةً دينية عندما قال:
وقالوا نحنُ للإسلامِ سورٌ وإنَّ بنا الخلافةَ والإماما
فهلْ في دينِ أحمدَ أن يجوروا وهلْ في دينِ أحمدَ أن نُضاما؟
ثم يضيف إلى ذلك توزيع مقاعد الحكم ….
إلى كم يحصرونَ الحُكمَ فيهم وكم ذا يبتغونَ بنا احتكاما
ألسنا نحنُ أكثرهم رجالاً إذا عُدُّوا وأرفعهم مَقاما
وبعدها يعلن الثورة ليقول:
سنوقدُها تُعير الشّمسَ ناراً ويُعي أمرُها الجيشَ اللُّهاما
وعلمُ المرءِ أنَّ الموتَ آتٍ يهوّنُ عندَه الموتَ الزّؤاما ! ..
ولا تكاد تمرُّ مناسبةٌ من المناسبات حتى يحمل حملته الشّعواء على الأتراك الذين هدروا القيم وعطَّلوا المفاهيم ووأدوا الأحرار وأداً مُشيناً:
ما كفتْنا مظالمُ التُّركِ حتّى زحفوا كالجرَادِ أو كالوَباءِ
ضيمَ أحرارُنا وريعَ حِمانا وسكتْنا، والصَّمتُ للجُبناءِ
وتراه في قصيدة “معركة بورغاس” يشنُّها حرباً صليبية أخرى، إذ يرى أنَّ المعركة لم تكن بين قومٍ وقوم، وإنَّما كانت بين الإسلام والنّصارى …وانحسرت المعركة عن:
وقد انجلتْ فإذا الهلالُ منكَّسٌ علمٌ طوتْه رايةُ الصّلبان
ويجد الفرصة موآتية مرّةً أخرى فيصبُّ جامَ غضبه على الأتراك، أو على المُسلمين، كأنه لا يفهم الإسلام إلّا من خلال الأتراك، أو كأنَّه نسي أنَّ غضبة المسلمين على الأتراك تفوق غضبة النّصارى عليهم، أو كأنَّه نسيَ أنَّ الإسلام شيءٌ والمسلمين شيءٌ آخر … ويجدر بنا في هذا المعرض أنْ نستطرد، بعض الاستطراد، لنذكر كلمةً في مثل هذا المجال وجهَّها الدكتور طه حسين إلى الأديب الفرنسي الكبير أندريه جيد، فأملى قوله: “… لم تُخطئ أنت ـ والخطاب لأندريه جيد ـ وإنَّما دُفعتَ إلى الخطأ. لقد خالطتَ كثيراً من المُسلمين، ولكنك لم تخالط الإسلام: فليس على الإسلام بأسٌ ممّا ألقى في روعِك خلطاؤك المسلمون”(1).
ومثيلُ ذلك ما وقع لشاعرنا الكبير أبي ماضي ، فإنه ما كاد يرى مساوئ الأتراك حتى ظنَّ السُّوء في الإسلام لا في الأتراك…
أمّا جُبن الأتراك فإنَّ الشاعر يُقدِّم لك صورةً رائعةً لهؤلاء الجُبناء (على حدِّ رأيه):
نفروا لكالحُمرِ التي روَّعتها بابنِ الشَّرى المُتجهَّم الغَضبانِ
وقلوبُهم قد أسرعتْ ضرَباتُها وتظنَّها وقفتْ عن الخَفقَانِ
مُتلفّتين إلى الوراءِ بأعيُنٍ تتخيَّلُ الأعداءَ في الأجفانِ
يتلمَّسون من المنيّة مَهرباً هيهاتَ! .. إنَّ الموتَ كلَّ مكانِ
إنْ يأمنوا وقْعَ الأسنّةِ والظُّبى فالذُّعرُ طاعنُهم بشرِّ سِنانِ!
يقابل هذا رأيه في “أميركا” فهو نقيضُ رأيه في أولئك الأتراك أصحاب الهلال، أليس الأميركيون أصحاب “الصُّلبان”؟ إذن لا عليه إذا أزجى المديح وأطنب فيه أيَّما إطنابٍ في أكثر من قصيدةٍ من المُنتخبات، ويبلغ إعجابه بأميركا حدّاً يُنسيه قوميّته وعصبيّته ووطنه، ويرى الراية الأميركية هي الراية الوحيدة الجديرة بالخلود (في موشح “1914”):
… … …
فلتدُمْ “أميركا” ما التطمـا
ما لهذا الفتح في التاريخِ ثانِ
ولتعِشْ رايتُها ذاتَ النُّجومِ أجملُ الرّاياتِ أولى بالخلودِ
……….
ومن جملة ما تقدَّم يتضِّح لنا أنَّ الشاعر الكبير لا يُعالج مبدأً سياسيّاً مُعيّناً ولا يميل مع مذهبٍ من المذاهب الاجتماعيّة السائدة ، وإنَّما عالج موضوعاً من موضوعات “المناسبة” وحدها …
أمّا رأيه في السياسة، من حيث هي “جوهر” ومن حيث هي “مبدأ”، فإنَّنا نجده يحمل عليها بشدّةٍ وعنفٍ لأنها كثيرة الوجود، كالحرباء مُتلوِّنة.
ولا يفوتني أن أشير إلى أنَّ الشاعر قد انصرف عن غرض “شعر المناسبات” ـ إلّا قليلاً ـ في الجداول والخمائل (2)، بمعنى أنَّه أصدر “تذكار الماضي” ثمَّ “الجزء الثاني من ديوان إيليا أبي ماضي” ثم انصرف عن هذا اللّون انصرافاً كليّاً، كأنَّما أصبح يرى نفسه أرفع من أن يحقد على أمّةٍ أو يُماري أمّة! وإذا كنّا نجد له (من شعر الخمائل) قصيدة “فلسطين”، فهي من قبيل ملحمةٍ قوميّةٍ لا تتّصل بالمُسلمين والنَّصارى واليهود وإنَّما تتّصل بالعروبة وبالصّهيونيّة!! .
ونجد أنفسنا مباشرةً (في الجداول) أمام رأيه في “السياسة” والحديث فيها وموقفه منها…
… … …
وأهجرُ أحاديثَ السياسةِ والأُلى يتعلَّقون بحبلِ كلِّ سياسي
وشاعرنا الكبير نبذ ثمارَها بعد أن ذاقها؛ ولسنا ندري مؤدَّى لفظة: “مُذْ ذقتُها” في هذا البيت:
إنّي نبذتُ ثمارَها مُذْ ذقتُها ووجدتُ طعمَ الغدرِ في أضراسي
لأنَّنا لا نجد في سيرة حياته ما يشير إلى اتّجاهٍ سياسيٍّ معيّن، ولكنَّه ههنا يومئ إلى ذلك إيماءةً عابرةً كأنما يريد أنْ يذكر شيئاً عن “ماضيه السياسيّ”، ولكنَّه إلى جانب ذلك يريد أن يُبرِّئ ساحته من تلك “الخطيئة” التي ارتكبها؛ وها هو ذا يغسل يديه منها، فيغسل راحتيه بذلك من جميع الأوضار والأرجاس …
وغسلتُ منها راحتَيَّ فغسَلتُها من سائرِ الأوضارِ والأدناسِ
هذا من حيث موقفه من السياسة، أمّا نظرته إليها فهي فضلاً عن كونها مجمع الأوضار والأدناس، يراها شتّى الوجوه، مُتلوِّنة، تلبس لكلِّ حالةٍ لبوسها الذي يُلائمها وتجعل بالتالي مُعتنِقها اشدَّ ما يكون خُبثاً وتلوُّناً.
لا تخدعنَّكم السياسةُ ، إنَّها شتّى الوجوهِ كثيرةُ الألوانِ
أمّا معتنقوها فهم برأي الشاعر أحد اثنين: غِرٌّ ساذَجٌ أو مشعوذٌ دسّاس! ..
وأكرِمْ بهما من رجلين!! . والسياسيّ، بعد هذا، متآمرٌ أبداً على موطنه وعلى قومه، فهو إمّا مجرمٌ دنيءٌ أو لصٌّ سافل! ..
وأيَّةُ صفاتٍ يمكن أن يتصوَّرها الإنسان للمخلوق المُنحطِّ من جميع جوانب الانحطاط الخُلُقيّ أكثر من أن يكون سياسيّاً على الشاكلة التي يريدها، أو التي صوَّره بها، أبو ماضي عندما قال (في الجداول):
وتركتُها لاثنين: غِرٍّ ســاذَجٍ ومشعوِذٍ متذبذبٍ دسّـاسِ
يرضى لموطنه يصير مَواطناً وتصيرُ أمَّته إلى أجنـاسِ
ويبيعها بـدراهمَ معـدودةٍ ولو أنَّها جاءتْ من الخِناسِ
على أنَّنا إذا أحببنا أن نستقرئ رأي الشاعر الآن في السياسة وجدناه وقد تركها حقّاً وصدقاً، ونفض منها اليدين نفضاً … أمّا لمَنْ تركها؟ فلسنا ندري إن كانت تصدق وجهة نظره من أنَّ السياسين أحد اثنين: غِرٌّ ساذجٌ أو مشعوِذٌ دسّاس …؛ لأنَّنا نرى السّاسة اليوم وقد ملؤوا الدنيا طولاً وعرضاً كما كان الأدباء، في عصور الأدب العربي ، يملؤون دنيانا أدباً وشعراً …
—————————————————
-
مقدمة “الباب الضيق” لأندريه جيد نقله إلى العربية الأستاذ نزيه الحكيم، وقدَّم له أندريه جيد وطه حسين، طبعة دار الكتاب المصري 1946.
-
تجد في “الجداول” بعضاً لا يكاد يذكر ، ولكنك ، مقابل ذلك تجد كثيراً من شعر المناسبات . في آخر دواوينه “الخمائل”